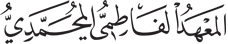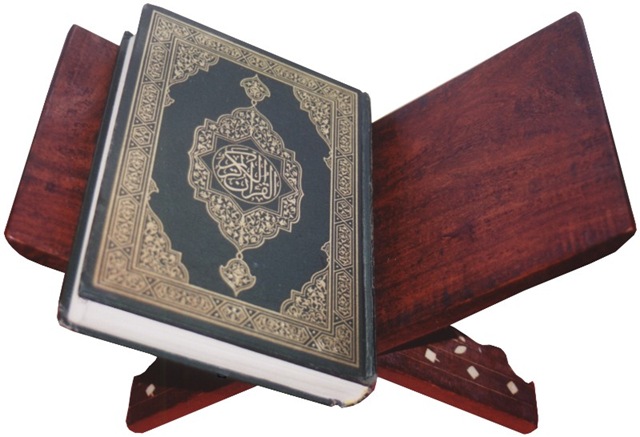
== (المَواقف الرّوحيّة والفُيوضات السُبّوحيّة) ==
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد،وعلى مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،وعلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين،وعلى آله وصحبه أجمعين.
== (مقدمة) ==
_ [.. هذه نَفثات روحية وإلقاءات سُبّوحية،وبعلوم وَهبيّة وأسرار غيبيّة،من وراء طَور العقول وظَواهر النّقول،خارجة عن أنواع الإكتساب والنّظر في كتاب. قَيّدتها لإخواننا الذين يؤمنون بآياتنا،إذا لم يَصلوا إلى إقتطاف أثمارها،تَركوها في زوايا أماكنها،إلى أن يبلغوا أشُدّهم ويَستخرجوا كَنزهم. وما قيّدتها لمن يقول هذا إفك قديم وأساطير الأوّلين،ويُحَجّر على الله تعالى ويقول: (أهؤلاء مَنّ الله عليهم من بيننا) من علماء الرّسوم،القانعين من العلم بالإسم.. ولا نُجادلهم،بل نَرحمهم ونَستغفر لهم،ونُقيم لهم العُذر من أنفسنا في إنكارهم علينا،إذ جئناهم بأمر مُخالف لما تَلقّوه من مَشايخهم المُتقدّمين وما سَمعوه من آبائهم الأوّلين..]. _ [حَضرت مُحاضرة من مُحاضرات الشُرَفا ومُسامَرة من مُسامرات الظُرَفا،في نادٍ من أنديّة العُرَفا،فجاؤوا في سَمَرهم بكل طُرْفة غريبة ومُستَظرفة عجيبة،وكان الحديث شُجوناً وألواناً وفنوناً،إلى أن تَكلّم عَريف الجماعة ومُقَدّم أهل البَراعة،فقال: أحدّثكم بحديث هو أغرب من حديث عنقاء مُغرب،فاشْرَأبّوا لسماعه ومَدّوا أعناقهم وفَرّغوا قلوبهم وحَدّقوا أحداقهم،فقال:
إن في الوجود مَعشوقة غير مَرموقة: الأهْوِيّة إليها جانحة،والقلوب بحُبّها طافحة،والأبصار إلى رؤيتها طامحة. يَطير الناس إليها كُلّ مَطار،ويَرتكبون الأخطار،ويَستعذبون دونها الموت الأحمر،ويَركبون لطَلبها المُكعّب الأسمر (قناة الرّمح). ولا يَصل إليها إلا الواحد بعد الواحد،في الزمان المُتباعد. فإذا قُدّر لأحد مُشارَفة حِماها ومُقاربة مَرماها،ألْقَت عليه إكسيراً لا له مادّة ولا مُدّة،ولا هو عَيْن مُعتَدّة. فيَحصُل إنقلاب عَيْنه،وجميع الأعيان في عَينه،إلى عين هذه المَعشوقة التي هي غير مرموقة،المعلومة المجهولة،المغمودة المَسلولة،الباطنة الظاهرة،المستورة السّاترة،الجامعة للتضادّ،بل ولجميع أنواع المُنافاة والعِناد،ولا يقدر أن يُعبّر عنها بعبارة ولا يُشير إليها بإشارة،أكثر من قوله: (إنّي وَصلتها وحَصّلتها).
وبعد التّعب والعَنا،ومُعاناة الضّنا،وجدت هذه المعشوقة: (أنا). وتبيّن لي أنّني: الطالب والمطلوب،والعاشق والمعشوق. فما كان هَجْري للَذّاتي إلا في طَلب ذاتي،ولا كانت رحلتي إلا لنِحْلَتي،ولا وصولي إلا إلَيّ،ولا تَفتيشي إلا عَليّ،ولا كان سَفري إلا مِنّي فِيّ إلَيّ.
فيُقال له: هَل رأيت مُحَيّاها وشَممت رَيّاها،حتى قلت أنا إيّاها؟ فيقول: رأيت وما رأيت،وما رَميت إذ رَميت. ويأتي بأوصافها بما تَنبو عنه العقول ولا تَحتمله ظواهر النّقول،ما طَرق الأسماع ولا طَمعت في فَهمه الأطماع..
فيُراجَع ولا يَرجع،ويُغَلّط ولا يَسمع. وحينئذ يَحكُم الناس عليه بالجنون والعَته والسّفه والبَله،ويُجهّلونه ولو كان أعلمهم،ويُسفّهونه ولو كان أحْلَمهم،ويَستبيحون منه العِرْض،في الطول والعرض،ويجعلونه مَرمى غَمْزهم ولَمْزهم ونَبْزهم ووَكزهم. يَهجُره الحَميم العاطف،ويَقليه الصديق المُلاطف. وهو مع هذا ناعم البال بما لديه،قَرير العين بما حَصل بين يديه. لا يلتفت إلى قطعهم وهَجرهم،ولا يُبالي بلَغْوِهم فيه وهَجرهم..
قلت لهم: يا قوم ألَستُم تعلمون أنّي طَلاّع الثّنايا،وسَبّاق الكَتيبة إلى معترك المَنايا؟ فأنا آتيكم بحقيقتها ومجازها،وأفُكّ لكم المُعَمّى من ألغازها،أو أموت فأعذَر،ولا عَليّ إن لم أقْبَر..
وما زلت مُمتطيّاً صَهْوَتَيْ النّسر والغُراب،مُحَمّلاً نفسي كل مكروه،مُستعذباً أنواع العذاب. لا تطمئنّ بي دار ولا يستقرّ بي قرار،إلى أن ظَهرت لي الأعلام التي ظهرت لمن قَبلي من الوافدين الأعلام.. وألقِيَ عَليّ ما ألقي عليهم،وثَبت لديّ ما ثبت لديهم. ولما وَصلت حيث وَصلوا وحَصّلت على ما عليه حَصّلوا،طَلبت الإباحة والجواز إلى التقدّم والجواز،وقد عرفت الحقيقة والمجاز،فقيل لي: لا تَتخطّ رقاب الصدّيقين،إرجع فما وراء مَوقفك إلا العدم المحض،لا ثبات ولا ركض..
لما إنْفَتح الباب وإرتفع الحجاب،وإجتمعت الأحباب على شراب اللّذيذ المُستَطاب،رَتّب الأفراح حيث ما دَبّت الرّاح. وبعد أن طار السُكر والمَحو،ونَزل الحضور والصّحو،رأيت شَمسنا طالعة،مُشرقة ساطعة،والناس في ظلمة وليل ومَرْج ووَيْل،قلت: ما بال الناس؟ فقيل: إنهم في عُمْي وإفلاس،وما لكم ولهم؟ إنهم عالَم وأنتم عالَم. والله غالب على أمره،الحاكم العزيز العالِم.].
== (الموقف الأول) ==
قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حَسنة) [الأحزاب 21].
إن الله تعالى قد عَوّدني،أنه مهما أرادَ أن يأمُرني أو يَنهاني أو يُبشّرني أو يُحذّرني أو يُعلّمني عِلماً أو يُفتيني في أمر أسْتَفتيه فيه،إلا ويأخذني مِنّي،مع بَقاء الرّسم،ثُمّ يُلقي إليّ ما أراد بإشارة آية كريمة من القرآن،ثمّ يرُدّني إليّ فأرجع بالآية قرير العين،مَلآن اليدين. ثمّ يُلهمني ما أراد بالآية،وأتلقّى الآية من غير حرف ولا صوت ولا جهة.
وقد تَلقّيت،والمنّة لله تعالى،نحو النّصف من القرآن بهذا الطريق،وأرجو من كرم الله تعالى أن لا أموت حتى أسْتَظهر القرآن كُلّه.
فأنا،بفضل الله،مَحفوظ الوارد،في المَصادر والمَوارد،ليس للشيطان عليّ سُلطان،إذ كلام الله تعالى لا يأتي به شيطان.. وكل آية تَكلّمت عليها،إنما تَلقّيتها بهذا الطريق،إلا ما نَذُر.
وأهل طريقنا ما إدّعوا الإتيان بشيء في الدين جديد،وإنما (إدّعوا الفهم الجديد في الدّين التّليذ).. ومن أراد أن يَبلُو صِدقهم،فليَسلُك طريقهم. والقوم ما أبطلوا الظواهر،وما قالوا ليس المراد من الآية إلا ما فَهمنا.. بل قالوا: فَهمنا شيئاً زائداً على ما يُعطيه ظاهرها..
== (الموقف الثاني) ==
قال الله تعالى: (وإيّاك نَستعين) [الفاتحة 5].
من المعلوم البَيّن: أن القُدرة على الفعل والتّرك والمَشيئة وسائر الإدراكات،تابعة للوجود. فما لا وجود له،لا فعل ولا تَرك ولا إدراك له. والإنسان،وكل ممكن،لا وجود له مُستقلاً،لا قديماً ولا حادثاً،بُرهاناً وكَشفاً..
ولمّا كان خطاب الحق عباده إنما هو على حَسب تَخيّلهم،وتَمشيّة لدَعواهم.. جاءت نسبة الأفعال الصّادرة من العباد،في بادئ الرّأي ونَظر العقل،متنوّعة مختلفة،في الكتاب والسنة. فمرّة جاءت منسوبة إلى الله بالإنسان،ومرّة منسوبة إلى الإنسان بالله،وتارة منسوبة إلى الإنسان وحده،وتارة نَفاها عن الإنسان صَراحة..
وقولنا: (عِلّة التّكليف هي الدّعوى) مُرتبطة بالعبادة التكليفيّة.. أما (العبادة الذّاتيّة) فهي حاصلة لكل المخلوقات..
== (الموقف الثالث) ==
قال الله تعالى: (فسَبّح بحمد ربّك وكُن من الساجدين واعبُد ربّك حتى يأتيك اليقين) [الحجر: 98_99].
لكل مخلوق إسماً من أسماء الحق تعالى،هو الواسطة بين الحق والعبد،ولا يَعرف العبد الحق إلا من طريقه،ولا يعبد العبد من الحق إلا ذلك الإسم،ولو تَجلّى الحق للعبد بغير مُقتضى ذلك الإسم ما عَرفه،بل يُنكره.. لأن العامّي لا يَقدر أن يعبُد الحق مُطلقاً،ولا يعرفه في جميع تجليّاته.. فأمر تعالى (العامّي) أن يعبد ربّه بأنواع العبادات الشرعية والوظائف السَنيّة،ويتقرّب إليه بنوافل الخَيرات.
والحكمة في الأمر بمُلازمة التّسبيح والتّنزيه والسّجود والعبادة،هو أنه رُبّما سَمع العاميّ المَحجوب أحوال العارفين بالله وكَلامهم،وما مَنّ الله تعالى عليهم به من العلوم الوهبيّة والأسرار الربانيّة،فيتعلّق بذلك على غير وجهه وطريقه الموصل إليه،ويترُك ما بيده من الأعمال والوظائف الشرعية،فيَهلك.. ويَتشبّه بهم في أحوالهم الباطنة الخاصّة بالكاملين،ويتكلّم بكلماتهم في وحدة الوجود ومثلها من المسائل المُشكلة من غير سلوك طريقهم على الوجه المعروف عندهم.
فنَصح الحق عباده وأمرهم بالتمسّك بما عندهم والعمل به.. فإذا عمل العبد على أمر الحق له،وواظب على أنواع النوافل،أحَبّه الله. فإذا أحبّه كان سمعه وبصره ولسانه ويده وجميع قواه،وهو المُراد بإتيان اليقين،بمعنى (الكَشف)..
فليس المقصود من التكاليف الشرعية إلا أنها أسباب وأدوية لرَفع الحجاب عن وجه الأمر،وبعد فتح الباب ورفع الحجاب،يَزيد العبد تعظيماً للأوامر الشرعية وإلتزاماً لها. ويكون إتيانه بالعبادات،بعد رفع الحجاب،على طريق أعلى وأفضل وأعدَل وأكْمَل.. وكل من إدّعى أنه شَمّ رائحة من طريق أهل الله،ولم يزْدَد للشّرع تعظيماً وللسنّة إتّباعاً،فهو مُفْتَر كذّاب.
== (الموقف الرابع) ==
قال الله تعالى: (بل كانوا يعبدون الجنّ أكثرهم بهم مؤمنون) [سبأ: 41].
كل مَن عَبد الله تعالى خَوفاً من النار أو طلباً للجنة،أو ذكر الله تعالى لتَوسعة رزق مثلاً،أو لصَرف الوجود إليه وهو الجاه،أو لدفع شرّ ظالم.. فهذه كلها (عبادة مَعلولة)،ليست عند الله بمقبولة،إلا بالفضل والمنّة،إلا أن تكون هذه الأشياء المذكورة غير مقصودة،بأن كان حظورها تابعاً لا حاملاً،فلا بأس..
قال الله تعالى على لساني: [ إن كل من لَم يسلُك طريق القوم،ويتحقّق بعلومهم حتى يعرف نفسه،لا يصلُح له إخلاص،ولو كان أعْبَد الناس وأورعهم وأزهدهم وأشدّهم هُروباً من الخلق وإختفاءً،وأقربهم تدقيقاً وبَحثاً عن دسائس النفوس وخفايا العيوب. فإذا رحمه الله تعالى بمعرفة نفسه صَحّ له الإخلاص،وتَصير الجنة والنار والأجور والدّرجات وجميع المخلوقات كأن الله ما خلقها. فلا يُعظّمها ولا يَعتبرها،إلا من حيث إعتبرها الحق تعالى شرعاً وحكمة..]..
== (الموقف الخامس) ==
قال الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل: 40].
(الأمر) أمران: أمر الشيء المطلوب كَوْنُه بالكون،فهذا لا بدّ أن يكون. وأمر المُكلّف بتكوين الفعل منه،فهذا لا يكون.
و(الإرادة) نوعان: إرادة متعلّقة بالفعل نفسه،فهذه نافذة الوقوع. وإرادة متعلّقة بالفاعل أن يفعل،فهذه غير نافذة التعلّق،إلا إذا جامعتها الإرادة الأخرى.
ولما غفل المعتزلة على هذا الأمر وما إنكشف لهم هذا السرّ،جعلوا للإرادة تعلّقاً واحداً،وللأمر كذلك..
== (الموقف السادس) ==
كان الحق تعالى لحقيقته يقول: “أنا”،والعبد لجَهله يقول: “أنا”. العبد يقول: “هو” لشهوده من رَبّه البُعد،والربّ يقول: “هو” لكَون ذلك مَشهود العبد. فلما تَنفّس صُبح العناية وجعل مُنادي الهداية،وأشرقت الستّ (الجهات) والخَمس (الحواس) بإشراق الشمس: زالَ الهو من البَيْن،وإلْتَبس أنا بأنا،عَيْناً بعَيْن،من غير إمتزاج ولا إتّحاد ولا حلول،إذ الكل في طريقنا وتوحيدنا مَعزول،فليس عندنا إلا وجود واحد،هو عَيْن. وشرط الثلاثة عند الثلاثة: تعدّد الوجود والعيْن. فلا يُكدّرون صُفوفنا بجَعْجعتهم،ولا يُرَوّعوننا بمَعْمعتهم.
== (الموقف السابع) ==
أخذني الحق عَنّي وقَرّبني مِنّي،فزالَت السماء بزوال الأرض،وإمتزج الكلّ بالبعض،وإنعدم الطول والعرض،وصار النفل إلى الفرض،والإنصباغ إلى المَحض،وإنتهى السّيْر،فإنْتَفى الغير،وصَحّ النّسب بإسقاط الإضافات والإعتبارات والنّسب: (اليوم أَضع أنسابكم وأرفع نَسبي). ثمّ قيل لي مثل قولة الحلاج،غير أن الحلاج قالها،وأنا قيلَت لي،ولا أقولها. وهذا الكلام يعرفه ويُسَلّمه أهله،ويَجهله ويُنكره مَن غلب جَهله.
== (الموقف الثامن) ==
قال الله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56].
أي ليَعرفون،بإجماع المُحققين من أهل الله تعالى. ويؤيّده الخبر: (كنت كنزاً مخفياً لم أعرف،فأحببت أن أعرف،فخلقت الخلق وتَعرّفت إليهم،فبي عرفوني) الحديث..
قال تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) أي: حَكم. فما خلقهم إلا ليعرفوه،فلا بد أن يعرفوه (المعرفة الفطرية) التي فطر الله الناس عليها.. فحُكمه تعالى نافذ لا يُرَدّ ولا يُغالَب،وإنما تفاوتت معرفتهم لتفاوت عقولهم. وإنما تفاوتت عقولهم لتفاوت إستعداداتهم،والإستعدادات لا تُعَلّل لأنها قديمة غير مَجعولة،فهي (فَيْض قُدسي ذاتيّ)،ما تَخلّلته صفة من الصفات..
فالمقصود بالعبادة: التعظيم والذلّة والخضوع،من كل عابد،نحو من يَملك الضرّ والنّفع والعطاء والمنع والرزق والخفض والرّفع. وهذه الصفات في نفس الأمر ليست إلا لفرد واحد وهو الحق تعالى،وهو غيب مطلق.
فكل عابد صورة: من شمس وكوكب،ونار ونور،وظلمة وطبيعة،وصنم وصورة خياليّة وجنّ،وغير ذلك،يقول في الصورة التي عَبدها: إنها صورة المقصود بالعبادة،ويَصفها بصفات الإله،من الضرّ والنّفع ونحو ذلك. وهو مُحقّ من وجه،لولا أنه حصره وقَيّده. فما قصد عابد بعبادته للصورة التي عبدها إلا الحقيقة المُستحقّة للعبادة،وهو الله تعالى،وهو الذي قضى به الله وحَكم. ولكنهم جهلوا ظهورها المطلق الذي لا يشوبه تقييد ولا حصر،فجهلوها على التحقيق،وعرفوها في الجملة وهي المعرفة الفطرية.
فكل من عَبد الحق تعالى ــ ما عدا الطائفة المرحومة،طائفة العارفين ــ إنما عَبده مُقيّداً مَحصوراً مَحكوماً عليه،لأنه عرفه هكذا. حتى طوائف المُتكلّمين فإنهم حكموا عليه بأنه على كذا،ولا يَصحّ أن يكون على كذا،وينبغي أن يكون على كذا.. فحكّموا عقولهم في الحق،والعقل ليس عنده إلا (التّنزيه الصّرف). وتوحيد الشرع الذي جاءت به الكتب والرُسُل (تَنزيه وتشبيه).
ولا شكّ أن المتكلمين،من سُنّي ومعتزلي،ما حَكموا على الحق تعالى بما حكموا،من إثبات وسَلب،إلا بعد تصوّره بصورة عقلية خيالية،فإن الحكم فرع التصوّر ضرورة. وإن قال المُتكلم ليس للحق تعالى في عقلي صورة فهو: إما جاهل بالتصوّر ما هو،وإما مُغالط مُباهت..
فكل طائفة تَحصر الحق تعالى في مُعتقدها،وتَنفي أن يكون للحق تَجلّ وظهور على خلاف عقيدتها فيه. وهذا هو سَبب إنكار المُنكرين للحق تعالى وتَعوّذهم منه يوم القيامة.. فما عَرف أحد من المُنكرين المُتعوّذين الحق تعالى من حيث الإطلاق،وإنما عرفه من حيث تَقييده بصورة معتقده،صَوّر تلك الصور بعقله وإعتكف عليها يَعبُدها.
ولولا إذن الشارع في تَخيّل المعبود وقت العبادة،لقُلنا: لا فرق بين من يَنحته بيده ويُصوّره،وبين من يُصوّره بعقله. لكن الشارع أذِنَ في (الصورة الخَيالية)،ومَنع (الصورة الحِسيّة).. وهو قول الصادق الأمين: (أن تعبُد الله كأنك تراه) أي: تَتخيّله كأنه في قِبلَتك،مَثلاً،وأنت بين يديه،حتى تتأدّب في عبادته ويَحضُر قلبك فيها. فالأمر وَرد بهذا التخيّل رَبطاً للقلوب في الباطن عن الخوض والتّشتيت،كما ربط الأجسام بإستقبال القِبلة في الظاهر،رَبطاً للأجسام عن الإلتفات والحركات.
وما أمر هذا المُتخيّل للحق تعالى أن يُقيّده عنده،ولا يكون عند غيره. وأنه محصور في قبلته،ولا يكون في قبلة غيره. ولا أن يَحصره في ذلك المُتخيّل دون غيره من الصور المُتخيّلات. فإنه تعالى مطلق في حالة التخيّل عن التخيّل،فهو عين الضدّين..
والعارفون،عند هذا التجلّي والتحوّل في الصُور في الآخرة،ساكتون لا يتكلّمون ولا يُعرّفونه لأحد،كما هم اليوم في الدنيا. لأنهم عَرفوه في الدنيا بالإطلاق الحقيقي،حتى عن الإطلاق،لأن الإطلاق قَيْد. وعَلموا أنه تعالى المُتجلّي الظاهر بكل صورة حسيّة أو عقلية أو روحانية أو خيالية. وأنه (الظاهر،الباطن،الأول،الآخر). فما أنكروه في الدنيا ولا يُنكرونه في الآخرة،في أي تَجلّ ظَهر..
تَجلّي الحق تعالى لأهل المحشر،ويَستعيذون منه،المُنزّه والمُشبّه،إلا العارفين بالله تعالى،ما هو؟.
فإنه لو كان تَجلّي (تَنزيه) لأقَرّت به المُنزّهة،ولو كان تَجلّي (تَشبيه) لأقرّت به المُشبّهة. وليس المعروف إلا هاتين المرتبتين.
فكان الجواب: أنه تعالى يتجلّى في ذلك اليوم بتَجلّ جامع للتنزيه والتشبيه،على وجه لا تهتدي إليه العقول،ولا الكشف الآن. وما عُرف الحق إلا بجَمعه بين الأضداد،بل هو عين الأضداد،لا أن هناك عَيناً جامعة للأضداد..
_ الحكمة في تكليف العباد بالتكاليف الشاقّة،وإلزامهم بالأوامر والنّواهي،والتّحجير عليهم ــ هو أن العبد،وإن كان يُسمّى مُمكناً لنسبة مجازية أورثته هذا الإسم،فله نسبة حقيقية إلى الربوبيّة. والحق تعالى أراد بظهوره في المُسمّى خَلقاً وعبداً،أن يَرى جميع أسمائه فيهم،وأن يعرفوه ويعبدوه. فلو تركه مُطلقين،ما أمرهم ولا نهاهم ولا حَجّر عليهم،ولما ظهرت فيهم جميع الأسماء،ولتعلّقوا بما فيهم من الربوبية ونَسوا إمكانهم. وما جعل الحق تعالى لهم عينين،ظاهرة وباطنة،إلا لينظروا بالعين الباطنة نِسبتهم الباطنة،وبالعين الظاهرة نِسبتهم الظاهرة الإمكانية. فمهما غفلوا عن واحدة من النّسبتين هَلكوا.. _ العبادة فَرع المعرفة وثَمرتها..
== (الموقف الحادي عشر) ==
قال الله تعالى: (كَتَب ربكم على نفسه الرحمة) [الأنعام: 54].
الآيات والأخبار الدالّة على وُجوب أشياء على الحق تعالى،لا يُفهَم منها الحقيقة المعروفة في العُرف للوجوب،الذي يستحق فاعله المَدح وتاركه الذمّ،حتى يكون الحق داخلاً تحت الحَجْر والحَصْر..
هذه الأشياء،وأمثالها،إقتضتها (مرتبة الألوهية) إقتضاء ذاتياً لها،لا مُقتضي لها غيرها. إذ لا يَصدُر من الحق تعالى شيء،إلا ولذلك الشيء إسم إلهي إقتضى صُدور ذلك الشيء،كائناً ما كان.
فالألوهية نِسبة ومرتبة،لها أحكام وخصوصيات،لا بدّ منها لتحقيق المرتبة.. ورُتبة الألوهية ثابتة لله تعالى،عقلاً ونَقلاً،ظاهراً وباطناً،فهو يفعل ما تقتضيه ألوهيته من غير إعتبار شيء زائد على ذلك.
وقد تكلّم إمامنا محيي الدين (الشيخ الأكبر) على هذه المسألة بغير هذا،والكلّ من عند الله تعالى (كُلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً).
== (الموقف الثالث عشر) ==
قال الله تعالى: (سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً) [الكهف: 78].
كنت مُغرماً بمطالعة كتب القوم منذ الصبا،غير سالك طريقهم. فكنت في أثناء المطالعة أعثُر على كلمات تصدُر من سادات القوم وأكابرهم،يَقف منها شعري وتَنقبض منها نفسي،مع إيماني بكلامهم على مُرادهم..
وذلك كقول عبد القادر الجيلي: [مَعاشر الأنبياء أوتيتُم اللّقب،وأتينا ما لم تُؤتَوه]،وقول أبي الغيث بن جميل: [خُضنا بحراً وَقفت الأنبياء بساحله].. ومثل هذا كثير عنهم.
وكل ما قاله القائلون المُأوّلون لكَلامهم،لم تَسْكُن إليه النّفس،إلى أن مَنّ الله تعالى عَليّ بالمُجاوَرة بطيبَة المباركة،فكنت يوماً في خُلوة مُتوجّهاً،أذكر الله تعالى،فأخذني الحق عن العالَم وعن نفسي،ثمّ رَدّني وأنا أقول: (لو كان موسى بن عمران ما وَسعَه إلا إتّباعي) على طريق الإنشاء،لا على طريق الحكاية،فعَلمت أن هذه القَولة من بَقايا تلك الأخْذَة،وأنّي (كُنت فانياً في رسول الله صلى الله عليه وسلم)،ولم أكن في ذلك الوقت فُلاناً،وإنما كنت محمداً،وإلا لما صَحّ لي قول ما قُلت إلا على وجه الحكاية عنه صلى الله عليه وسلم.
وكذا وقع لي مرّة أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيّد وَلد آدم ولا فَخر).
وحينئذ تَبيّن لي وَجه ما قال هؤلاء السّادة،أعني أن هذا أنموذج ومثال،لأنّي لا أشبّه حالي بحالهم،حاشاهم،وحالهم أتَمّ وأكمل. وكذا قال الشيخ الجيلي: [كُلّ مَن إجتمع،هو وآخر،في مقام من المقامات الكمالية،كان كلّ منهما عين الآخر في ذلك المقام. ومن عَرف ما قُلناه عَلم معنى قول الحلاج وغيره]..
وقبل أن تصدُر منّي هذه المقالة: كنت ثالث ليلة من رمضان مُتوجّهاً للروضة الشريفة،فحصل لي حال وبُكاء،فألقى الله تعالى في قَلبي أنه صلى الله عليه وسلم يقول لي: (أبْشِر بفَتح). فبعد ليلتين: كنت أذكر الله تعالى فغَلبني النوم (فرأيت ذاته الشريفة إمتزجت مع ذاتي،وصارت ذاتاً واحدة)،أنظُر إلى ذاتي فأرى ذاته الشريفة ذاتي. فقُمت فَزعاً مرعوباً فرحاً،فتوضّأت ودخلت المسجد للسلام عليه صلى الله عليه وسلم،ثمّ رجعت إلى الخلوة وجعلت أذكر الله تعالى،فأخذني الحق عن نفسي وعن العالَم،ثمّ ردّني بعد أن ألقى إليّ قوله: (الآن جئت بالحقّ)،فعلمت أن الإلقاء تصديق للرّؤيا..
== (الوقف الرابع عشر) ==
قال الله تعالى: (إهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: 6].
ألْقِيَ عَليّ،وأنا في صلاة الصبح،أن الهداية إلى الصراط المستقيم،جنس لا نهاية لأفراده..
و(الصراط المستقيم) هو صراط أهل معرفته تعالى،ومعرفته تعالى لا نهاية لها،لأن معرفته هي معرفة كَمالاته،وكمالاته تعالى لا نهاية لها. ولذا قال بعض العارفين: [السّيْر إلى الله تعالى له نهاية،والسّيْر في الله لا نهاية له] يُشير إلى هذا..
و(المُنعَم عليهم) هم الذين أراهُم الحق تعالى حَقائق الأشياء كما هي،فإنكشف عنهم الغطاء وتَقشّع سَحاب الجهل بطلوع شمس المعرفة لقلوبهم،فعرفوا الحق والخلق،معرفة يقين..
و(المغضوب عليهم) هم الطوائف الذين ما عرفوا معبودهم ولا تَصوّروه إلا بصورة محسوسة من: نور وشمس وكوكب ووَثن وصَنم.
و(الضّالّين) بمعنى (الحائرين)،لأن كل ضالّ حائر،فهم الناظرون في ذات الله بعقولهم،من حكيم فيلسوفي ومُتكلّم،فإنهم ضالّون حائرون..
والحَيْرة الحاصلة للعارفين ما هي الحيْرة الحاصلة للمتكلّمين،وإنما هي حَيْرة أخرى حاصلة من (إختلاف التجليّات وسُرعتها وتنوّعها وتناقضها)،فلا يهتدون إليها ولا يعرفون بما يحكمون عليها. فهي (حيرة عِلم لا حيرة جهل)..
== (الموقف الخامس عشر) ==
قال الله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) [الحديد: 3].
مَحَق الله تعالى،بهذه الآية،كما قال الشاذلي،(الأغيار) كلّها..
المَحجوب،حالَ حجابه،يعتقد أن له وجوداً مُستقلاً مُنفصلاً من الوجود الحق: إما حادثاً كما هو معتقد المتكلمين،وإما قديماً كما هو معتقد بعض الحكماء. كما يعتقد أنه هو الظاهر بالصورة المحسوسة المنسوبة إليه،المُسماة بزيد أو عمرو. وكما يعتقد أن له صفات مغايرة لصفات الحق تعالى،من قدرة وإرادة وعلم ونحوها. كما يعتقد أن له أفعالاً صادرة عنه،هو فاعلها،إما خَلقاً أو إكتساباً..
_ واعلم أن الحق تعالى هو الظاهر بهذه الصُوَر المُشكّلة المحدودة،التي هي خَيالات لا وُجود لها ولا حَقيقة لها،إلا في المشاعر الإنسانية. كما إذا أخذت عوداً في طَرفه نار،وأدَرْته بسرعة،فإنك تَرى دائرة نار لا تشُكّ فيها.. وتحكُم بعقلك وعلمك أنه ليس ثَمّة إلا الجمرة التي على رأس العود. فهكذا جميع ما ترى في الأرض والسماء،ليس إلا أمر الله الذي هو مجموع صفات الله الظاهر بكل صورة.. وهذه الصور المشكلة المحدودة في الأرض والسماء هي أحكام الإستعدادات الممكنة الثابتة في العلم،التي ما شَمّت رائحة الوجود ولا تَشُمّ أبداً،المُسماة ب(الأعيان الثابتة) وب(الحقائق)،عند الصوفية،وب(الماهيات) عند المتكلمين.. والوجود الحقّ المُسمّى ب(الأمر) لا يَظهر إلا بما يَقتضيه إستعداد كل عَيْن ثابتة،وما هي طالبة له من الأحوال ومُتأهّلة من الأزل والقدم: من إيمان وكُفر،وطاعة ومعصية،وعلم وجهل،وصلاح وفساد،وحسن وقبيح،وغير ذلك من (الأقوال والأفعال والإعتقادات والصفات).. فأمر الله،الذي هو (الوجود المُفاض على المُكَوّنات)،هو الظاهر،وهو الشّهادة،وهو المُحيط بكل شيء. والمخلوقات هي الباطنة،وهي الغيب،ولكن الحُكم دائماً للباطن على الظاهر وللغيب على الشهادة. فحَكمت أحكام الأعيان على الوجود الحق الظاهر بما تقتضيه حقائقها،فلا يظهر إلا بأحكامها،كائنة ما كانت،من نقص أو كمال. وهي إعدام،لأنها نِسَب وأعراض،وهو تعالى في هذا الظّهور على ما هو عليه من الكمال،لا حلول ولا إتّحاد ولا إمتزاج. ومن هنا كانت الحجة البالغة للحق تعالى على الخلق (ولا يظلم ربّك أحداً) لأنهم بطَلَب إستعداداتهم،طالبون منه تعالى أن يَظهر بأحكام كلّ عَيْن وما تقتضيه. وهذا الإستعداد الكُلّي (غير مَجعول): فما هو مخلوق،ولا هو من فعله فتكون للخَلق الحُجّة. وهنا ظُلمات مُدلهمات،تَقصُر دونها الخُطا وتَضلّ فيها القَطا. _ ظهور الحق تعالى بذاته،مُسمّى بأسماء العالَم،مُتّصفاً بصفاته: هو حجابه وبُطونه. ولو ظهر بأسمائه وصفاته،ما كان للعالَم عين ولا إسم. فهو كالواحد يُنشىء الأعداد إلى غير نهاية،بذاته دون إسمه،إذ ليس العدد إلا الواحد المُتنقّل في مراتب الأعداد،مُتسمّياً بأسماء المراتب كالإثنين والثلاثة.. ولو ظهر بإسمه وقيل: واحد،لبطل العدد.
فمن تجلّى الحق تعالى عليه بإسمه (الظاهر) رأى الحق تعالى في كل شيء من ذرّات العالم،عُلوي وسُفلي،وما زهد في شيء،ولا طلب الإحتجاب عن شيء. وهذا هو الذي يرى الوحدة في الكثرة،والكثرة في الوحدة.. وكذا الجاهل يَرى الحق تعالى،لأنه عين كل ما يَرى،ولكن لا يعرفه.. فالفارق بينهما: العلم والجهل،لا غير..
وما ورد من ذكر الحُجُب النورانية والظلمانية.. فعندي: أن الحُجُب،في حَقّ النبيّ والمَلَك،إنما هي مظاهر هَيْبة وجَلال وعظمة،بحيث لا تُمكن مُشاهدتها لخصوصية ذاتيّة لها.. وأما غير المَلك،فما حجابه إلا الجهل،لظهوره الظّهور الذي لا يُتصوّر مثله ظهور،وقُربه القُرب الذي لا يُماثله قُرب،وإتّصافه بصفات المُحدثات وتَسمّيه بأسمائها،فجُهِل لذلك وإنْحَجب وإسْتَتر..
وأما الإسم (الباطن) فالتجلّي فيه ممنوع جملة واحدة،ما تجلّى فيه لأحد سواه..
== (الموقف السادس عشر) ==
قال الله تعالى: (قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السّمع والأبصار) [يونس: 31].
قل للذين صَرفوا عقولهم لغير الله تعالى وقصّروا نَظرهم عليه،وتعلّقوا بالوسائط والأسباب،وأعرضوا عن مُسبّبها..
(يرزقكم من السماء): يُريد ما تنتفع به العقول من العلوم والأسرار،والأمور التي لا يهتدي إليها العقل إلا بالفيض الإلهي.
(والأرض): ما تنتفع به الأجسام والنّفوس الحيوانية..
فلا فاعل ولا مؤثّر إلا الحق تعالى،وهو الفاعل بالأسباب وعند الأسباب وعند فَقْد الأسباب.. فليس الوجود والفعل إلا لله تعالى وحده.. فلو نَسبتم الفعل والأثر إلى الأسباب،على جهة أنها وُجوه الحق تعالى وذاته ظاهرة فيها،من غير حلول ولا إتّحاد ولا إمتزاج،لكُنتم مُصيبين..
== (الموقف السابع عشر) ==
سُئل سيّد الطائفتين الجنيد عن العارف والمعرفة،فقال: [لون الماء لون إنائه]..
يُريد أن الماء لا لون له،وإنما يَظهر مُتلوّناً بلون الإناء. وكذلك الحق تعالى لا صورة له،وإنما يظهر بصورة العارف له. فالعارف الكامل هو الذي تظهر فيه صورة الحق تعالى على الكمال،لأنه مرآة الحق،ويَرى الحق فيه أسماءه وأوصافه. ف(العارف صورة الحق)،أعني (صورة العارف الباطنة). فظاهر العارف خَلْق،وباطنه حَقّ. فصورة باطنه هي صورة الحق تعالى،لأنه مُتخلّق بأخلاقه،مُتحقّق بأسمائه. فكل من رأيناه تَظهر منه أخلاق الحق تعالى وأوصافه وأسماؤه،عَرفنا أنه عارف بالله،وأن المعرفة وَصفه.
فالعارف بمَثابة الإناء،والحق تعالى بمثابة الماء.. فالحق تعالى لا صورة له مخصوصة،وإنما يَتصوّر ويَظهر بصورة العارف له. فهو هو،وكل صُور العالَم آنيّة لظهور ماء الحق تعالى،ولكنه ليس كالإنسان،فإنه الآنيّة الوحيدة في قبول هذا الظهور.
وليس المُراد من نِسبة الصّورة إلى الحق تعالى إلا أسماؤه،لا أن له شكلاً مُصَوّراً محدوداً،تعالى الله عن ذلك.
ورد في الخبر: (إن الله خلق آدم على صورته). فالعارف خَليفة الله،والخليفة لا بُدّ أن يكون ظاهراً بصورة مُستَخلِفه،وهي أسماؤه وصفاته.. والعارفون مُتفاوتون في هذا. والظاهر بالصفات والأسماء على الكمال هو (الخليفة الكامل)،ولا يكون إلا واحداً في كل زمان،وهو (الإنسان الكامل)..
فالعارف لا يَعرف أنه عارف وأن المعرفة نَعْتُه،إلا إذا ظهر مُتخلّقاً مُتحقّقاً بالأسماء والصفات الإلهية،أعني: الصفات والأسماء التي يُمكن الظهور بها في دار الدنيا. وأما (صفات الربوبية) فإن أدب المَوطن،وهي الدار الدنيا،يقضي بعَدم الظّهور بذلك،من أجل حُكم الحَصْر والقَيْد على صورة العارف الظاهرة المُسمّاة (عَبداً)،لمُقتضياتها الذاتيّة اللاّزمة لصورته الناقصة،لئلاّ يَلزم التناقض بين حاله ومقاله.. فكَتْمُه لأوصاف الربوبية هو الكمال.
== (الموقف الثامن عشر) ==
قال الله تعالى: (ولقد آتيناك سَبعاً من المثاني) [الحِجر: 87].
كنت ممّن رحمه الله تعالى وعَرّفه بنَفسه وبحقيقة العالَم على (طريقة الجَذْبة)،لا على (طريق السّلوك).
فإن (السّالك) أول ما يحصُل له الكَشْف عن عالَم الحِسّ،ثمّ عن عالَم الخيال المطلق،ثمّ ترتقي روحه إلى السماء الدنيا فالثانية،وهكذا،إلى العرش. وهو في كل هذا من جُملة العوامّ المَحجوبين،إلى أن يرحمه الله تعالى بمَعرفته،ويَرفع عنه الحجاب،فيَرجع على طريقه فيرى الأشياء حينئذ بعين غير الأولى،ويعرفها معرفة حَقّ.
وهذه الطريقة (طريق السلوك) ــ وإن كانت أعلى وأكمل ــ ففيها طول على السّالك،وخَطرها عظيم. فإن هذه الكُشوفات كلّها إبتلاء: هَل يَقف السالك عندها أو لا؟.. فإن كان السالك ممّن سَبقت له العناية،ودامَ مُصمّماً على طَلبته،ماضياً على عَزمه،مُعرضاً عن كل ما سوى مَطلوبه: فازَ ونَجا. وإلا طُرد عندما وَقَف،ورجع من حيث جاء،وخَسر الدنيا والآخرة.
ولذا قال في الحكم: [ما تَبرّجَت ظواهر المُكوّنات لسالك،إلا ونادَته هَواتف الحقيقة: ما تطلُب أمامك؟ إنما نحن فتنة فلا تكفُر]..
فإذا حَصّلوا على المعرفة المطلوبة،حُجبوا عند نهايتهم عن هذه الكشوفات.
وأما عن (طريق الجَذْبة) فهي أقْصَر وأسْلَم،والعاقل لا يَعْدل بالسّلامة شيئاً.. وهو (المُراد) الذي عَرّفوه بأنه: (المَجذوب عن إرادَته،مع تَهيّؤ الأمور له)..
وإلى هَذين النّوعين يُشير قوله تعالى: (فستعلمون من أصحاب الصراط السَويّ ومن إهتدى)..
== (الموقف التاسع عشر) ==
قال الله تعالى: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يُمسك فلا مُرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم) [فاطر: 2].
من الحكايات المتواترة عند القوم: أن عارفاً رأى مُريداً حَزيناً،فسأله عن سبب حُزنه،فقال له المُريد: (مات أستاذي)،فقال له العارف: (ولِمَ جَعلت أستاذك من يَموت؟).
ففي هذه الحكاية أدب عظيم وإرشاد جسيم إلى طريق مُستقيم،وأكثر المريدين عن هذا في غَفلة..
[ذكر الشيخ الأمير قاعدة نفيسة حول معرفة الشيخ وصفته،وكيفية تعامل المريد معه..]..
== (الموقف العشرون) ==
طَلبت من الحق تعالى أن يَجعل لي نوراً أكْشِف به،حتى أعرف ما آتي وما أذَر. فقال لي في الحين: (ها هو ذا الكتاب والسنة). فإنتبهت حينئذ لقوله تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يَهدي به الله من إتّبع رضوانه سُبُل السلام ويُخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويَهديهم إلى صراط مستقيم).
فعرفت أنه لا نور يَرغب فيه الرّاغبون مثل الإستقامة على الكتاب والسنّة،لأنه تعالى ضَمن النّجاة في العمل بهما،وما ضَمنهما في العمل بالكشف..
== (الموقف الواحد والعشرون) ==
قال الله تعالى،على لسان فرعون: (ءامنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل). ومُرادُه ببني إسرائيل: موسى وهارون وأتباعهما. فهو: توحيد وإقرار برسالة موسى وهارون،وإذعان لهما ولما جاءا به. وما هو ب(إيمان يأس)،فإنه شاهد كرامة الله تعالى لموسى.. وقد نَصّ الله تعالى على أن فرعون (آمَن إيماناً كاملاً) بقوله: (ءالان وقد عَصَيت قبل). فما نَعى عليه إلا تأخير الإيمان فقط،لأن عصيان فرعون ما كان عن جهل بصحة رسالة موسى وصدقه،وإنما جُحوده إستكباراً،مع معرفته في الباطن. قال تعالى في حَقّه وحقّ قومه: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعُلواً).
وأقوى حجّة للمُخالف في (عَدم قبول إيمانه)،قوله تعالى: (فأخذه الله نكال الآخرة والأولى). ولقد أعلمني الحق تعالى أن معناها: أنه (جمع لفرعون في الغَرَق نَكال الآخرة والأولى)،فلم يَبْق عليه بعد الغرق نَكال في الآخرة،هكذا ألْقِيَ إليّ.
وقد ذكر أستاذنا مُحيي الدين للآية وجهاً غير هذا. وما كان فرعون مُغَرغراً حتى لا يُقبل إيمانه،فإن الغرغرة نفس واحد،يَخرُج ولا يَرجع. وفرعون تكلّم بعد الإيمان كلمات كثيرة حَكاها الله عنه،وخاطَبه الحق بكلمات كثيرة.
وكَوْن (إيمان اليأس) غير مقبول،إنما هو في دَفْع العذاب الدّنيوي،سُنّة الله التي قد خَلت في عباده،إلا قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب في الدنيا.. والعذاب الدنيوي هو تَطهير لما سَلَف من الكفر والعناد،كالحدود في الدنيا،فإنها لا تَرفعها التوبة..
فمن قال بعَدم قبول إيمان اليأس،ما أمْعَن النّظر. ومن عَرف الحق عَرف أهله،ومن عرف الحق بالرجال تاهَ في مَهامِه الضّلال.
وربمّا يقول الواقف: إن هذه المسألة ممّا لا يعني،وإنما ذكرتها ليعلم الواقف سِعَة رحمة الله فلا يَيأس ولا يَقنط،ويظُنّ خيراً فيكون الحق عند ظَنّه.
== (الموقف الثاني والعشرون) ==
ورد في الحديث الصحيح،عن الله تعالى،قال: (أنا جليس من ذَكرني) الحديث.
فلفظة (أنا) و(نِي): يَقتضيان أن المُراد (المُجالَسة بالذّات). ومجالسة الحق الذاتية إنما هي إذا ذَكره ب(أسماء الذّات)،كالله والهو والحق والأحد،و(أسماء الضمائر). وأما إذا ذكره الذاكر ب(أسماء الصفات) أو (أسماء الأفعال)،وكان قصد الذاكر المعنى الذي دَلّت عليه لفظة الإسم،فلا يكون الحق جليسه إلا من حيث ذلك المعنى خاصّة،لا بالذّات..
ومن هذا المعنى قوله تعالى: (يوم نحشُر المُتّقين إلى الرحمن وَفداً). فحيث لم يكن المُتّقي جليساً للرحمن في الدنيا،وإنما كان جليساً لإسم من أسماء الجلال،كالمُنتقم والجبّار وشديد العقاب ونحوها. ومُجالسة أسماء الجلال تَمنع من مجالسة أسماء الجمال،كالرحمن ونحوه. وهي التي حَملته على التّقوى،فجزاه الله تعالى بحَشره إلى الرحمن وَفداً،حتى يرحمه الرحمن ويُكرمه ويُنعّمه..
والذي يُحشَر إلى (الرحمن) مَقطوع بنَجاته،بخلاف الذي يُحشَر إلى (الله) كما في قوله تعالى: (واتّقوا الله الذي إليه تُحشرون) فإنه بين خوف ورجاء من حيث الإسم (الله) الجامع لمعاني أسماء الجلال والجمال.. ولا يمكن أن يُقال: إن الإسم (الرحمن) كذلك له الأسماء كلّها،كما قال تعالى: (قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن أياً ما تدعون فله الأسماء الحسنى)،فالأسماء حين تكون تحت حيطَته وفي قَبضته،لا تخرُج إلا بنفسه،وهو (الرحمة)،لأن الدولة والحُكم له.
وأما قوله تعالى: (وأنذر به الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم) فكذلك خافوا من الحشر إلى الحضرة الجامعة لأسماء الربوبيّة كلّها،ولا يعرفون من يتلقّاهم منها من الأسماء. لو عرف كل واحد أنه يُحشر إلى ربّه الخاص،ما خافَ،لأنه كان معه في الدنيا. وكل واحد من المَربوبين مَرضيّ رَبّه،لأن المربوب شأنه طاعة ربّه الخاص،كيفما كان ربّه،مُضلاً أو هادياً أو جباراً أو عفُواً أو غير ذلك..
== (الموقف الرابع والعشرون) ==
قال الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) [محمد: 19].
الحقيقة المُسماة ب(الله) واحدة من كل وَجه،ومع وَحدتها فهي ظاهرة وتَظْهر بما لا نهاية له من الصُوَر،ولها في كل صورة وَجه خاص بتلك الصورة. فهي واحدة كثيرة: واحدة بحقيقتها،كثيرة بتعيّناتها ومَظاهرها.
فحقيقة الله،وإن ظَهرت بكمالها في مظاهرها التي لا تتنافى،فهي لا تتجزّأ ولا تتبعّض،ولها في كل مَظهر وَجه خاصّ،أي ذات. ولا يستحقّ العبادة وَجْه من تلك الوجوه الظاهرة بالمظاهر إلا الذّات المُسمّى ب(الله)،لأن غيرها وإن كان هو هي فإنه لا يُسمّى الله،فإنه تعالى لمّا ظهر بهذه الصورة سَمّاها (غَيْراً) أو سِوىً وإنساناً ومَلكاً وعَرشاً وفَلكاً وشمساً وكوكباً ونحو ذلك.
قال تعالى مُوَبّخاً لعبدة الأصنام: (قُل سَمّوهم) يعني الأصنام التي عَبدوها،فلو سَمّوهم ما سَمّوهم إلا حَجراً أو شجراً أو نحو ذلك،وما سَمّوا مَعبوداتهم (الله) أبداً. فكل من عَبد شيئاً غير مُسمّى (الله) فهو كافر،وإن كانت حقيقة ذلك المعبود هي الحقيقة المُسماة بالله،وما أصاب الحق إلا من عَبد الذات المُسمّى بالله،الغيب المطلق الذي لا صورة له ولا يُعرَف منه إلا وجوده لا غير،من حيث إتّصاف الألوهية.. والذين عَبَدوا ما عَبدوا من دون الله،ما قَصدوا بعبادتهم إلا المظاهر التي حَصروا الحق فيها،وهي الصور المشهودة لهم،وما عرفوا الحق الظاهر بتلك الصور وبغيرها،فضَلّوا وأضَلّوا.
__ فالحق تعالى إنما أمر عباده بمعرفة مرتبة ذاته،وهي الألوهيّة. وما أمرهم بمعرفة ذاته التي هي الغيب المطلق والوجود البحت،بل نَهاهُم عن طلب ذلك. قال الله تعالى: (ويُحذّركم الله نفسه)،وقال صلى الله عليه وسلم: (تفكّروا في آلاء الله ولا تتفكّروا في ذاته)..
فما أمر الله تعالى إلا بمعرفة الألوهية التي هي مرتبة الذات وظهور الصفات،لأن الأثر ليس إلا للصفات،وإن كانت لا عَيْن لها،وإنما هي مراتب للذّات. ومعرفة الأثَر توصِل إلى معرفة المُؤثّر..
فالذات ــ من حيث هو هو ــ لا يُدرك حِسّاً ولا عقلاً ولا كَشفاً،بخلافها من مرتبة الألوهية،فإنها تُدرك حسّاً وعقلاً وكشفاً.
والمُتكلّمون في التوحيد العقلي،خَلطوا الأمر وحَيّروا العقل وخبطوا خَبط عشواء في ليلة ظَلماء..
الذّات البَحْت،لا خَبر عنها ولا وَصف ولا إسم ولا حُكم ولا رَسم. المُخبر عنها صامت،والناظر إليها باهت..
ومرتبة الألوهية مُطلقة مُقيّدة،فهي جامعة للضدّين: مطلقة من حيث أنها لا حَصْر ولا حَدّ لظُهوراتها.. وأما كونها مُقيّدة،فمن كونها هي الظاهرة بكل مَظهر،المُتعيّنة بكل تَعيّن.. وهي في حال تعيّنها وتَقييدها بالمظاهر مطلقة،فتقييدها عين إطلاقها..
وكل من حَصر الحق في معتقد ونَفاه عمّا عَداه،فهو جاهل بالله،كائناً من كان،وبالخصوص إذا ظنّ التّقييد إطلاقاً كالمتكلمين. فلا ضدّ للحق تعالى فيُنافيه ويُناويه،ولا مِثْل له فيُشبهه ويُدانيه،من حيث الذّات..
== (الموقف الخامس والعشرون) ==
جاء في الحِكَم: [لولا مَيادين النّفوس،ما تَحقّق سَيْر السّائرين].
أي: لولا ما يكون فيه سَيْر معنوي،ويَحصُل فيه تردّد وصُعود وهُبوط،وهي صفات النفس المُعَبّر عنها ب(الميادين)،أي المجالات المُتّسعة. والسّيْر فيها بقَطْع وَصْلتها وتبديل وَصفاتها ومَحو آثارها وعاداتها.
والنفس واحدة،ولكن تعدّدت باعتبار تعدّد صِفاتها وتَبايُن مُقتضياتها..
سَيْر السّائر ليس شيئاً محسوساً،وإنما هو سَيْر معنوي في مَجالات معنوية،وهي النّفوس التي يكون سَيْر السّالك فيها.
وقَطْعُها: كناية عن تبديل صفاتها البَهيمية بالصفات الإلهية. بمعنى أنه يَملكُها،حتى يَضع كل وَصْف في مَحلّه اللاّئق به،ويَصرف كل وَصف مَصرفه. وأما مَحْو الصفات بمعنى زَوالها بالكُلّية،فهو غير واقع،لأنها لو مُحِيَت لمُحيَت النفس رأساً وإنعدمت.
ولا يتوهّم مُتوهّم أن السالك سائر إلى الله في مسافة محسوسة.. فلا يصحّ إطلاق السّيْر إلى الله تعالى إلا بنوع من المجاز،وهو أنه لمّا كان السالك السائر في ميادين النفوس،إذا قَطع تلك العقبات المعنوية يَصل إلى العلم بالله تعالى،صَحّ أن يُقال: سارَ إلى الله. وإلا فجَلّ ربّنا أن يسير إليه أحد ويَصل إليه..
== (الموقف التاسع والعشرون) ==
كُنت بين النائم واليَقظان،فقيل لي: [ إن الناس يظُنّون أنهم في حالة النوم،في خَيال وعَدم. وفي حالة اليقظة،في وجود حَقّ. وما يُدريهم أنهم في الحالَتين في خيال لا حقيقة له؟ فإنهم في حالة النوم،في خيال مُتّصل. وفي حالة اليقظة،في خيال مُنفصل. وحقيقة الخيال فيهما واحدة،إذ الخيال المُتّصل شُعبة من الخيال المُنفصل. والخيال لا موجود ولا معدوم،ولا مَنفيّ ولا مُثبت. وجميع ما يُدرَك،بأيّ آلة من آلات الإدراك كانت،فهو في هاتين المرتبتين. وليس في الوجود الحقّ الثابت إلا الله تعالى،والأرواح والأجسام خَيال كلّها ].
== (الموقف الثلاثون) ==
قال لي الحق تعالى: [ أتَدري من أنت؟ فقلت: نعم. أنا العَدْل الظاهر بظهورك،والظلمة المُشرقة بنورك. فقال لي: عَرفت فالْزَم،وإيّاك أن تَدّعي ما ليس لك. فإن الأمانَة مُؤدّاة،والعاريّة مَردودة،وإسم المُمكن مُنسَحب عليك أبداً،كما هو مُنسَحب عليك أزلاً.
ثمّ قال لي: أتدري من أنت؟ فقلت: نعم. أنا الحق حقيقة،والخلق مجازاً وطريقة. أنا الممكن صورة،الواجب ضرورة. إسم الحق لي هو الأصل،وإسم الخلق عَليّ العاريّة والفصل. فقال لي: أعْمِ هذا الرّمز،ودَعْ الجدار يَنقضّ على الكنز،حتى لا يستخرجه إلا من أتْعَب نفسه وعايَن رَمْسه.
ثمّ قال لي الحق تعالى: ما أنت؟ فقلت: إن لي حقيقتين من حَيْثيّتين: أما من حيث أنت،فأنا القديم الأزليّ الواجب الوجود الجَليّ. أما الوجوب،فمن إقتضاء ذاتك. وأما القِدَم،فمن قِدَم عِلمك وصفاتك. وأما من حيث أنا،فأنا العدم الذي ما شَمّ رائحة الوجود،والحادث الذي في حال حُدوثه مَفقود. فما كنت حاضراً بك لَك،فأنا وجود. وما كنت غائباً بنفسي عنك،فأنا مفقود موجود.
ثمّ قال لي: ومن أنا؟ فقلت: أنت الواجب الوجود بالذّات،المُنفرد بكمال الذات والصفات. بل تَنزّهت عن كمال الصفات بكمال الذات. فأنت الكامل في كل حال،المُنزّه عن كل ما يخطُر بالبال.
فقال: ما عَرّفتني. فقلت: من غير خَوف عُقوق،وأنت المُشَبّه بكل حادث مخلوق. فأنت الربّ والعبد،والقُرب والبُعد،وأنت الواحد الكثير،والجليل الحقير،الغنيّ الفقير،العابد المعبود،الشاهد المشهود. فأنت الجامع للمُتضادّات ولجميع أنواع المُنافاة. فإنك الظاهر الباطن،المُسافر القاطن،الزارع الحارث،المُستهزئ الماكر الناكث. فأنت الحق وأنا الحق،وأنت الخلق وأنا الخلق،ولا أنت حقّ ولا أنا حقّ،ولا أنت خلق ولا أنا خلق.
فقال: حَسْبُك،عَرفتني،فاستُرني عمّن لا يَعرفني. فإن للربوبيّة سِرّاً لو ظهرت لبطلت الربوبية،وللعبودية سرّاً لو ظهرت لبطلت العبودية. واحْمَدنا على أن عَرّفناك بنا،فإنك لا تعرفنا بغيرنا،إذ لا دليل غيرنا علينا ].
== (الموقف الواحد والثلاثون) ==
قال الله تعالى،في الحديث القدسي: (لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنّوافل،حتّى أحِبّه. فإذا أحببته،كنت سمعه الذي يسمع به،وبصره الذي يُبصر به) الحديث.
هذه رُتبة عُليا،وصاحبها غير كامل،لأنه يَرى له ذاتاً ونَفساً قائمة موجودة،والحق صفاتها،من سمع وبَصر ويَد ورجل،فنفسه عنده مُقرّرة وأفعاله بالحق تعالى.
وأعلى منه وأكْمَل،عكسُه،وهو الذي يرى نفسه صفات الحق،فيكون سمع الحق وبصره وكلامه.. وهذا وإن كان أكمل ممّن قَبله،ففيه بَقيّة نَقص،فإنه ما إنعدمت عَينه جُملة واحدة.
وأعلى منهما معاً،من يحصُل على الفناء والمَحْق،فإنه رجع إلى الإطلاق بعد التّقييد،ولم يَبق له إسم ولا عَيْن ولا رَسْم،ونوديَ عليه: لمَن المُلك اليوم؟ هَل تُحسّ منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً؟. وفي هذا الفناء تحصُل الرؤية الحقيقية،فإنه ما غابَ عن العالَم وعن نفسه إلا برؤية الحق تعالى،وفي نفس الأمر: الرّائي والمَرئي واحد،والتعدّد إعتباري. وما عَدا هذا،ممّا يُقال فيه رؤية،فهو مجاز.
ومن السّالكين من يحصُل على الفناء والمحو قبل قُرب النوافل والفرائض،وهو السالك المجذوب بالعناية.
وقوله: (كنت سَمعه..) الحديث،فيه إيماء إلى ما هو الأمر عليه في حقيقته،بأن الله تعالى هو السامع والسمع،والمُتكلّم والكلام. إذ لا يصحّ أن يكون الحق تعالى صفة يقوم بذات العبد الحادث،لأنه تعالى ذات،ما هو صفة،والذات لا تقوم بذات أخرى.
فمنطوق الحديث غير مفهومه: لأن منطوقه إثبات عين العبد.. ومفهومه نَفْي عين العبد ومَحوها،وأنه ليس هنالك إلا الحق تعالى هو العين والصفة،وهو الظاهر بأحكام عين العبد الثابتة في العلم والعدم،إذ العبد معدوم أبداً،كما هو معدوم أزلاً. وإنما هو عبارة عن الأحكام العدميّة التي ظهر الوجود الحق بها لا غير،ولا حلول ولا إتّحاد كما يفهمه العُميان،ولا تأويل كما يقوله أصحاب الدليل والبرهان. وسَمّى الحق تعالى نفسه في هذا الظهور وهذه المرتبة عَبْداً،وهو العزيز الحكيم،ولا يُسأل عما يفعل.
ويدُلّ قوله تعالى: (كنت سمعه..) الحديث،أنه تعالى سميع بذاته بصير بذاته.. ولا يُفهم منه أنه لم يكن كذلك،ثمّ كان. وإنما المُراد رفع الحجب عن هذا المُتقرّب بالنوافل حتى يُشاهد الأمر على ما هو عليه في هذه المرتبة وهذا الظهور..
فتَحت إشارة هذا الحديث الربّاني بُحور زاخرة،تَرجع العقول عنها حائرة كأنها حُمْر مٌستنفرة فَرّت من قَسورة.
== (الموقف الثاني والثلاثون) ==
قال الله تعالى: (وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دعان) [البقرة: 186].
إعلم أن الحق تعالى لا يُعطي أحداً ما يطلُبه بلسان مَقاله،إلا إذا وافَق طَلب لسانه طَلب إستعداده.. والإنسان قد يكون له إستعداد الطلب باللسان،وما يكون له إستعداد قبول المطلوب. فإذا سأل أحد من الحق تعالى شيئاً ولم يُعطه إيّاه،فإنما ذلك لكون إستعداده طلب خلافه،وليس له إستعداد لقبول ذلك المطلوب،وإلا فتعالى الحق أن يمنع أحداً عن بُخل..
فالآية الكريمة،وإن كانت مطلقة في ظاهر اللفظ،فهي مُقيّدة بطلب الإستعداد وسُؤاله. فإن مَدار الأمر كلّه على الإستعداد للقبول،سواء طلب أو لم يطلُب. والإستعدادات الكُلّية قديمة،لم يتعلّق بها جَعْل،وإنما حَصلت بالفيض الأقدس الذّاتي. فالحق تعالى حكيم،لا يُعطي أحداً شيئاً هو غير طالب له بإستعداده،فيكون مستعداً لقبوله..
[ الفيض الأقدس الذاتي: هو التجلّي من الكثرة الأسمائية غير المَجعولة. أو هو التجلّي الحُبّي الذّاتي الموجِب لوجود الأشياء وإستعداداتها في الحضرة العلمية. أو هو التجلّي الذّاتي والفيض الغيبي من غُيوب الشؤون الذاتيّة. أو هو تَعيّن المعلومات في العلم الأزليّ ].
_ وفي [الموقف الرابع والتسعون] يقول الأمير: قال الله تعالى: (وإنا لمُوَفّوهم نَصيبهم غير منقوص) [هود: 109]. فنَصيب كل مخلوق هو مُقتضى حقيقته وإستعداده،الذي لا يُزاد عليه ولا يَنقص منه،وهو معنى: (أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى). ولكل مخلوق إستعداد،هو نَصيبه من الحق تعالى،ولا يُشبه إستعداداً آخر من كل وجه أبداً. وسبب هذا الإختلاف هو الوجه الخاص الذي لكل مخلوق من الحق تعالى،فلا تكرار في الوجود أبداً. فالإستعداد هو الطالب المُجاب،الدّاعي الذي لا يُرَدّ دعاؤه،وهو المُراد بقوله تعالى: (أجيب دعوة الداع إذا دعان). إن كان المراد الإجابة بالمطلوب،ف(أل) في (الدّاعي) للعَهْد،وهو الدّاعي الذي يُقبَل دعاؤه ولا بُدّ،وليس ذلك إلا الإستعداد. فالإستعداد مُجاب،وافَقه اللسان أو خالَفه،أو لا وافَقه ولا خالَفه،وهو معنى ما ورد في الصحيح: (كل مُيَسّر لما خُلق له).. فدعاء اللسان مُجرّداً عن الإستعداد،لا أثر له في الإجابة بالمطلوب البتّة. كيف يكون الدّعاء اللاّحق،سَبباً في القضاء السّابق؟.. فما أمَر الحق تعالى عباده بالدعاء،وجعله الشارع صلى الله عليه وسلم مُخّ العبادة،إلا تَعبّداً وإظهاراً للفاقة والحاجة التي هي صفة ذاتيّة لكل ممكن.. قال صاحب الحكم العطائية: [الدّعاء كُلّه مَدخول،إلا ما كان بنيّة التعبّد والتقرّب،فهو مقبول].. وهذه من مقامات الحَيْرة،أمَرَنا بالدّعاء،فإن دَعونا يقول لنا: لِمَ تَدعون؟ جَفّت الأقلام وطُويت الصّحف.. وإن لم ندعُ،تَوعّدنا وتَهدّدنا: (قل ما يعبؤا بكم ربّي لولا دعاؤكم).. وهذه الحالة من “سِرّ القدر”،الذي لا يطلع عليه إلا الناذر الفرد. وأما القدر نفسه،فما عَلمت هَل يطّلع عليه أحد أو لا؟.. _ وفي [الموقف السابع والتسعون]،في قوله تعالى: (وقيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيراً)،يقول:
فالإستعداد هو الأصل،والأسباب الخارجية تابعة له. وهو أزليّ قديم،غير مجعول. فالنازل بكل إنسان،هو من لَوازم عَينه الثابتة،وتأثير القُدرة تابع للإرادة،والإرادة تابعة للعلم.. والعلم تابع للمعلوم،تَبعيّة رُتبة،لا تبعيّة زمان. بمعنى أن تسميّته علماً،إقتضت تبعيّته للمعلوم. أعني ما دام المعلوم في حضرة العلم،الذي هو عين الذات،من كل وجه وإعتبار،لم يوصف بالوجود الخارجي. وأما بعد الوجود الخارجي وتعلّق العلم،الذي يُعبّر القوم عنه بظاهر العلم،كان المعلوم حينئذ تابعاً للعلم،إذ الوجود الخارجي ظلّ وحكاية لهذا العلم (الظاهر)،كما أن العلم الذاتي حكاية للمعلوم،وهو معنى تَبعيّته. والمعلوم هو ذلك الذي لا يتبدّل ولا يتغيّر ولا ينقلب،إذ لو تغيّر لكان جهلاً،تعالى الله عنه.. فالنّازل بكل إنسان لازمُه وحقيقته..
== (الموقف الرابع والثلاثون) ==
قال الله تعالى: (فوَلّ وجهك شَطر المسجد الحرام) [البقرة: 144].
اعلم أنه لا وجود إلا الوجود الواحد الحق تعالى،والمُسمّى عالَماً،والمخلوقات مظاهره.. فحَقّ بلا خَلق،لا يَظهر. وخَلق بلا حقّ،لا يوصَف بالوجود.
والوجود الحق واحد،لا يتعدّد ولا يتغيّر ولا ينحصر ولا يُحَدّ ولا تُقيّده الأكوان والمظاهر. ومظاهره متعدّدة متغيّرة مُنحصرة مُقيّدة.. والحقّ ما عُرف إلا بجَمعه الأضداد،فكل المُتضادّات في العالَم هو جامع لها،بل هو عَيْن الأضداد كلّها. وإنما يَظهر في كل صورة بحُكم إستعدادها،وبما هو من أحوال عَيْنها الثابتة في العلم والعَدم..
وعليه فالحقّ تعالى ظهر في الصورة المُسمّاة بالكعبة بصورة المَعبودية،وهو المَعبود،وإن وقعت العبادة للكعبة في الحِسّ. كما أنه ظهر في الصورة المُسماة بمحمّد بصفة العابديّة،وهو العابد،وإن ظهرت العبادة من الصورة المحمدية في الحسّ والعقل.
فسَمّى نفسه عابداً في مَظهر،لظهوره فيه بصفة العابد. وسَمّى نفسه في مظهر مَعبوداً،لظهوره فيه بصفة المَعبود. إذ المُسمّى مَخلوقاً،ليس هو إلا أسماؤه تعالى ظهرت بذلك الشكل وتلك الصورة. والأسماء أمور عَدميّة،فظهورها في التحقيق ظهور ذاته السّاريّة في كل مخلوق من غير سَريان. ولكن الذّات باطنة هنا،لظهور التعدّد في الأسماء،ومُقتضى الوحدة بظهور الأسماء،فهي باطنة حال ظهورها.
وقد نقل عن الشيخ الأكبر أنه قال: (مَظْهريّة الكعبة أفضل من مَظهريّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم). فإذا صَحّ النّقل عنه،فوجهه ما ذكرناه: من مَظهرية العابديّة والمَعبودية،لا غير. ولا يلزم منه فضل الكعبة،ولا هو مذهب الشيخ ولا غيره من العارفين.
== (الموقف التاسع والثلاثون) ==
قال الله تعالى: (بل هم في لَبْس من خَلق جديد) [ق: 15].
ورد في الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مَرّتين على صورته،فرآه قد سَدّ الأفُق لعِظَم صورته.
وورد في أخبار كثيرة: أن جبريل كان يدخل عليه صلى الله عليه وسلم في حُجْرة عائشة،ويجلس معه فيها. وفي بعض الأخبار: أن جبرائيل وإسرافيل جَلسا معه صلى الله عليه وسلم في الحُجرة.
العالَم كُلّه ــ العرش وما حَواه من الصور،سواء كانت حسيّة أو عقلية أو خيالية ــ فهي أعراض،والمُقَوّم لها والقائمة به هو الوجود الإضافيّ المُسمّى بنَفَس الرحمن،وبالأسامي الكثيرة،فهو كالجَوهر لها.
وكما أن العَرَض،المعروف عند المتكلمين،لا يَبقى زَمانين عند الأشاعرة.. فكذلك هذه الصورة المحسوسة،التي هي أعراض عند أهل الله تعالى،العارفين به وبحقائق الأشياء،وهي جواهر عند الجاهلين بالله تعالى وبحقائق الأشياء..
ففي كل آن يَخْلع النَفَس الرحماني،الذي هو مُقوّم للصُور،صورة ويَلْبس أخرى،إما مِثل الأولى أو مُخالفة لها،هكذا على الدّوام.
وهذه الصورة المحسوسة هي عند التحقيق نِسَب وإضافات وإعتبارات،وهي أحكام الأعيان الثابتة في العلم والعَدم،المعدومة أبداً وأزلاً،يظهر بها نَفَس الرحمان المُسمّى أيضاً ب(أمر الله) الذي هو كلَمح البصر،ولا بَقاء لها ولا ثَبات..
== (الموقف الواحد والأربعون) ==
قال الله تعالى: (فإذا قَرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل: 98].
الحكمة في الأمر بالإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم،عند إرادة قراءة القرآن،وعدم الأمر بذلك عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الذكر أو غير ذلك من سائر العبادات،هو أن القصد الأول بالقرآن: بَيان الأحكام من حلال وحرام ووجوب وحَظر،وذكر قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية،مع ذكر الجنة والنار.. فكأن قارئه لا يقصد منه،غالباً،إلا معرفة ما ذُكر. فأمر لذلك بالتّحصين من الشيطان،لئلاّ يُضلّه عن طريق الرّشاد.. بخلاف سائر العبادات،فليس المقصود منها عند التلبّس بها،إذا كانت جارية على مُراد الله،إلا مُجالسة الحق تعالى والخُلوة به،مع صَرف النّظر عن كل مخلوق.. ومن كانت عبادته على هذا الوجه،فما للشيطان عليه من سَبيل،فهي حصنه من الشيطان.
فتبيّن من هذا: أن المقصود الأغلب من قراءة القرآن،أحكام الله تعالى ومخلوقاته. والمقصود من سائر العبادات،الله عَينُه.
ولهذا ترى العارفين بالله وبطريق السلوك إليه،يُسَلّكون مُريديهم بالأذكار وسائر نَوافل الخيرات،ولا يأمرونهم بالتّلاوة إلا قدر الحاجة. لأن تلاوة القرآن للمُبتدئ الجاهل بالله تعالى،لا تُجديه غالباً في رَفع حُجُبه والترقّي إلى المراتب العَليّة. والعارف الكامل يَتلوه على طريق لا يهتدي إليها غيره،فيستخرج منه الأسرار والعلوم والمعارف والفوائد التي تَحار العقول فيها.
== (الموقف الثالث والأربعون) ==
قال الله تعالى: (كلاّ إنهم عن ربّهم يومئذ لمَحجوبون) [المطففين: 15].
كُلّ من يَسمع ذِكر الحجاب،من غير العارفين،يتوهّم أن هناك حجاباً ومَحجوباً ومَحجوباً عنه،وهذا وَهم باطل. لأنه ليس ثَمّة إلا الحق تعالى والخَلق،أعني مرتبة الوجوب والإمكان،ولا واسطة بينهما..
وأما ما ورد في الخبر: (إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة،لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه ما أدركه بَصره من خَلقه).
فالمُراد بالحُجُب هنا: المظاهر العظيمة والتعيّنات الفخيمة التي هي حُجُب على نَفسها وعلى غيرها. وليس المراد خصوص هذا العدد،وإنما المراد التّكثير: فالحُجب النورانية هي الحقائق الغيبية،والحجب الظلمانية هي الحقائق الكونية،وكلها مُتّفقة في الحِجابيّة،بمعنى أنها سَتَرت المَحجوب،لا أنها سَتَرت الحق تعالى عن ذلك..
كل من رأيناه تكلّم على هذا الحديث،من العارفين،رأيناه جعل ضمير (بَصَره) عائداً على الحق،والذي ألقاه الحق عليّ: أنه عائد على ما وَقعت عليه (ما)،وهي واقعة على المخلوق. إذ الحق ليس بمحجوب،وبَصره يُدركنا بلا رَيْب. وإنما نحن المحجوبون،وأبصارنا لا تُدركه. فإذا أراد الحق رفع الحجاب وكَشفه عن أحد من مخلوقاته،وليس إلا الجهل،وواجَهته السُبحات الوَجهيّة،أحْرَقت خَلقيّته فزالَت حِجابيّته وثَبتت حَقيّته. وفي الحجاب رحمة لبعض الخلق،وفي كَشفه رحمة لبعضهم.. فالمُمتنع هو كَشفه عن الجميع..
== (الموقف الرابع والأربعون) ==
روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مَرّ بقوم يُؤبّرون النّخل،فقال لهم: (لو لم تفعلوا لصَلُحت) الحديث.
ليس المُراد من هذا: أنه صلى الله عليه وسلم يُريد منهم تَرك الأسباب العاديّة التي أجرى الحق عادَته بها في مخلوقاته،إذ الرّسل والعارفون إنما يأمرون برَفْع حُكم الأسباب لا برَفع عَيْنها. بل يأمرون بإثبات عينها من حيث أن الأسباب وضعها وأثبتها الحكيم العليم،بما يُجريه ويُثبته سبحانه. فمن طلب رفع العوائد الجارية والأسباب العادية،فقد أساء الأدب وجَهل..
وإنما المُراد أنه صلى الله عليه وسلم أرادَ أن يُنبّههم على باطن الحقيقة ونَفس الأمر،وهو أن هذه الأسباب العادية والصورة المشهودة،لا تأثير لها في شيء ممّا جَرت به العادة أنه يوجد عندها. وإنما الحق هو الفاعل لذلك،فهو المؤثّر بوجهه الخاص الذي له تعالى في كل مخلوق.. وإنما سَتَر تعالى فعله بصور مخلوقاته رحمة بخَلقه وتَقديساً لجنابه.. فلا بدّ من الأسباب وجوداً،والغيبة عنها شُهوداً.
وقوله صلى الله عليه وسلم،لمّا طَلعت النخل شيصاً: (أنتم أعرف بدنياكم) هو كلام خرج منه مخرج الإعراض عنهم،حيث ما فهموا مُراده بقوله (لو لم تفعلوا لصلحت)،وحملوه على ترك التأبير. بينما كان المُراد: أنه تعالى يفعل الأشياء عند الأسباب وعند عدم الأسباب،وهو التوحيد الحقيقي..
وقد تكلّم إمام العارفين محيي الدين،وصاحب الإبريز،على هذا الحديث بغير ما ألقاه تعالى إليّ. والكلّ صواب،إن شاء الله،فإن الكل من عند الله.
== (الموقف الثامن والأربعون) ==
ورد في الخبر: (من عرف نفسه عرف ربّه).
يعني: من عَرف نفسه التي هي ربّه المُقيّد،عرف ربّه الذي هو نفسه المطلق.
فإن حقيقة النفس هي الروح،وحقيقة الروح هو الحق تعالى. وإتّحد هنا الشّرط والجَزاء،والفرق بينهما التّقييد والإطلاق،أعني إتّحادهما معنى لا لفظاً.
فإن كانت النفس لا تُعرف،بل هي مجهولة أبداً،فكذلك الربّ لا يُعرف أبداً،إذ المُعلّق على الممنوع مَمنوع. بل الربّ تعالى أحَقّ وأولى بعَدم تعلّق المعرفة به. فمعرفة الربّ مَشروطة بتَقدّم معرفة النفس. والتّقديم رُتَبي لا زماني،إذ ليس في هذا المقام زمان.. والقضية الشّرطيّة لا تَقتضي وجود المُقَدّم،بل ولا إمكانه. قال تعالى: (لئن أشركت ليحبطنّ عملك) وهو لا يُشرك،بل لا يُتصوّر منه الإشراك..
وإن كانت النفس تُعرف من وجه دون وَجه وباعتبار،لا من وجه وإعتبار. فكذلك الربّ يُعرف من وجه وإعتبار،دون كل الوجوه والإعتبارات..
فالناس مُتفاوتون في معرفة نفوسهم،كما هم مُتفاوتون في معرفة ربّهم،بما لا يكاد يَنحصر ولا يدخُل تحت ميزان.
== (الموقف التاسع والأربعون) ==
قال الله تعالى: (قل إن كنتم تُحبّون الله فاتّبعون يُحببكم الله) [آل عمران: 31].
محبة الله تعالى،من حيث الذات الغنيّة عن العالمين،التي لا تطلُب العالَم ولا يطلُبها،مُحال. لأن المحبّة لا تكون إلا بمناسبة،ولا مناسبة بين الخلق والذات البَحْت،ولا إرتباط بوجه ولا حال..
الذّات تُشهَد ولا تُعلَم،ومرتبة الصّفات تُعلم ولا تُشهد. فمرتبة الصفات،وحضرة النّسب والإضافات،هي المَحبوبة لجميع المخلوقات. فما أحَبّ مُحبّ إلا حضرة الجمال ونُعوت الإفضال،كالإنعام والإفضال والرحمة والغفران،ونحو ذلك.
وعند التحقيق: ما أحَبّ مُحبّ إلا آثار صفات الجمال،بل ما أحبّ إلا نفسه. ومن هنا قال مُحقّق العارفين: لا يكون أنْس بالذّات العَليّة أبداً،لعدم المناسبة والمجانسة،وإنما يكون الأنس ببعض الأسماء الجمالية..
قال صلى الله عليه وسلم: (أحبّوا الله لما يغذوكم به من نِعَمه) فأرْشَد إلى أن محبّة الله تعالى لا تكون إلا من هذا الوجه،وهو كونه مُنعماً رحيماً سَتّاراً،ونحو ذلك،وهي مرتبة الصفات..
في الحكاية المشهورة بين القوم،عن أبي سعيد الخراز أنه إجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله شَغلتني محبّة الله عن محبّتك. فقال له صلى الله عليه وسلم: (يا مُبارك،محبّة الله هي محبّتي).. يُريد: شَغلتني محبّة المظهر الروحي العُلوي،عن محبّة المظهر الجسمي الأرضي. فأجابه صلى الله عليه وسلم بأن الظاهر في المَظهرين واحد لا تعدّد فيه ولا تغايُر،فالمحبوب في المظهرين واحد.. وليس الظاهر في جميع المظاهر العلوية والسفلية،إلا الصورة الرحمانية،المُسماة بالحقيقة المحمدية.. فالرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة ظُهور الحق تعالى،وهذه المرتبة واسطة لجميع الظّهورات،ومنها تَفرّعت،فهي يَنبوعها وهَيولاها.
== (الموقف الخمسون) ==
قال الله تعالى: (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) [الأنفال: 17].
إعلم أن نسبة الفعل الصّادر في بادئ الرّأي من المخلوق،جاءت متنوّعة في الكتاب والسنّة. فمَرّة جاءت نسبة الفعل إلى المخلوق،ومرّة إلى الله تعالى بالعبد،ومرة إلى العبد بالله تعالى.
فأما نسبته إلى الله،فمن جهة أنه الوجود الحقّ والفاعل الحقيقي. وأما نسبته إلى المخلوق،فمن جهة أنه مصدر الفعل في الحِسّ. وأما نسبته إلى الله بالمخلوق،فمن جهة أنه آلة الفعل. وأما نسبته إلى المخلوق بالله،فمن جهة أن المخلوق مَظهر وتَعيّن للحق. والحق غيب،والمخلوق شهادة..
ومن كان كاملاً بالحقائق،ذا عَينين،قال: الفعل للحق تعالى من حيث هو فعل العبد،وفعل العبد من حيث هو فعل الربّ. إذ ليس في الأمر إلا الوجود الحقّ،الظاهر بأحكام الأعيان الثّابتة التي هي نِسَب الوجود وإعتباراته تَسَتّر بها،وتَسمّى بإسم العبد والمخلوق،ووُصف بأوصافه في هذه المرتبة،وهذا الظّهور. ومن عجيب أن الظهور تَستّر،والتستّر ظهور..
وقد قال إمامنا وأستاذنا أبو حامد الغزالي: إن مسألة نِسبة الفعل،الصّادر في العبد،إلى الله تعالى أو إلى العبد،لا يرفع إشكالها شرعُ،يعني الأدلّة الشرعيّة،ولا عقل ولا كشف. ونحن ــ والمنّة لله ــ رُفع عنّا إشكالها بالكشف،مع أننا نعلم يقيناً أن كشف الشيخ أتَمّ وأعلى بما لا نسبة بيننا وبينه،والله أعلم بمَطْمَح نَظر الشيخ.
== (الموقف الواحد والخمسون) ==
قال الله تعالى: (ونُنشئكم في ما لا تعلمون) [الواقعة: 61].
يوجد في كلام سادات القوم لفظة (الإنسلاخ)،كما يوجد لفظة (المعراج التّحليلي)،ومعنى اللفظتين واحد.
وإيضاحه: هو أن يعلم أن كلّ ما يُطلق عليه إسم موجود،في أيّ مرتبة من مراتب الوجود كان،ليس هو إلا الحق تعالى،ظاهراً ومُقيّداً،بحسب تلك المرتبة التي حصل الظهور فيها. فهو الظاهر في مَلابسه اللّبسيّة،المُتعيّن بأسمائه القُدسيّة. والظّهورات والتعيّنات والتقيّدات كلّها،أمور إعتبارية عقلية،لا وجود لها خارج العقل،كسائر الأمور المصدريّة.
ولما ظهرت حقيقته المطلقة مُقيّدة،في بادئ الرّأي والوَهْم،وإلا فهي مطلقة حالة الحُكم عليها بالتّقييد.
ولا يكون العارف كاملاً حتى يَشهد الإطلاق في التقييد،والتقييد في الإطلاق،في آن واحد. إنْحَجب،من حيث تقييده،عن نفسه،من حيث إطلاقه،فإشتاق المطلق إلى الإتّحاد بالمُقيّد.. فأرسل الرّسل لذلك،وشرّع الشّرائع،وأمر بإستعمال الأدويّة والأسباب المُعينة على رفع الحُجُب المَسدولة على المُقيّد بالوَهْم والخيال،حتى يتّحد المطلق بالمُقيّد،الإتّحاد النّسبي المعروف عند أهله. وليست الأسباب الرّافعة للحُجُب إلا الأدوية التي ركّبتها الرّسل،من العبادات والأوامر والنّواهي والرياضات والمجاهدات.
صورة كل شيء،كائناً ما كان،حَقاً أو خَلقاً،هي ما به ظهور ذلك الشيء وتَعيّنه من غَيبه النّسبي. فالأجسام صور الأرواح،والأرواح صُور الأعيان الثابتة،والأعيان الثابتة صور الأسماء الإلهية،والأسماء الإلهية صور الذات العَليّة..
فإذا إستعملت حقيقة من الحقائق المُقيّدة،الأدوية التي جاءت بها الرسل،على وجه مخصوص وكيفية معروفة عند أهل هذا الشأن،حَصَل له علم ضروري،كسائر الضروريات،بأن هذا الجسم ليس هو بشيء حَقّ له حقيقة وثُبوت،وإنما هو خَيال ووَهم..
فإذا داوَم على التوجّه والإقبال على الله،ودَأب على ذلك،حَصل له علم وشعور بأن هذا التعيّن الروحي مثل التعيّن الجسمي،لا حقيقة له،ويرى أن حقيقته الخَفيّة إنما هي عَينُه الثابتة في العلم القديم. وحينئذ يَصير في علمه وشعوره عَيناً ثابتة،ثمّ بعد هذا يحصُل له علم بأن حقيقته إنما هي الأسماء الإلهية،وحقيقته الخَفيّة هي الذات العَليّة،لأن الإسم عين المُسمّى،ما هو بشيء زائد على ذات المُسمّى إلا في التعقّل..
فإن السالك،ما دام مُقيّداً بهذا الهيكل،لا يعرف الله تعالى،فإنه لا يعرف الله إلا الله. فإذا تَجرّد السالك من كل تعيّن جسمي وروحي وقلبي وفنّي،وَصَل إلى العلم بالله تعالى،وتَحصُل له علوم وأسرار ما كانت تخطُر له ببال.
وبعد هذا: إما أن يُمسكه الحق عنده أو يرُدّه فيَلبس مَلابسه الأوّل التي كان خَلعها فيلبسها،لكن على غير اللّبْس الأول. ففي اللبس الأول: حقّ ظهر بخَلق،باطنُه حَق وظاهره خَلق. وفي اللّبس الثاني: حقّ ظهر بحقّ،فهذا هو الإنسلاخ والمعراج التحليلي..
== (الموقف الثالث والخمسون) ==
قال الله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُلنا) [العنكبوت: 69].
دخول جنّة المعارف والمُشاهدة،خلاف دخول جنّة اللّذائذ المحسوسة.
فجنّة المعارف والمشاهدة دُخولها،غالباً،بالكَسب والمُجاهدة،كما قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا) أي جاهدوا أنفسهم بسَببنا. ثمّ تُقسّم بالوَهب والجود الإلهي والإستعداد. ودخول جنّة اللذّات المحسوسة يكون بالرحمة،ثمّ تُقسّم بالأعمال،كما ورد في الخبر: (أدخلوها برحمتي وإقتسموها بأعمالكم).
والحكمة في الإختلاف: أن جنة اللذات المحسوسة يَستحقّها كل مؤمن،ولو بعد حين،بحسب الوعد الصادق.. وأما جنّة المعارف فإنها مخصوصة بقوم مخصوصين،من خواصّ المؤمنين،أصحاب المجاهدات والرياضات.. ولو دخل المؤمنون كلّهم جنة المعارف والمشاهدة في الدنيا،ما دخل أحد من المؤمنين النار يوم القيامة..
أهل جنّة المعارف الإلهية أشهَدهم الحق،أولاً،أنفسهم كغيرهم،فشَهدوها فاعلة تاركة مُختارة. ولهذا تراهُم في بدايتهم يُعاقبون أنفسهم إذا حَصَل منها تقصير،ويَشكرونها إذا وَفّت بالعمل في زَعمهم..
سأل بعض العارفين،مُريداً لبعض المشايخ،فقال له: بِمَ يأمُركم شيخكم؟ فقال المريد: يأمرنا بالأعمال ورؤية التّقصير فيها. فقال له العارف: أمركُم بالمَجوسية المحضة. هَلاّ أمركم بالأعمال والغَيبة عنها بشُهود مُجريها..
ثمّ إذا رَحمهم الله وفَتح لهم الباب ودخلوا جنّة المعرفة والمُشاهدة،عَرفوا أنهم ليس لهم من الأمر شيء،من حيث ظاهرهم ومن حيث أنفسهم.. فغابوا عن أنفسهم،وعن العقل والوَهْب،وإسْتَغرقهم مُشاهدة الواهِب،فإصطفاهم الحق لنفسه وإختارهم لمُجالسته.
وأما أهل الجنّة المحسوسة،فإن الحق أشهدهُم أيضاً كَسبهم وإختيارهم. فهم يعملون الصالحات ويَنسبونها لأنفسهم،قاصدين الوصول إلى الجنة المحسوسة،غافلين عن جنّة المعارف والمشاهدات،فأبقاهم الحق على غَفلتهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الحساب وفي حال دخول الجنة،إلى وقت الرؤية في الكثيب الأبيض. ولذا يقول لهم الحق: (تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون)..
== (الموقف السادس والخمسون) ==
قال الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل: 40].
فقوله: (قَولُنا) يُريد أنه مُتكلّم.. فلا مناسبة بين كلام الحق وكلام المخلوقين إلا من هذا الوجه الواحد،وهو إيصال ما في نفس المُتكلّم إلى السّامع.
وكلام الحق على نوعين: بغير واسطة مشهودة،ويُسمّى إلهاماً أو إلقاءً ونحو ذلك. وبواسطة مشهودة،وهي المظاهر الروحانية،ويُسمّى وَحياً.
وكلام الحق يَسمعُه الأنبياء،وللأولياء منه نَصيب،ولكن أذواقهم في السّماع مختلفة مُتباينة. فليس ذَوْق النبيّ كذَوق الوليّ،فبين ذَوقيهما ما بين رُتبتيهما. وإنما إختصّ موسى عليه السلام بإسم (الكَليم)،من بين سائر المُكلّمين،لذوق إختصّ به موسى لا يعلمه إلا هو..
قال تعالى: (فأجره حتى يسمع كلام الله). وكلامه صفته،وصفته لا تقوم بغير ذاته. أي حتى يَسمع كلام الله بمَظهريّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كلام الله،من حيث أنه كلام رسول الله،من حيثيّة واحدة. فافهم وإلا فسَلّم تَسلم،ولا تُنكِر تَندم،إذا كُشف السّاق والقَدم.
وكما أن ظهور الحق بالصُور حادث،فكذلك كَلماته. لأن كلماته أفعاله،وأفعاله حادثة. وأعني بكلماته: مخلوقاته المُخاطبة ب(كُنْ)،لا نفس الكلام الذي هو صفته. وصفاته تعالى إذا نُسبت إلى مرتبة الإطلاق،تكون مُطلقة،فيتعلّق علمه وكلامه بالواجب والممكن والمستحيل،وتتعلّق قُدرته وإرادته بكلّ ممكن،وسمعه وبصره بكل مُستعدّ لأن يَرى ويَسمع. وإذا نُسبت إلى مراتب التّقييد،لا تَظهر إلا مُقيّدة،فيتعلّق العلم ببعض المعلومات،والقدرة ببعض المقدورات،وقِسْ على ذلك..
== (الموقف السابع والخمسون) ==
رأيت في بعض بعض المَرائي: أني جالس في قبّة بيضاء،وأنا أتكلّم مع أشخاص لا أراهُم. فتَكلّمنا في قول القطب عبد السلام بن مشيش: (واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي،وروحه سِرّ حقيقتي).
فقلت لهم: سأل الشيخ بهذا أن يكون الحجاب الأعظم ــ وهو الحقيقة المحمديّة والتعيّن الأول المُسمّى بالأسماء الكثيرة،بحسب إعتباراته ووُجوهه ــ حياة روحه. أي: إجعلني به حَيّاً على الكمال،لا مطلق الحياة،لأن الروح مُستلزم للحياة ولا عكس. فكل روح حَيّ،وليس كل حَيّ له روح.
ومطلوب الشيخ ومقصوده: أن يكون روحه مَظهراً كاملاً ومَجلى تاماً للروح الكُلّ،الذي هو الحجاب الأعظم والحقيقة المحمدية. إذ كلّ روح إنما هو من الروح الكُلّي المحمّدي،ولكن لا على الكمال،إلا أرواح الكُلّ الحاصلين على رتبة الكمال من الوَرثة المحمديين،فإنه ينطبع فيه كإنطباع الطّابع في الشمع ونحوه.. والمُنْطَبع حقيقة وأصل،والمُنْطَبع فيه مجاز وفرع.. فإن تبايُن حقيقة كل واحد من المَوصوفين بالصّفة الواحدة،مُؤذِن بعدم المشابهة بينهما في النّسبة. وأين الشمس من شُعاعها الظاهر في الحائط..
وقوله: (وروحه سِرّ حقيقتي): يُريد الشيخ روح الحجاب الأعظم،فالضمير عائد عليه. وروح الشيء ما به قوامُه،وروح الحجاب الأعظم هو الذّات الغيب المطلق البَحت،الذي لا يُعبّر عنه بعبارة ولا تتطرّق إليه إشارة. إذ الحجاب الأعظم هو غاية معرفة العارفين،ونهاية السائرين. غير أنهم عَلموا أن وراء هذا الذي أدركوه شيئاً من حقيقته،وصفته نفسه أنه لا يعرف ولا يُدرك منه سوى وجوده،لا غير. فكان إدراك العجز عن إدراكه إدراك،إذ العلم إنكشاف المعلوم على ما هو عليه..
واعلم أن كثيراً من أهل الرياضات والمجاهدات،على غير طريق الأنبياء،وَصَل إلى الروح الكُلّي،فظنّ أنه هو حقيقة الحقائق،وأنه ليس وراءه مَرمى،فكفر ورجع من حيث جاء. ولهذا يقول بعض سادة القوم: (ما رَجع من رجع إلا من الطريق،ولو وصلوا ما رجعوا) يعني الوصول إلى الذات الغيب المطلق،إذ ليس وراء الله مَرمى. وأما مرتبة التعيّن الأول والحقيقة المحمدية والحجاب الأعظم،فوراءه مرمى،وهو الله،من حيث أنه إسم مُرتَجل،عَلَم على الذّات الغيب المحض،لا شيء فيه من الوَصْفيّة.
== (الموقف الثمان والخمسون) ==
قال الله تعالى: (للذين أحسنوا الحُسنى وزيادة) [يونس: 26].
الإحسان هو الحضور مع الله تعالى في الأعمال الصالحة،وهو يستلزم إخلاص العمل من كل شَوْب.
وفَسّر صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه) يعني العبادة على الحُضور. فالعبادة الخالصة من الشرك الخَفيّ،لا تكون إلا لمن دخل حضرة الإحسان..
و(الزيادة): هي المعرفة والشّهود اللاّئقان بالدار الآخرة،فإن الشهود هناك أتَمّ والمعرفة أكمل.. وإن كان الحجاب مُصاحباً في الدّارين،لأن رداء الكبرياء لا يرتفع عن وجهه تعالى،لا دنيا ولا آخرة.. ورداء الكبرياء هو أول التعيّنات،وهو الحقيقة المحمدية..
== (الموقف الستّون) ==
قال الله تعالى: (وكَبّره تَكبيراً) [الإسراء: 111].
أي: تَكبيراً بالغاً في الفخامة والضخامة غاية ما يُتصوّر.
وإنما أمِر المُصلّي بقول (الله أكبر) عند دخوله في الصلاة،وعند إنتقالاته في الركوع والسجود والرّفع منه،إلى تمام الصلاة،لكونه أمر بأن يعبُد الله كأنه يراه،وأن يعتقد أن الله في قِبلته،وأنه بينه وبين قبلته،وأنه يُناجيه..وأمثال هذا. وكل هذا يستلزم التّخييل والتّصوير لا مَحالة. وكل مُصَلّ،بل مخلوق،يتصوّر معبوده ويتخيّله،بمعنى أنه يعتقد في معبوده أنه كذا وليس كذا،وهذا هو التصوّر والتخيّل.
ولمّا كان الأمر هكذا،وعلى ما ذكرنا،أمر المُصلّي وغير المُصلّي أن يقول: (الله أكبر)،بصيغة المُفاضلة،أي مُسمّى الله في مرتبة إطلاقه أكبر وأعظم من أن يتخيّل أو يُتصوّر،أو تَحوم حَول حِماه شائبة تَقييد بجهة أو صفة،أو يَحصره نَعت أو إعتقاد..
== (الموقف الثاني والستون) ==
قال الله تعالى: (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) [القمر: 50].
إعلم أن كل ما يقع إليه الإدراك،من محسوس ومعقول ومُتخيّل،فهو مُتغيّر مُتجدّد في كل نفس،يوجد ويُعدَم. إذ كل مُدرَك فهو صورة قائم بغيره،كقيام العرض بالجوهر عند علماء الكلام. وذلك الغير المُقَوّم لتلك الصورة،هو نفس الرحمن وأمر الله وحقيقة الحقائق،وله أسماء كثيرة بحسب إعتباراته. والكون كلّه،العرش وما حوى من عالم الأرواح وعالم المثال وعالم الأجسام،أعراض. ونفس الرحمن مُقَوِّم لها،وهي قائمة به.
ولولا أن هذه الصُوَر المُدرَكة،بأيّ مُدرَك كان من أنواع الإدراكات،أعراض،ما صَحّ إنقلاب العَصا حَيّة ولا العرجون سَيفاً،ولا صَحّ مَسْخ. إذ لو كانت هذه الصور المُدرَكة هي حقائق الأشياء،ما صحّ إنقلابها،لأن قَلْب الحقائق مُحال..
وإذا صحّ أن كل ما يتعلّق به الإدراك،مطلقاً،صورة،بمعنى عَرَض قائم بغيره،فهو لا يبقى زمانين،كما تقول الأشاعرة من المتكلمين.. وقال بعدم بقاء الجسميّة زمانين،قوم من الحكماء قديماً،عَقلاً. والقوم قالوه كَشفاً..
== (الموقف الثالث والستون) ==
قال الله تعالى: (فتَمثّل لها بَشراً سَوياً) [مريم: 17].
ورد في صحيح مسلم: (تَجلّي الحق لأهل المحشر،وتحوّله في الصُور). وفي الصحيح المتواتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل في صورة دحية ويعرفه أنه جبريل،والصحابة يجزمون أنه دحية.
وهذا هو التجلّي الذي أنكره علماء الرّسوم المَحجوبوبن على العارفين،ورَموهم بالحلول والإتّحاد. ولو أنصفوا ما أنكروا ما جَهلوا،لأن الحكم على الشيء،تَصويباً وتزييفاً،فرع من تصوّره. وهم ما تَصوّروا التجلّي والشّهود،على ما هو عند القوم. فما رَدّ علماء الرّسوم إلا باطلهم الذي تصوّروه في أنفسهم.. إذ القوم لا إثْنَينيّة عندهم،ولا يقولون بوجودين: قديم وحادث،حتى يتّحد أحدهما بالآخر أو يحُلّ فيه. فحقيقة الوجود عندهم واحدة،لا تتعدّد ولا تتجزّأ ولا تتبعّض،وهي ما به وجدان الشيء وتحقّقه الذي له بالذات.
فالأشياء كلّها،لا تَظهر ولا تتعيّن،إلا بظهور الوجود الحقّ فيها،من غير حلول ولا إتحاد ولا إتّصال ولا إنفصال. كما أن الوجود الحق لا يظهر ولا يتعيّن إلا بمخلوقاته..
والقوم لا يُثبتون الوجود إلا لشيء واحد،وهو المُقَوّم القائم على العالَم جميعه،جَواهره وأجسامه وأعراضه،والعالَم كلّه أعراض عندهم.. ولو أدركنا الصُوَر بحواسنا تتكلّم وتَفعل أفعالاً مختلفة،فإنما ذلك لتعلّق إدراكنا بالصُور،دون نُفوذ إلى بَواطنها وحقائقها التي الصور فيها بمثابة العرض في الجوهر.. فالصُور ظَهرت لظُهور الوجود الحق مُتَلبّساً بها،إذ ظهوره بلا صورة مُتخيّلة مُحال،لأنه لا صورة له. فظهرت به وظهر بها،مع عَدمها. ولا يُقال في الصورة إنها عَيْن ما قامت به،لأنها عَدَم،والمُقَوّم لها وُجود. ولا يكون العدم عَيْن الوجود،ولا أنها غيره،لأن الغَيْريّة عند المتكلمين أمران وجوديان،وليس إلا وجود واحد،لا قديم ولا حادث. وإذا قيل: إنها غَيْر،فهي إعتبارية لا حقيقية. وكذا إن قيل: إنها عَيْن،بمعنى أن الظاهر عين المظهر،فهو مجاز أيضاً،لأنها شُؤونه في مرتبة التعيّن الأول..
النّسَب كلّها أمور إعتبارية،لا موجودة ولا معدومة،فوجودها إنما هو في إعتبار المُعْتَبر ما دام مُعتبراً،وفي عقل المُتعقّل،كسائر الأمور المَصدريّة. فهي مثل الصورة الظاهرة في المرآة والمُتوجّه على المرآة،ما ظهرت الصورة في المرآة،والصورة خيال لا حقيقة لها،وإنما نَسبنا الوجود للصورة مجازاً،لكونها ما ظهرت إلا بتوجّه المُتوَجّه على المرآة،وهو الوجود.
فالعالَم كلّه،بما فيه الصور الحسيّة والخيالية والعقلية،ظِلّ لأعيانه الثابتة من جهة الصورة المُقيّدة،وظِلّ للوجود الحق من جهة الوجود،وتوابع الوجود من الأفعال والإدراكات..
== (الموقف الرابع والستون) ==
قال الله تعالى: (إنا كل شيء خَلقناه بقَدَر) [القمر: 49].
إعلم أنه ليس للحق تعالى ذات،ولمخلوقاته ذَوات مُستقلّة قائمة بأنفسها.. وإنما ذات الحق هي عين ذوات المخلوقات،من غير تعدّد ولا تَجزئة لذاته تعالى. وذوات المخلوقات هي عين ذات الحق،لا على أن للحق ذاتاً وللمخلوقات ذوات،ثمّ إتّحدت ذات الحق بهم أو إمتزجت أو حَلّت فيهم،فإن هذا مُحال وليس بمُراد. بل بمعنى أن ذاته تعالى ــ التي هي وجوده المُقوّم للمخلوقات،القائم عليها ــ هي عين ذوات المخلوقات،أي ذَوات المخلوقات عبارة عن ظهور الوجود الحق مُتَلبّساً بأحكام إستعدادات المخلوقات،أي أعيانها الثابتة في العلم القديم،أزلاً وأبداً،وهي نِسَب الوجود الحق وإعتبارات وإضافات،ولا عين لها في الوجود الحقّ.
ولكن لما كان الشأن أنه لا حُكم إلا لباطن في ظاهر،ولا أثَر إلا لغيب في شَهادة،حَكمت أحكام الإستعدادات الثابتة علماً،المعدومة عَيناً،على الوجود الحقّ،الظاهر بأحكامها،وصارت الأحكام والأوصاف لها فيه مع عدميّتها..
ولا يَقدح فيما ذكرنا،التعبير ب(نَحن،هو)،لأن ضرورة التّفهيم أحْوَجت إلى ذلك..
واحذَر أيها الواقف على هذا،تَرمينا بحلول أو إتّحاد أو زندقة أو إلحاد،فنحن بَريئون من فَهمك الأعوج وعَقلك الأهْوَج.
== (الموقف الخامس والستون) ==
قال الله تعالى: (لها ما كَسبت وعليها ما إكتسبت) [البقرة: 286].
قد طَوّل المتكلمون،من علماء الرسوم،الحديث في الثواب والعقاب،من حيث أن فعل العبد بقضاء الله وقدره وإرادته وسَبْق علمه،فما للعبد حيلة في التحوّل عن مُراد الله تعالى،فيكون العقاب ظُلماً على وَهمهم،حتى أدّى النظر في هذا إلى الإختلاف والتشعّب بين المسلمين..
ولو كَشف الله الغطاء عن بَصائرهم،لعَلموا: أن الثّواب فَضله ورحمته،لأن الرحمة بها الإيجاد والإمداد والثّواب. وأما العقاب والجزاء على سَيّء أفعالنا،فإنما جاء من قِبَلنا،فإننا لما كنا عند أنفسنا موجودين،بعد أن كنا معدومين،تَخيّلنا أن لنا وجوداً حادثاً مُستقلاً مُبايناً للوجود الحق،وتوهّمنا أن لنا صفات مُباينة لصفات الوجود الحق،من قدرة وإرادة وعلم وإختيار.. فعامَلنا الحق تعالى حَسب تخيّلنا،وخاطَبنا بذلك في كلامه وبألسنة رُسله،فقال: إفعلوا واترُكوا،وهو يعلم: أنه لا فعل لنا ولا تَرك،وأنه الفاعل تعالى وحده،ورتّب تعالى الثّواب والعقاب على وَهْمنا هذا،والثّواب مِنّة منه تعالى وفَضل.
فما جاءنا الشرّ إلا من قِبَلنا،ولا حَملنا ما حَملنا إلا بجَهلنا،قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال)،يعني تعالى: أنه عرضها عليهن عَرضاً لا إلزاماً،فأبَيْن وخِفْن من حَملها،لأنها عارفة بالله تعالى فطرة وما طرأ عليها حجاب. وعَرفت أن حمل الأمانة يَستلزم الحجاب الذي هو سَبب المُخالفة،ودعوى الإستقلال بالوجود والفعل والإختيار. وإن كان حمل الأمانة،على الكمال والتّمام،يَقضي بحاملها إلى شَرف ما يبلُغه سواه من المخلوقات،فإختارت هي السّلامة..
== (الموقف السادس والستون) ==
قال الله تعالى: (وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده) [الإسسراء: 44].
(شيء) أنكر النّكرات،وكل مُسبّح فهو عالِم ناطق،بنُطقه مُدرك. وعلى هذا،فكل ما يُطلق عليه إسم موجود،في أي مرتبة من مراتب الوجود كان،فإنه يوصف بجميع الأوصاف،من حياة وعلم وقُدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام،وغير ذلك. لأن هذه الأوصاف والأحوال،تابعة للوجود. فحيثما كان الوجود،كانت هذه الأوصاف لازمَة له،لأنه ما صحّ لشيء من الأشياء الإتّصاف بالوجود إلا بعد إقتران الوجود العام المُفاض على الممكنات بأحوال ذلك الشيء وإنصباغها بالوجود. فوجود كل شيء هو تعيّن الحق تعالى،الذي هو الوجود،وظهوره بأحوال ذلك الشيء وصفاته..
== (الموقف السابع والستون) ==
قال الله تعالى: (ألا إن أولياء الله) [يونس: 62].
جمهور المحقّقين من أهل الله على أن الوَلاية مُكتسبة،والإكتساب إفتعال،وهو طلب الشيء بقوّة وإجتهاد. وعليه فالعمل لأجل تحصيل الولاية،التي معناها القُرب من الله برفع الحُجُب وإخلاص العبودية إليه وصدق التوكّل عليه والإنحياش،ظاهراً وباطناً إليه،ليس بعِلّة قادحة في العبادة.. وأما إذا قَصَد بالعمل الولاية التي معناها ظهور الخوارق والكرامات وإنتشار الصّيت وإقبال الخَلق،فهذا لا يشُكّ أحد أنه عِلّة،بل شرك. وعليه يُحمَل قول من قال: [لا يَصل أحد إلى الله ما دامَ يَشتهي الوصول إليه].
وعندي،على ما ألقاه الحق إلَيّ: أن بداية الولاية،بمعنى التّوفيق لطَلبها،مَوهبة،لأنها حال،والأحوال مَواهب. ووَسطها إكتساب،لأنه جدّ وإجتهاد،وإرتكاب أهوال،ورياضات ومجاهدات. وآخرها،ولا آخر،مَواهب.
والقُرب من الحق تعالى قُرب معنوي،وليس ذلك إلا برفع حجاب الجهل،وإلا فالحق أقرب إلينا من حبل الوريد،فما بَعّدنا إلا الجهل،ولا قَرّبنا إلا العلم..
== (الموقف الثاني والسبعون) ==
قال الله تعالى: (ألا إنه بكل شيء مُحيط) [فُصّلت: 54]. وقال: (وهو بكلّ شيء عليم) [البقرة: 29].
إعلم أن الإحاطة تقتضي تَحديد المُحاط به من جميع وجوهه وجهاته،والعلم هو إدراك المَعلوم على ما هو عليه.
فلذا نقول: الحق تعالى يَعلم ذاته ولا يُحيط بها،لأن ذاته تعالى غير متناهية. فلو قلنا: إنه يُحيط بها،لإنقلب العلم جَهلاً،تعالى الحق عن ذلك. لأنه حينئذ تَعلّق بها،على خلاف ما هي عليه من عدم التّناهي.
ولا نَقص في قولنا: (يَعلم ذاته ولا يُحيط بها)،بل هو الكمال. فالجهل على الحق مُحال،لأن الجهل إدراك الشيء على غير ما هي عليه حقيقة ذلك الشيء. وإحاطته بالذات العَليّة مُحال،لأن الإحاطة تَستلزم التّناهي،والتناهي على الحق مُحال..
والمُراد بعدَم التناهي في حق الذّات،الوجود الحقّ،عدم تَناهي ظهوره بالمَظاهر،وتَعيّنه بالأسماء والصور،التي هي آثار الأسماء أو هي الأسماء عَيْنُها. والظهور والتعيّن،مُمكن من حيث هو. والممكنات،التي هي مُتعلّقات العلم والقدرة،لا نهاية لها،بإجماع المتكلمين والحكماء وأهل الله. فلو تناهى ظهور الذات بظهور الأسماء والصفات،بظهور آثارها في الممكنات،لتَناهَت الممكنات،المعلومات المقدورات،وهو مُحال.
ولذا يُقال: ذات الحق قابل للوجوب والإمكان. فالوجوب ثابت للذات،الوجود الحقّ،من حيث هو. والإمكان،من حيث الظهور والتعيّن بالممكنات.
وما ذكرناه من عدم إحاطة العلم بالذّات،الوجود الحق،المُراد به: العلم الذي هو شأن من شؤون الذات،ونِسبة من نِسبها. وصورته ومَظهره العقل الأول،وهو الذي يُعبّر عنه القوم بظاهر العلم،وهو المُكنّى عنه ب(قاب قَوسين)،وهو غاية معراج الرّسُل،غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،فإن غاية معراجه (أو أدنى).. لأن تعلّق هذا العلم،بما تعلّق به،هو عين وجود المعلوم في الخارج،فلا يتعلّق بما لا يتناهى،لن كل موجود في الخارج مُتناهٍ.
وأما العلم الذّاتي الذي هو عين الذات من كل وجه،فهو مُحيط بالذات،لأنه عَيْنُها،مع عدم تَناهيها. بل لا يُقال في الشيء: إنه مُحيط بنفسه،ولا غير مُحيط..
وهذه المسألة كثُر الخوض فيها،وحارَت فيها أهل العقول وأهل الكشف. وبما ذكرنا يحصُل الجمع بين قول إمام الحرمين: بالإسترسال الذي أنكره عليه أهل زمانه كافة. وبين قول الفخر الرازي بحُدوث التعلّقات،لو كان المتكلمون بقولون بالعلم الذي هو عين الذات،من كل وجه،وهو غيب،وبالعلم الذي هو ظاهر هذا الغيب،وهو عين الموجودات الخارجية،وبه تَعيّنت وفيه ومنه.
__ الحق تعالى يَعلم ذاته ولا يُحيط بها: أعني بالذات الغيب المطلق،وأعني بالعلم العلم الظاهر. فإنه أتى بالإسم (الله) الذي هو إسم لمرتبة الألوهية،أعني (الله) المُشتقّ لا المُرتَجل. ولا نقص في هذا،بل عين الكمال والتنزيه.. فحقيقة الشيء هو ما يصحّ أن يُعلَم ويُخبَر عنه،والحق تعالى،من حيث الذات والكُنْه والإطلاق،لا يصحّ أن يُعلم ولا أن يُخبَر عنه.. ولو عُلِمَ المطلق لإنقلبت حقيقته،وقَلب الحقائق مُحال. فالمطلق إذا عُلم،ليس ذلك العلم علماً بحقيقته،وإنما هو علم بوُجوهه وإعتباراته،لا غير.
وأما مرتبة التّقييد،التي تُعلَم ولا تُشهَد،خلاف الذات،فهي مرتبة الألوهية،فإنه يعلم ذاته المُقيّدة بصفات الألوهية ويُحيط بها علماً. بمعنى أنه يَعلم وجود ذاته المطلقة وإعتباراتها،لا حقيقتها. وهو،في هذه المرتبة،داخل في الأشياء التي أحاطَ بها علمُه،وهي المُسماة بظاهر الوجود وبالأسامي الكثيرة. وكل ما دخل الوجود فهو مُتناهٍ،وتصحّ الإحاطة به. وفي هذه المرتبة دَخل في الأشياء،وإليه الإشارة بقوله تعالى: (قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله)..
فمن عَرف هذا الموقف حقّ المعرفة [الموقف التسعون: (وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً)] زالَت عنه إشكالات كثيرة في عدّة مسائل،أكثر الناس الخوض فيها. وكذا موقف (ألا إنه بكل شيء مُحيط) [الموقف الثاني والسبعون] السابق.
فالعلم حقيقة واحدة لا تتجزّأ ولا تتعدّد،وكل معلوم له حقيقة واحدة. فما يُعلَم من كل مَعلوم إلا الوجوه والإعتبارات. فتعدّد العلم ونِسبة الكثرة إليه،إنما هو بحسبها،لا غير. فإذا تعلّق علم زيد،مثلاً،بعشرين وَجهاً لحقيقة من الحقائق،وتعلّق علم عمرو بعشرة،يُقال: علم زيد أكثر من علم عمرو. والحدود الموضوعة للأشياء،إنما هي وجوه لها وإعتبارات ولَوازم،فلا تُعْلَم الحقائق بالحُدود،فافهم ترشُد. والسلام.
== (الموقف الثالث والسبعون) ==
قال صلى الله عليه وسلم: (رَجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر). وفي رواية: (رَجعتُم)،خطاباً للصحابة. وفي رواية: (رَجعنا من الجهاد الأصغر إلى الغزوة الكُبرى).
(الجهاد الأصغر): جهاد الكُفّار بالأبيض والأسمر.. و(الجهاد الأكبر): جهاد النفس بالتزكيّة والتخليّة والتحليّة.
وإنما سَمّى صلى الله عليه وسلم جهاد الكفار بالأصغر،مع أن فيه إهلاك النفس وتَفويت الحياة الحاضرة رأساً.. وسَمّى جهاد النفس بالأكبر،مع أن الغالب فيه عدم تفويت الحياة الحاضرة بالموت،وإنما فيه تفويت راحة وشَهوات،وتهذيب أخلاق،وتبديل أحوال ذميمة بأخلاق جميلة.
_ فإما أن يكون ذلك،لكون جهاد العدو الكافر،لا يكون خالصاً مُخلصاً من الشّوائب المُفسدة والحُظوظ المُبعدة،إلا بجهاد النفس وتهذيبها وتزكيّتها. وإلا فلا يخلُص جهاد مُجاهد،بل ولا عمل من الأعمال الصالحة،ما دامت النفس حَيّة مُتلطّخة بالخبائث. فجهاد النفس أكبر لكونه شَرطاً في صحّة جهاد العدو الأكبر. والشّرط مُقدّم،فهو أكبر من المَشروط،لأن قبوله وصحّته بوجوده مَربوط.
_ وإما أن يكون صلى الله عليه وسلم سَمّى جهاد العدو الكافر أصغر،باعتبار مُقتَحميه الخائضين فيه. فإنه ليس كل من قاتَل،مُجاهداً حقيقة. لأن مُصابَرة العدو تكون من البَرّ والفاجر،بل ومن المنافق والكافر.. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (من قاتَل لتكون كلمة الله هي العُليا،فهو في سبيل الله).. فما كل مُقاتل للعدُوّ الكافر سَعيد،ولا كلّ مَقتول فيه شَهيد.. وأما جهاد النفس الذي سَمّاه صلى الله عليه وسلم أكبر،فهو جهاد مخصوص،بقوم مخصوصين،إهتدَوا بأنوار الهداية،وسَبقت لهم من الحق العناية. فلا يخوض غمرات هذا الجهاد إلا مُوَفّق سعيد،يَمشي على الأرض حَيّاً وهو شهيد..
_ وإما أنه صلى الله عليه وسلم سَمّى جهاد الكفار أصغر،لكون جهاد الكفار وقَتلهم،ليس مَقصوداً للشارع بالذّات. إذ ليس المقصود من الجهاد إهلاك مخلوقات الله وإعدامهم،وهَدْم بُنيان الرب تعالى وتَخريب بلاده،فإنه ضدّ الحكمة الإلهية.. وإنما مقصود الشارع،دَفع شَرّ الكفار وقَطع أذاهُم عن المسلمين. لأن شَوكة الكفار إذا قَويت أضَرّت بالمسلمين في دينهم ودُنياهم،كما قال تعالى: (ولولا دَفْع الله الناس بعضهم ببعض لهُدّمت صَوامع / ولولا دَفع الله الناس بعضهم ببعض لفَسدت الأرض)..
== (الموقف الرابع والسبعون) ==
قُلت للحقّ تعالى: لِي القِدَم بالعلم،ولَكَ الحُدوث بالظّهور والحِسّ. فأنت القديم وأنا القديم،وأنت الحادث القديم وأنا الحادث القديم. فما الذي تَميّزت به مِنّي وإنفَصلت به عَنّي؟.
فقال لي: قِدَمُك بي،وحُدوثي بكَ. فالقِدَم ووُجود الوجود،لي بالذات،ولَك بالغير. والحدوث وجَواز الوجوب،لكَ بالذات،ولي بالغير. فلذا تميّزت مَرتبتي بالربوبيّة،ومرتبتك بالعبودية. والمراتب حافظة المنازل،فلا يلتبس عالٍ بسافل.
== (الموقف الخامس والسبعون) ==
قال الله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) [الرحمن: 19_20].
البحران: الشريعة والحقيقة. والبرزخ بينهما: العارف. فلا تَبغي الشريعة على الحقيقة،ولا الحقيقة على الشريعة. فهو دائماً بين ضدّين ومُشاهدة نَقيضين. يَنفي ويُثبت،ويَنفي عين ما أثْبَت،لا يستقرّ به قرار ولا تطمئنّ به دار،مُتحرّك ساكن،راحل قاطن. فهو كطائر يَطير من غُصن إلى غُصن،والذي طار إليه هو الذي طار عنه..
فلذا العارف بين نارَين: نار الشريعة ونار الحقيقة،بل بين شقّتَي طاحون،كل واحدة تَدفعه إلى الأخرى. فالشريعة تُطالبه بالحقيقة وبالشريعة،والحقيقة تُطالبه بالشريعة وبالحقيقة. وهذا هو الإبتلاء الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: (أشدّ الناس بَلاء الأنبياء،ثمّ الأمْثَل فالأمْثَل).
== (الموقف السابع والسبعون) ==
قال الله تعالى،حكاية عن يعقوب: (يبنيّ لا تدخلوا من باب واحد) [يوسف: 67].
هكذا فليكن تَعليم المُعلّمين وتأديب المُؤدّبين: أمرهم،أولاً،بإستعمال الأسباب،لمَيْل الطبيعة إليها وإيناس النفوس بها. ثُمّ أمرهم بالتوكل حالة مُلابسة السّبب،وهذا هو الكمال..
والناس في هذا الأمر ثلاثة:
مُتَسبّب صَرْف: نَظره مقصور على السّبب،وقوّته وضُعفه،فهو أعمى.
ومُتوكّل صَرْف: مُعرض عن الأسباب،ظاهراً وباطناً،وهو صاحب حال،لا يُقتدى به ولا يُحْتَجّ عليه.
ومُتَسبّب بظاهره،مُتوكّل بباطنه: يَده في السّبب،وقلبه مُتعلّق بخالق السّبب. ظاهر لظاهر،وباطن لباطن. وهذا هو الكامل،الناظر بعَينين..
واعلم أن الأسباب كلها حُجُب وأستار دون وجه الحق،وهو الفاعل من خَلف أستارها،ما يظُنّ العُميان أنه أثَر للأسباب وناشئ عنها. سواء في ذلك الأسباب العادية أو العقلية،أو الشرعية،من الأوامر والنّواهي..
ومن العجب أن المُواظبة على الأسباب الشرعية،التي قُلنا إنها حُجُب وأستار دون الحق،على وجه مخصوص وطريقة معروفة عند أهلها،تكون سَبباً لرفع حجابيّتها مع بَقاء عَيْنها. فالذي يُرفع حُكمها،لا عَينُها،فإن عينها مأمور بإثباتها.
ومن هنا ترى العارفين،أهل الوجود والشّهود،يتلبّسون بالأسباب العادية والشرعية كلها،لا فرق بينهم وبين عوام المؤمنين في ظاهر الأمر.. ولكن في الباطن،بينهم ما بين السماء والأرض..وهذا هو السور الذي ضُرب بين عوام المؤمنين والعارفين بالله: (باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبَله العذاب).
فالعارفون تَتلبّس ظواهرهم بالأوامر والأفعال الشرعيّة،ويعلمون أنهم ظُروف لإجرائها،لا فاعلون لها. فلذا لا يرجون،بما يُنسَب إليهم من الأفعال،حُصول خير ولا دفع شَرّ.. وَقفوا على حقيقة الإسمين (الظاهر والباطن)،فعرفوا أنه لا ظاهر إلا هو ولا باطن إلا هو..
وأما عامة المؤمنين،وأعني بعامّتهم صُلحاءهم من العُبّاد والزهّاد وعلماء الظاهر،فهم في تَعب وعَناء ومَشقّة وضَنى،لظَنّهم الذي أرداهُم: أن أفعالهم المخلوقة فيهم،تَجلب لهم نَفعاً وتدفع عنهم ضرّاً. وإذا فاتَهم سَبب حَزنوا لفَوْته،لتحقّقهم بفَوات مُسَبّبه عندهم..
فليس لشيء ممّا يُقال إنه غير الحقّ،وجود أصلاً. وإذا إنتفى الوجود،إنتفى كل شيء من الصفات والأحوال والأفعال،فإنها توابع الوجود،لازمة له.
== (الموقف التاسع والسبعون) ==
ورد في الخبر: (من سَرّته حَسنته وساءَته سيّئته،فهو مؤمن).
هذه صيغة حَصْر،حَصر صلى الله عليه وسلم الإيمان في الموصوف بها. لأن غيره: إما جاحد مُكَذّب،وإما عارف مُشاهد مُكاشف،صارَ الغيب عنده شَهادة،فلا يُطلق عليه إسم المؤمن إلا بالمجاز.
فهذا تعريف للمؤمن،فمن كان بهذه المثابة فهو مؤمن،أي مُصدّق بالغيب من إخبار الشارع بنسبة الأفعال إلى من صَدرت عنه من العباد،بادئ الرأي،وإثابتهم وعقوبتهم عليها.
وأما غير المؤمن،وهو يشمل الجاحد والعارف المُكاشف. فالعارف هو الذي كَشف الله عن حقيقة الأمر،فعرف نفسه فعرف ربّه. فإنه لا تَسُرّه حَسنته ولا تسوؤه معصيته.. فإنه عارف بأنه ليس له من الأمر شيء،فهو وإن شارك المؤمن في تصديق الشارع فيما أخبر به من المغيّبات،فقد زاد على مطلق المؤمن،وصار ما كان غيباً شهادة له. فالعارف لا يرى له حسنة ولا سيّئة،إلا بالنسبة الشرعية،التي هي لحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى أو من أطلعه الله من خواص عباده. فالشريعة جامعة للُبّ والقِشر،والحقيقة لُبّ فقط.
== (الموقف الثمانون) ==
ورد في الصحيح: (لا هجرة بعد الفتح،ولكن جهاد ونيّة).
يُريد صلى الله عليه وسلم،بطريق الإشارة،أنه لا يصحّ ولا يستقيم لمن فتح الله عين بصيرته،وأراه سَريان الأحدية بلا سَريان،وقيام القيّوميّة على كل ذرّة من ذرّات الوجود،ورؤية الوجود الحق تعالى في كل شيء،من غير حلول ولا إتحاد ــ أن يهجُر شيئاً من المخلوقات،بأن يحتقره ويَزدريه ويجعله كالشيء اللّقْي. فإن هذا لا يَصحّ من عارف مُشاهد،كان ما كان ذلك المخلوق،حيواناً أو غيره،وعلى أيّ دين كان،وعلى أيّ ملّة ونِحلة حَصَل،فإنها كلها شَعائر الله،ومن يُعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب،أي من يُعظّم مخلوقات الله،التي هي من شعائره،فإن ذلك التعظيم من تَقوى أهل القلوب،وهم أهل الشّهود..
ولكن مع هذا الشّهود وعدم الهجرة لشيء،والإحتقار له والإعراض عنه،لا بدّ من الجهاد والنيّة،أي المُجاهدة والقَصد. أي الجمع بين شُهود الحقيقة وإجراء أحكام الشريعة،من قتال مُخالفي دين الإسلام،وتعيير المُنكر شَرعاً،وتَحسين ما حَسّنه الشرع وتقبيح ما قبّحه،حكمة وعدلاً..
== (الموقف الواحد والثمانون) ==
ورد في الحديث الصحيح: (ينزل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا،حين يبقى ثُلث الليل الأخير) الحديث.
نُزوله تعالى كناية عن تَجلّيه وظهوره،فإن التجليات كلها تنزّلاته تعالى من سماء الأحدية الصّرفة إلى أرض الكثرة.
وسماء الدنيا كناية عن مظهر الصورة الرحمانية التي يظهر بها الكامل،وهو فرد واحد في كل زمان ولا يتعدّد..
وهذا التجلّي،في هذا الوقت المخصوص،هو للعُبّاد والزهّاد والمُتوجّهين بالأعمال. ولهذا كنّى عنه بسماء الدنيا،لأنها قبلة الدّاعين. وأما العارفون فتَجلّيه لهم دائم،لا يختصّ بزمان ولا مكان،إذ الحق تعالى مُتجَلّ من الأزل إلى الأبد.. والإختلاف والتعدّد والحُدوث المَنسوب إلى التجلّي،إنما هو للمُتجَلّى له،بحسب القوالب والإستعدادات..
وإنما خَصّ هذا التجلّي بالثّلث الآخر،لأنه وقت قيّام المُجتهدين،وزمان توجّه المُستغفرين والتائبين والدّاعين.
== (الموقف الثاني والثمانون) ==
ورد في الخبر: (مَن لم يشكُر الناس،لَم يشكُر الله).
يُريد صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يشكُر الناس،حيث رآهم غيراً وسِوىً،وإعتقد وَهْماً وتَخيّلاً،أن الحق تعالى مُباين لهم ومُنفصل عنهم،وأنه في السماء أو فوق العرش فقط ــ لم يشكر الله،حيث إنه ما عَرفه. وكيف يشكُره مَن لم يَعرفه؟. لأنه تعالى ما عَرفه من عرفه،إلا في مراتب التّقييد والظّهور والتعيّن،والناس وجميع المخلوقات والأسباب والوَسائط،مَظاهره وتَعيّناته ونِسَبه وإعتباراته،فإنها آثار أسمائه وصفاته،بل هي عين أسمائه..
فمن عَرف الله والناس هذه المعرفة،كان شُكره للناس شُكراً لله،إذ لا إثنينيّة في الوجود. ومن هناك،كان الفعل الصادر من الناس وجميع المخلوقات،بَداهة وضرورة،وهو فعل الله تعالى شَرعاً وعقلاً.
فأين الله وأين الناس لمَن يَعقل؟ أفْدي من يعقل عَنّي بنفسي،وأجعله فوق رأسي.
كل شيء له وجهان: وجه إلى الحق،وهو حقّ من هذا الوجه،وهو وجه الربّ الذي لا يفنى،وهو المراد بقوله: (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك). ووجه إلى سَبَبه الذي ظهر عنه،وهو الفاني العدم الباطل،وقد نفى تعالى التأثير عنه في هذا الوجه بقوله: (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون).
فإذا رأيت العارف يشكُر مَخلوقاً ويُثني عليه ويُعظّمه ويَلحظُه،فمن هذه الحَيثيّة. فلا تظُنّ أنه يرى الناس،وسائر المخلوقات،كما تراهُم أنت،وأن بينهم وبين الحق بوناً،مَعاذ الله. ومن هنا صحّ ما أخبر به تعالى في قوله: (فأينما تولّوا فثَمّ وجه الله)..
== (الموقف الثالث والثمانون) ==
قال الله تعالى: (وأما بنعمة ربك فحدّث) [الضحى: 11].
هذه الآية الكريمة ألْقِيَت عَليّ بالإلقاء الغيبي مراراً عديدة لا أحصيها.. ومما ألقيَ عليّ فيها: أن من المُراد بالنّعمة هنا،نعمة العلم والمعرفة بالله تعالى،والعلم بما جاء به الرّسل من المُعاملات والأمور المُغيّبات. ولا شكّ أن هذه النعمة،أعظم النّعم،وإطلاق النعمة على غيرها مَجاز بالنسبة إليها.
والمُراد بالتحدّث بها: إنشاؤها وبَثّها لمُستحقّيها،المُستعدّين لقبولها..
ومن بعض نِعَم الله عليّ: أنني منذ رحمني الله تعالى بمعرفة نفسي،ما كان الخطاب لي والإلقاء عليّ،إلا بالقرآن الكريم العظيم..
والمُناجاة بالقرآن من بَشائر (الوراثة المحمدية). فإن القوم،أرباب هذا الشأن،قالوا: كُلّ من نوجِيَ بلغة نبيّ فهو وارث ذلك النبيّ،صاحب تلك اللغة. ومن نوجيَ بالقرآن كان وارثاً لجميع الأنبياء،وهو المحمّدي،لأن القرآن مُتضمّن لجميع اللغات،كما أن مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مُتضمّن لجميع المقامات.
ومنها: أنّي لما بلغت المدينة طيبة،وقفت تُجاه الوجه الشريف،وقلت: (يا رسول الله عبدُك ببابك،يا رسول الله كَليمك بأعتابك،يا رسول الله نَظرة منك تَغنيني،يا رسول الله عَطفة منك تكفيني)،فسمته صلى الله عليه وسلم يقول لي: (أنت وَلدي ومقبول عندي)..
[ذكر الأمير عدّة نعم ومُبشّرات وقعت له..].
== (الموقف السادس والثمانون) ==
قال الله تعالى: (والشمس وضحاها والقمر وما تلاها والنهار وما جلاها والليل وما يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها) [الشمس: 1_7].
هذه الأشياء المُقسَم بها: هي كناية عن بعض مراتب تَجلّيه،وتَعيّن تَنزّله وتَدَلّيه،وهي مراتب كُليّة.. فكل المراتب والتعيّنات والتنزّلات،لا وجود لها خارج العقل،كسائر الأمور المصدرية،فهي لا موجودة ولا معدومة،فهي خيال لا حقيقة لها غير الوجود الحقّ الذي به ظَهرت.. فالوجود ليس إلا للذّات العَليّة،وكل ما قيل فيه مرتبة وتعيّن وسِوى وغَيْر،فهو إعتبار ونِسبة وإضافة،لا غير..
(والشمس وضُحاها): هو قَسَم بمرتبة الأحدية،وهو أوّل المَجالي. فهو مَجلى ذاتي،ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من المُكوّنات فيه ظهور. فهو ذات صَرْف،مُجرّد عن الإعتبارات الحَقيّة والخَلقيّة،وإن كان الجميع موجوداً فيها،ولكن بحُكم البُطون.
فنسبة الواحد إلى ذاته،نسبة واحدة،هي عين أحديّته،لا واحديّته. ونسبته إلى الثاني هي واحديّته.
فالأحدية هي تجلّيه تعالى لذاته بذاته،إذ لا غير في هذه المرتبة.. فما للخَلق،من مَلَك ورسول ووَليّ،في هذه المرتبة،إلا الإيمان بالغيب.. إذ الوجود المجرّد عن الظهور بالغير والتعيّن به،لا يُعرَف ولا يُنعَت ولا يوصَف،لأنه الذات الغنيّة عن العالمين. وهذه المرتبة في الحق والحقيقة هي (حقيقة الحقائق).. وقد وصل بعض الرهبان والبراهمة وغيرهم،من أهل الرياضات والمجاهدات على غير سُبُل الرّسل،إلى العقل الأول،فظنّوا أنه هو حقيقة الحقائق،وأنه لا شيء وراءه،فخسروا وباؤوا ورجعوا من حيث جاءوا.
(والقمر إذا تلاها): هو كناية عن المرتبة الثانية والتعيّن الأولي المُسمّى ب [الروح الكُلّي،نفس الرحمن،الوجود الإضافي،الحقيقة المحمدية،برزخ البرازخ] وله أسامٍ كثيرة،ويُعبّر عنه بالوحدة المطلقة. وذلك أن الوجود إذا أخذ بشرط لا شيء،فهو الأحدية. وإذا أخذ بشرط كل شيء،فهو الواحديّة. وإذا أخذ مطلقاً،لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء،فهو الوحدة. فالوحدة مَنشأ الأحدية والواحدية،لأنها عين الذات من حيث هي. والوحدة إذا أعتبرت من حيث هي هي،لا تُغاير الأحدية،بل هي عينها. والوحدة هنا لا تتعقّل في مُقابل كثرة،ولا يتوقّف تحقّقها على تصوّر ضدّ لها.
وهذا الوجود الإضافي المُشترك بين جميع الموجودات،المُتَعيّن بها،هو عين الوجود الباطن المُجرّد عن التعيّن والظهور،ولا يُغايره إلا بالإعتبار.. والحق تعالى في هذه المرتبة مَرئي للرّائين،معروف للعارفين،لأنها مرتبة إسمه تعالى (الظاهر).. وهذه المرتبة أول ظهور الله تعالى من كَنز الخَفاء،ومعرفة القوم وغاية وصولهم إليها،وبها يتغزّلون في أشعارهم،وعنها يُكَنّون بليلى وسُعدى والبرق والنّسيم والخمر والكأس.. وهي الظاهرة في سائر الخلق،وهي (أمر الله) كما قال: (ذلك أمر الله أنزله إليكم)،وقال: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي) أي: الروح أمر ربّي،ف(من) بَيانيّة،وهو الذي صَدر عن الله بلا واسطة. وهو نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،فما صَدر إلا بمُشافهة الأمر العزيز،وهذا الأخير هو السّبب الثاني،بالإضافة إلى الوجود المطلق (الله) حيث لا تعيّن.. فالنور المحمدي هو التعيّن الثاني باعتبار قيامه بالأمر،والتعيّن الثالث باعتبار نُزوله في عالَم الخلق. فهو ثلاث مراتب،وهو واحد.
ووجه الكناية عن هذه المرتبة والتعيّن بالقمر،هو أن القمر واسطة بين الشمس والأرض. فهو يستمدّ من الشمس،ويُمدّ الأرض به. وكذا هذا التعيّن الأول فإنه يستمدّ من الوجود الباطن الأحديّ الذاتي،ويُمدّ العالَم أعلاه وأسفله،بما يُفيضه الحق تعالى عليه. فله وجهة إلى الحق،ووجهة إلى الخلق. ولهذا سُمي ب(برزخ البرازخ)،لأن البرزخ جامع بين الطرفين،لا يكون غيرهما ولا عَينهما..
(والنهار إذا جلاها): هو كناية عن المرتبة الواحدية،وهو التعيّن الثاني. وهي إعتبار الذات من حيث إنتشار الأسماء والصفات منها.. فهي مَجلى ظهرت الذات فيه صفة،والصفة ذاتاً. فظهر كل من الأسماء والأوصاف عين الآخر.. وإلى ذلك أشرت في بعض القصائد التوحيدية: (فقُل عالَم،وقُل إله،وقل أنا،وقل أنت وهو،لست تخشى به رَدّاً)..
ووجه الكناية عن هذه المرتبة بالنهار،هو أن النهار تظهر فيه وبه الأشياء،ويتميّز بعضها عن بعض. وكذلك هذه المرتبة،فإن إليها تستند الآثار كلها. فهي المُجَليّة للمرتبة التي قبلها،كما أن النهار مُجَلّ ومُظهر للشمس. وأيضاً هذه المرتبة هي عبارة عن علم الله بذاته،وبجميع أسمائه وصفاته،وبجميع حقائق مُكوناته،على التفصيل. وقد كان علمها في المرتبة التي قبلها،وهي الوحدة المطلقة،إجمالاً. ولا يتوهّم مُتوهّم أن قولنا: (إجمالاً) أن العلم الإجمالي موجب للجهل،كما عليه جمهور المتكلمين..
(والليل إذا يغشاها): هو كناية عن الطبيعة الكثيفة،والتعيّن بالأجسام العنصوية المظلمة،الظاهرة في المعدن والنبات والحيوان والجان والإنسان. لأن العالَم الجسماني الطبيعي،محلّ الظهور الإلهي الكمالي.. فظهور الحق تعالى بالأجسام أكْمَل من ظهوره بالأرواح.. إذ عالَم الشهادة أكمل من عالم الغيب،وعالم الغيب أشرف من عالم الشهادة. فالشّرف بقِلّة الوسائط،والتّمام بكَثرتها.
ووجه الكناية عن هذه المرتبة بالتجلّي بالليل،هو أن الليل أصل النهار،قال تعالى: (وآية لهم الليل نَسلخ منه النهار). وكذا الأجسام الطبيعية،لكثافتها وحِجابيتها،سبب وأصل لظهور الأرواح الجُزئية وتعيّنها من الروح الكُلّ،كما قال تعالى: (فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي)..
(والسماء وما بناها): هو كناية عن مرتبة التعيّن بالأرواح،لأن الأرواح سماء الأشباح،ولها العُلُوّ..
ووجه الكناية عن هذا التعيّن بالسماء،هو أن السماء لها العلوّ والشّرف الحسّي والمعنوي،وأنها منبع الأنوار،ولها الفاعلية بما فيها من الكواكب والأملاك،وكذلك الأرواح مع الأجسام. وكما أن السماء بما فيها،تُدبّر الأرض وما فيها،من معدن ونبات وحيوان،من غير إتّصال ولا إمتزاج ولا إنتقال. كذلك الأرواح تُدبّر الأجسام المتعلّقة بها،من غير حلول ولا إتّصال ولا إمتزاج. وأمر الروح لا يُدرك إلا بالكشف،ولا يُدرك بالعقل أبداً..
(والأرض وما طحاها): هو كناية عن التعيّن بالنفس الكُليّة،المنبعثة من العقل الأول،كإنبعاث حواء من آدم،وهي المُسماة باللوح المحفوظ. وهي الحاوية لتفصيل ما أجمل في العقل الأول من العلوم.. فالنفس الكلية إذا أقبلت على الجسم،يُسمى إقبالها (نَفساً). والعقل الكُلّي إذا أفاض على الجسم،يُسمى إقباله (عقلاً). فالنفوس من فيض النفس الكلية،والعقول من فيض العقل الكلّي..
ووجه الكناية عن هذه المرتبة والتعيّن بالأرض،هو أن الأرض لها صفة الإنفعال عن الأمور السماوية،وكذلك النفس لها رتبة الإنفعال عن العقل الأول. والأرض محلّ لما يتكوّن فيها،وكذلك النفس محلّ لما يتفصّل فيها من علوم العقل المُجملة فيه..
(ونفس وما سواها): هو كناية عن مرتبة التعيّن بالنفس الجُزئية الإنسانية،وهي مخلوقة من نور واجب الوجود لذاته،ولهذا وُجد فيها من الكمال جميع ما للحق تعالى. ووُصفت بجميع صفاته،ما عدا الوجوب بالذات. وحَوت من النقائص جميع ما كان في الوجود. فجمعت صفات الحق والخلق..والنفس من حيث هي،لا خُبْث فيها،فهي طاهرة قُدسيّة،وإنما هي منفذة للخُبث بالعبد،فتَنزل في كل هيكل على حسب ما يَليق به،وتُدبّره بما هو مكتوب له وعليه من الأزل،إن خيراً فخير وإن شَرّاً فشرّ..
وجُملة الإنسان: (روح وعقل ونفس). فالروح واحد،يتعدّد بتعدّد الأعضاء،فهو واحد كثير،ولا يُدبّر الجسم. والعقل هو نور الروح،وهو يُدبّر الجسم بأمر الروح. والنفس هي نور العقل،وهي بمنزلة الخادم للعقل،فإن كَمُل كمُلت النفس،وبالعكس.. وجملة هذه الثلاث أمر واحد،وهو أمر الله..
وهذه التعيّنات والتغيّرات والتحوّلات في الصُوَر،وفي النّسَب والإضافات والإعتبارات،إنما هو بحسب ما يتجلّى له علينا ويَظهر به لنا. وهو في ذاته على ما هو عليه من قبل تَجلّيه وظهوره.
== (الموقف التاسع والثمانون) ==
قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: 107].
إعلم أنه ليس المراد من إرساله رحمة للعالمين،هو إرساله من حيث ظهور جسمه الشريف الطبيعي فقط،وإن قال به جمهور المفسرين وعامّتهم،فإنه من هذه الحيثيّة غير عام الرحمة لجميع العالمين.. بل المراد إرساله من حيث حقيقته التي هي حقيقة الحقائق،ومن حيث روحه الذي هو روح الأرواح. فإن حقيقته صلى الله عليه وسلم هي الرحمة التي وَسعت كل شيء،وعَمّت هذه الرحمة حتى أسماء الحق تعالى من حيث ظهور آثارها ومقتضياتها بوجود هذه الرحمة. وهذه الرحمة هي أول شيء فَتَق ظُلمة العدم،وأول صادر عن الحق تعالى بلا واسطة،وهي الوجود المُفاض على أعيان المُكوَّنات..
ولهذه الحقيقة المحمدية أسماء كثيرة باعتبار كَثْرة وُجوهها وإعتباراتها،وأذكر طَرفاً منها ليكون نموذجاً لما لم أذكُره. لأن كثيراً من الناس،الذين يُطالعون كتب القوم،حين يرون هذه الأسماء الكثيرة،يظنّون أنها لمُسمّيات متعدّدة،وليس الأمر كذلك.. ومن أسمائها:
[التعيّن الأول للحق تعالى،الذات مع التعيّن الأول،القلم الأعلى،أمر الله،العقل الأول،سدرة المنتهى،الحد الفاصل،مرتبة صورة الحق،الإنسان الكامل بلا تعديد،القلب،أم الكتاب والكتاب المسطور،روح القدس،الروح الأعظم،التجلّي الثاني،حقيقة الحقائق،العَماء،الروح الكُلّي،الإمام المبين،العرش الذي إستوى عليه الرحمن،مرآة الحق ومرآة الحَضرتين ومرآة الكون،المادّة الأولى والمُعلّم الأول،نَفَس الرحمن،الفيض الأول،الدرّة البيضاء،البرزخ الجامع،واسطة الفيض والمَدَد،حضرة الجمع،مجمع البحرين،مركز الدائرة،الوجود السّاري والحياة السارية في كل موجود،نور الأنوار،الظلّ الأول،حضرة الأسماء والصفات،الحق المخلوق به كل شيء..] إلى غير ذلك ممّا يطول ذكره.
فأما وجه تَسميّته ب(مرتبة الحق،والإنسان الكامل بلا تعديد): فلأن صورة الحق هي صورة علمه بذاته،وصورة العلم صورة نِسَب علمه،وصورة نسب علمه عبارة عن تعيّنات وجوده التي هي أحواله من حيث تِعدادها،وعَينُه من حيث توحّدها.
و(الحَدّ الفاصل): فلأنه فاصل بين ما تعيّن من الحق وما لم يتعيّن،وهو مَجلى لما تعيّن منه. ولا بدّ من هذا الحد الفاصل ليبقى الإسم الظاهر وأحكامه على الدّوام. إذ لولاه لطلب التفصيل الرّجوع إلى الغيب والإجمال..
و(سدرة المنتهى): فلأنه هو البرزخيّة الكُبرى،التي ينتهي إليها سَيْر الكُمّل وأعمالهم وعلومهم. وهي نهاية المراتب الأسمائية.
و(أمر الله): فلأنه الكلمة الإلهية الجامعة الشاملة..
و(العقل الأول): فلأنه أول من عَقَل عن الحق تعالى أمره بقوله (كُنْ)،أوجده تعالى لا في مادّة ولا في مُدّة،عالِماً بذاته،علمه ذاته لا صفة له،فهو تفصيل علم الإجمال الإلهي..
و(القلم الأعلى): فمن حيث التّسطير والتّدوين،إذ هو كاتب الحضرة الإلهية..
و(الحق المخلوق به كل شيء): فلأنه ليس هو إلا ظهور الحق وتعيّنه،فهو حقّ. والظهور والتعيّن عدم،فهو خَلق. ولما ظهر الحق تعالى به،جَعله شَرطاً وسَبباً لوجود كل موجود بعده،إلى غير نهاية،وفَوّض الحق إليه أمر المملكة كلّها،فهو يتصرّف فيها بإرادته تعالى.
و(حضرة الأسماء والصفات): فلأنه تعالى لما إقتضى لذاته إيجاد العالَم،إقتضى هذا الإقتضاء المذكور إنقسام الذات العليّة إلى طالب ومطلوب،وحاضر ومَحضور،ولا شيء إلا الذّات وحدها. وكل أمرين مُتقابلين،لا بد أن يكون بينهما أمر ثالث،ليتميّز كل منهما عن الآخر،فظهرت حضرة الأسماء والصفات من بين هاتين الحضرتين القديمتين: حضرة الطالب والمطلوب،والحاضر والمحضور. فوُصف بها الطالب باعتبار إتّصافه بهذه الأوصاف،مع تبايُن الطالب والمطلوب بالنّظر إلى ذات كل منهما،وإن كانا ذاتاً واحدة في الحقيقة. فحقيقة الإقتضاء الذّاتي هو طَلب الذات حُضورها عندها،بطَلب هو عين ذاتها،مثل إقتضائها لأوصافها. وإلا كانت أوصافها حادثة،لأنها مطلوبة لها،وأوصافها قديمة أزليّة.
و(أمّ الكتاب): فلأن الوجود مُندَرج فيها إندراج الحروف في الدّواة،ولا تُسمّى الدّواة بإسم شيء في أسماء الحروف. وكذلك أم الكتاب،لا يُطلق عليها إسم الوجود ولا العدم،فلا يُقال: إنها حق ولا خلق،ولا عين ولا غير. لأنها غير محصورة حتى يُحكَم عليها بحُكم،ولكنها ماهية لا تنحصر بعبارة إلا ولها ضدّ تلك العبارة من كل وجه. وهي مَحلّ الأشياء ومصدر الوجود..
و(الروح الأعظم): فلأنه روح الأرواح،إذ الأرواح الجزئية لكل صورة جسمية أو روحية أو عقلية أو خيالية أو مثالية،إنما هي فائضة منه..
و(التجلّي الثاني): فبالنسبة إلى التجلّي الأحديّ الأول،إذ هذا التجلّي الثاني،به وفيه،ظهرت أعيان الممكنات الثابتة،التي هي شؤون الذات لذاته تعالى وهو التعيّن الأول بصفة العالمية والقابلية. لأن الأعيان الثابتة: معلوماته الأولى الذاتيّة القابلة للتجلّي الشّهودي..
و(العَما): فلأن العَما في اللغة السّحاب الرّقيق (كان ربّنا في عماء،ما فوقه هواء وما تحته هواء). يعني لا صفة حق ولا صفة خلق.. فالعماء مُقابل للأحدية،ولا يصحّ أن يكون العماء هو الأحدية،لأن الأحدية حُكم الذات في الذات بمقتضى التّعالي،وهو البطون الذّاتي الأحدي. والعماء حُكم الذات بمقتضى الإطلاق،فلا يُفهم منه تعالٍ ولا تَدانٍ. فالأحدية صَرافة الذات بحكم التجلّي،والعماء صرافة الذات بحكم الإستتار.. فالعماء هو الإسم الظاهر.
و(النور): فلأنه ورد: (أول ما خلق الله نور نبيّك يا جابر).
والنور نوران: نور الحقّ،وهو الغيب المطلق القديم. ونور العالَم المُحدَث،وهو نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خَلقه الله من نوره،وخَلق كل شيء منه. فهو كل شيء من حيث الماهية،وكل شيء غيره من حيث الصورة. ورد في بعض الأخبار: (أنا من رَبّي،والمؤمنون مِنّي). وإنما خَصّ المؤمنين للتّشريف،وإلا فكل الخلق منه.. ولهذا كان الكُمّل يَشهدونه في كل شيء على الدّوام.. ولا يُفهَم ممّا ذكرناه حُلول ولا تَجزئة ولا جُزئيّة. فإن معنى إيقاد السّراج من نور سراج آخر،أن الأول أثّر في الثاني،فظهر الثاني على صورة الأول،بل الثاني عين الأول،ظهر من فَتيلة ثانية من غير إنتقال عن الأول. وهذا غاية ما قَدر عليه أهل الوجدان في التّفهيم. فافهَم السِرّ واحذر الغلط،وإذا عرفت فاحمد الله،وإلا آمِن به على مُراد أهله وذَوقهم،فإنهم الفرقة الناجية.
و(مركز الدائرة): فالمراد بالدائرة الأكوان كلها،والمركز هو القطب الذي تدور عليه.. فنقطة المركز تُقابل كل نقطة من نُقط الدائرة بكُلّها.. وليست هي نقطة من نقط الدائرة،باعتبار إستدارتها وإتّصالها بما قبلها وبما بعدها.. والمركز إشارة إلى سُكون الأمر،وهو الحقيقة المحمدية،تحت القضاء والقدر،وتنفيذ ما أراد الله بعباده..
و(الوجود السّاري): فلأنه لولا سَريان الوجود الحق في الموجودات،بالصورة التي هي منه،وهي الحقيقة المحمدية،ما كان للعالَم ظهور،ولا صَحّ وجود موجود،لبُعد المناسبة وعدم الإرتباط..
[قام الأمير بشرح باقي تسميّات الحقيقة المحمدية التي ذكرها سابقاً..].
ثمّ قال: ويكفي هذا القدر من ذكر أسماء هذه الحقيقة المحمدية لمن فَهم،فإنها بحر لا ساحل له. ولهذا ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: (لا يعلم حقيقتي غير ربّي)..
== (الموقف الواحد والتسعون) ==
قال الله تعالى: (وما أمرُنا إلا واحدة كلَمح بالبصر) [القمر: 50].
أمر الله تعالى هو كلمته الكُلّية،وهو الصورة الرحمانية التي إستوى بها على العرش. فهي في العرش واحدة،يعني كلمة واحدة،جامعة لجميع الحروف والكلمات،لأنها الساريّة في كل حَرف وكَلمة.
ثمّ لما تنزّلت هذه الكلمة إلى الكُرسي،صارَت كلمتين،بمعنى ذات صفتين مُتقابلتين مُزدوجتين. وهما المَكنِيّ عنهما ب”القَدمين”،أعني الصفتين المُتقابلتين: حَقّ وخَلق،خَبر وحُكم. وظهرت الزّوجيّة،بعد أن كانت الكلمة واحدة في العرش. إذ الكُرسي زَوج للعرش،ومن الكرسي ظهر التعدّد والمُقابلة في كل الأشياء،حتى في الأسماء الإلهية: قابض وباسط،مُعطي ومانع،مُحيي ومُميت..
__ [الموقف 162]: أمر الله تعالى هو أوّل صادر بلا واسطة،فهو قديم. وهو عبارة عن التوجّه والإرادة الكُليّة،وهو كلمته الكلية،وهو الحقيقة المحمدية المُسمّاة بالروح الكلّي.. ولا تعرف المخلوقات من هذا الأمر سوى وجوده،لا غير،فلا يعرف ما هو عليه إلا الله تعالى.. من رآه رأى الحق،ومن عرفه عرف الحق. وهو الحجاب الأعظم الذي لا يرتفع عن وجه الحق،لا دنيا ولا آخرة. وهو الإزار وهو الرّداء..
أخبر تعالى أن أمره الذي هو صورة علمه بالمعلومات،إنما كان بكلمة واحدة (كُنْ)،من غير حرف ولا صوت،وإنما هو كلام نفسي..
فإذا كان أمره تعالى،الذي هو صورة علمه،وهو مُحتَوٍ على جميع المعلومات إجمالاً وتفصيلاً،صَدر عنه كلَمْح بالبصر،فكيف بغيره من المخلوقات الجُزئيّة؟..
== (الموقف الثاني والتسعون) ==
قال الله تعالى: (واذكُر ربّك إذا نَسيت) [الكهف: 24].
الذكر المأمور به ههنا،هو ذكر القلب لا ذكر اللسان،فإنه جَعله ضدّاً للنّسيان. والنّسيان مَحلّه القلب فقط..
وذكر القلب المأمور به،هو إستحضار صورة العلم بالله الذي حَصل له،كُلّما غَفل جَدّد ذكرها في قلبه. ولا تضُرّ غَفلته،فإن العلم له الثّبوت،بخلاف الإيمان فإنه قد يزول. فإذا زال الإيمان،الذي هو سبب السعادة،خَلّف الشقاوة. وأما العلم فإنه لا يزول ولا تُؤثّر فيه الغفلات،فإنه لا يَلزم العالِم الحضور مع علمه في كل نَفس،لأنه والٍ مَشغول بتدبير ما وَلاّه الله عليه،فيغفل عن كونه عالماً بالله تعالى،ولا يُخرجه ذلك عن نَعته بأنه عالم بالله تعالى،مع وجود الضدّ في المحلّ من غفلة أو نوم. فإنه لا جهل بعد علم.
وأعني بالعلم،علم القوم الحاصل من التجليات الربانيّة والإلهامات الروحانيّة. وأما العلم الحاصل عن النظر العقلي بالأدلّة الفكرية،فمثل هذا لا يُسمّى عند القوم علماً،لتَطرّق الشّبَه على صاحبه..
وليست الغَفلات خاصة بالأصاغر،بل تكون حتى للأكابر،فهي عامّة في بني آدم حتى الأنبياء. ولكن العارفين بالله مُتفاوتون في زمان الغفلات،بحسب مقاماتهم. وانظُر قوله صلى الله عليه وسلم: (إنه ليُغان على قلبي) الحديث.
فإنه صلى الله عليه وسلم كان مُكلّفاً بأعباء الرسالة،وخطاب الناس على قدر عقولهم ومَراتبهم،وتبليغ الشرائع إليهم. وهذا وإن كان من أعظم القُربات وأجَلّ العبادات،فليس هو كخُلوته بربّه وإنقطاعه إليه. ولهذا قيل: (الولاية أفضل من الرسالة)،يُريدون: ولاية الرسول أفضل من رسالته،لا الولاية مطلقاً. لأن ولايته،هي وجهه إلى الله تعالى،ولها يقول صلى الله عليه وسلم: (لي وقت مع الله لا يسعني فيه نبيّ مُرسل ولا مَلك مُقرّب). وأما رسالته،فهي وَجهه إلى الخلق،ولها يقول صلى الله عليه وسلم: (إنه ليُغان على قلبي)..
== (الموقف الثالث والتسعون) ==
قال الله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقَدر) [القمر: 49].
إعلم أن الشّيئيّة شَيئيّتان: شَيئيّة ثُبوت،وشيئية وُجود.
شيئيّة الوجود: حادثة،وهي المُرادة المَعنيّة في قوله تعالى: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) أي موجوداً.
وشيئيّة الثّبوت: هي عبارة عن إستعداد الممكن وقبوله للظّهور بالوجود الحق،وظهور الوجود الحق به،فإنه لولا قبوله ما حصل ما حصل. ألا ترى المُحال،لمّا لم يكن له إستعداد ولا قبول للمَظهريّة ولا للظهور،ما كان له وجود؟.. فشيئية الثّبوت قديمة،وهي المُرادة والمُخاطبة بقوله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) كان المأمور ثابتاً معدوماً،فسمع الخطاب فإمتثل الأمر بالكون فكان.. فمُتعلّق الأمر والحُدوث والخَلق والتّكوين،إنما هو الصورة،وهي الهيئة الإجتماعية الحاصلة من إجتماع الأسماء. فمعنى (كُنْ): إقْبَل إتّصافك بوجودي وظُهوري بك،فتكون مَظهراً لي،لا أنك تكون موجوداً. فالأمر والمأمور والآمر،واحد عند التحقيق،والتغايُر بينهما إعتباري،ليس بشيء زائد على الهيئة الإجتماعية للأسماء الإلهية،التي تلك العين الثابتة صورتها العلمية..
فالحق تعالى إذا توجّه توجّهاً خاصاً لعَيْن من الأعيان الثابتة،التي هي صُور الأسماء الإلهية،للإيجاد،بمعنى المَظهريّة للوجود الحق،إنصبغ الوجود الحق بأحوال تلك العين الثابتة وبما لها من الإستعداد للصفات التي تَعرض لها حالاً بعد حال،إلى الأبد. فيظهر الحق مُنصَبغاً بصفاتها،والعين نفسها باقية في العدم والثّبوت،وتَنْصَبغ تلك العين بالوجود الحق: (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة). وعندما حَصَل للعَين الشعور بنَفسها،نَظرت في مرآة الوجود الحقّ،فنَظرت نفسها في النور،فظنّت أن الذي رأته في مرآة الوجود من صورتها شيء آخر،وأنها حصلت على وجود خارجي غير الوجود العلميّ،وليس الأمر كذلك. وإنما الذي رأته وظَنّته وجوداً خارجياً،هو الوجود الحق الظاهر بأحكامها وإستعداداتها. وأما هي،فما شَمّت رائحة الوجود،أزلاً وأبداً (كان الله ولا شيء معه).. إذ حَدّ الأعيان الثابتة،إذا حَدّها من حَدّها،هي حقائق الممكنات في العلم الإلهي. فلو كان لها وجود خارج العلم،لإنقلبت حقيقتها،وقلب الحقائق مُحال. فحقيقة كل شيء هي نِسبة معلوميّته في علم الحق تعالى،من حيث أن علمه عين ذاته.
فافهم الأمر على أصله،وأكْتُمه إلا عن أهله،المُستعدّين لقبوله،المُتهيّئين لتَحصيله،وإن خالفت نَدمت. إذ ما كل ما يُعلَم يُقال،وأنهم يُكذبونك،ولا يُمكنك إقامة دَليل على صدق دَعواك. فإن الأمور الوجدانيّة لا يُمكن حَدّها ولا إقامة دليل عليها،حتى في الأمور العادية في الخلق،كالفرح والغمّ والحوف والخشوع ونحوها،فلا يُمكن تَوصيلها إلى الغير أبداً،ولا سبيل إليها إلا الذّوق. وإذا أخذها المؤمن بحُسن الظنّ بالمُخبِر،يحصُل له فُرقان بينه وبين الجاهل بها،ولكن لا مثل ذَوقها.
== (الموقف الخامس والتسعون) ==
قال الله تعالى: (إن الصّفا والمَرْوة من شعائر الله فمن حَجّ البيت أو إعتمر فلا جُناح عليه أن يَطّور بهما) [البقرة: 158].
هذه الآية الكريمة ألقِيَت عليّ بالحرم المَكّي،أيام المجاهدة،والحال غالب على صاحبه،وكل إناء يَرشُح بما فيه.
(الصّفا): بطريق الإشارة،يعني تَصفيّة النفس حتى يزول شرّها وجماحُها،من الصفات الذّميمة والأخلاق اللئيمة. وهي المُسمّى بالمجاهدة والرياضة: فالمجاهدة بالأفعال الظاهرة،والرياضة بالأمور الباطنة،أي إرتياض النفس وتَركها للصفات البَهيميّة المَرذولة شَرعاً وطَبعاً. وهي التي سَمّاها صاحب إحياء علوم الدين ب(المُهلكات): كالحسد والغضب والرياء والسّمعة والكِبر والبُخل ونحوها. وليس المُراد إعدام هذه الصفات ونحوها بالكُلّية،بحيث لا يبقى لها أثر،فإنه مُحال. إذ حقيقة الإنسان مَعجونة بهذه الصفات،وقلب الحقائق مُحال.. إذ لو إنعدم الحسد،مثلاً،ما كان تنافُس في الفضائل ومَحاسن الخِلال. ولو إنعدم الغضب،ما كان جهاد ولا تغيير مُنكر.. ونحو هذا. وإنما المُراد تَذليل النفس وقَمعها على الإسترسال وقَهرها،حتى تكون تحت حُكم الشرع وإشارة العقل. فإن الخصال المذمومة لها مَصارف عَيّنها الشارع لتُصرف فيها،ومواطن عَيّنها لها،فما تَبقى مُعطّلة. فما هي مذمومة مطلقاً،وإنما هي مذمومة في موطن وحال.. وإليه الإشارة بقوله تعالى: (ومن أضلّ ممّن إتّبع هواه بغير هُدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين). فالهَوى مَيْل النفس إلى ما يُلائمها،وما كل ما يُلائمها مَذموم،بل منه مذموم ومحمود. فالمذموم منه هو الذي يكون بغير هُدى من الله،أي بغير هداية وتَعيين من الشارع. والمحمود هو الذي يكون بهداية الشارع ودَلالته وإشارته،وهي المصارف التي عَيّنها الشارع..
(والمَرْوَة): بينها وبين “المُروءة” مُناسبة في الإشتقاق: إذ المَرْوة الحجارة البيضاء،والمُروءة بَياض العِرْض والإتّصاف بالمَحامد.. والمُراد تَحليّة النفس وتَبييضها بمكارم الأخلاق ومَحاسن الخِلال،وجِماعُها حُسن الخُلُق،قال صلى الله عليه وسلم: (إنما بُعثت لأتَمّم مَكارم الأخلاق). وهي التي سَمّاها صاحب الإحياء ب(المُنْجيات)،وهي أضداد (المُهلكات).
(من شعائر الله): أي من دين الله المعروف عند الأنبياء وأتباعهم..
(فمن حجّ البيت): أي قَصَد معرفة الله تعالى والقُرب منه،لرفع الحُجُب عن عين بَصيرته.
(أو إعتمر): قَصَد الأجور والدّرجات الجَنانيّة،والدخول في زُمرة الصالحين،أهل السجّادة والمحراب،فإنه قال تعالى: (وذلك جزاء من تَزكّى) بعد قوله: (فأولئك لهم الدرجات العُلى).
والقَصْد إلى معرفة الله تعالى بالكَشف والعيّان،فرض عين،كالقصد إلى الحجّ،والقصد إلى الجنّة والدّرجات،كالقصد إلى سنّة العُمرة،فهي دونَه.. وفيه إشارة إلى أن من كان عاجزاً عن طلب الوصول إلى مقامات العارفين بالله تعالى وعلومهم،لعدم إستعداده،فهو معذور في قصد الأجور والدّرجات،كالذي قَدّم العمرة في غير أشهُر الحج،لعجزه عن مَشاقّ الإحرام،مع طول المُدّة.
(فلا جُناح عليه أن يَطّوف بهما): أي يَجب عليه أن يَطّوف ويَسعى بين هذين المَشعرين،اللذين هما أعظم أركان الطريق والسّلوك إلى الله تعالى،بالتّخليّة والتحليّة،فهما أساس الخير للعارف والعابد. وليس المراد،كما هو الظاهر،أنه لا حرج عليه في السّعي بينهما. بل المُراد: أنه يجب عليه هذا الفعل. ولو كان المراد رفع الحرج عن فاعل هذا،لقال: فلا جُناح عليه أن لا يفعل..
== (الموقف السادس والتسعون) ==
قال الله تعالى: (قل إن الهُدى هُدى الله) [آل عمران: 73].
الهُدى والدّلالة إلى معرفة الله تعالى: إما دَلالة حَقّ،وإما دلالة خَلق،لا ثالث لهما.
فأما (هداية الحق): فهي الهداية الموصلة للمطلوب من غير ضَلال ولا إنحراف. وليست هداية الله تعالى إلا فيما جاءت به الرّسل،من التوحيد والأوامر والنّواهي،وقبول ذلك منهم،سواء قَبله العقل أو لم يَقبله. فإذا عَمل المؤمن على ذلك،حينئذ يُعلّمه الله تعالى من عنده علماً ويَهديه إلى معرفة ما كان قبله تقليداً.. وذلك بالتجلّيات الذّوقيّة والإفاضة الربّانية،فيُعرّفه بما أنكرته العقول،ممّا أخبرت به الرسل عن ربّها ووَصفته به. ولا أصْدَق من الحق،ولا أدَلّ منه،على نفسه.
وأما (هداية الخَلق): فهي هداية العقول. وهي إما أن يكون فيها زيغ أو ضلال وحَيرة،وإما أن يكون فيها خروج عن المقصود جملة واحدة. فهي إما مُهلكة وإما ناقصة،إذ غاية معرفة العقل التّنزيه عن صفات المُحدَثات،بأنه ليس كذا وليس كذا. وما هي هذه المعرفة المطلوبة منّا،وإنما المطلوب منّا معرفة طريقة الرّسل،بل الواجب تنزيه الحق تعالى عن معرفة العقول،فإنها حَصرت الإله الحق وحَدّدته وحَجّرت عليه،وكل محدود مَحصور،وكل محصور مقهور،كيف؟.. فالذي ظَنّه العقل تنزيهاً،هو غاية التّشبيه بالمُحدثات. وهذا الإفراط في التنزيه العقلي،أوْرَث جَهلاً عظيماً لمُتّبعيه،وأوْقَعهم في أبعد ما يتصوّر من البُعد عن معرفة الله وتعالى ومعرفة تجلّياته في الدنيا والآخرة. على أن التنزيه لا يحتاج إليه المؤمن إلا لردّ على مُشبّه،إن كان. فإن لم يكن هناك مُشبّه ففيه من سوء الأدب ما فيه،إذ الحق تعالى نَزيه لنفسه،وإنما يُنَزّه من يجوز عليه ما نُزّه عنه،وهو الحادث..
وليس فيما أدركه العقل،من صفات الإله،صفة ثُبوتيّة،بل كلّها في التحقيق صفات تنزيه تَنفي أضدادها. والحق تعالى ما نَزّه نفسه،في كتبه وعلى ألسنة رُسله،إلا رَدّاً على معتقد ذلك في الإله الحق. فالإله الذي أرسَل الرّسل وأمرنا بمعرفته،ما هو الإله الذي عَرفه العقل بنَظره،وإكتسابه تلك المعرفة من الدلائل المأخوذة من المحسوسات..
وقد وصف الحق تعالى نفسه،على لسان رسله،بالضحك والتبشبش والنزول،وغير ذلك. فهذه النّعوت معقولة المعنى،مجهولة النّسبة إلى الإله.. فالتنزيه الحقيقي هو أن تُثبتها له ولا تَنفيها عنه،ولا تُؤوّل ولا تُشبّه،كما قال الإمام مالك: [الإستواء معلوم والكيف مجهول]..
فإذا آمَن العقل بإله الرُسُل: فإما تَسليماً وتَفويضاً،كما هو مذهب السّلف،فإنهم فَوّضوا من غير تأويل ولا حَيْرة ولا مُنازعة. وإما على كُرْه وإستسلام،كما هو شأن المتكلمين. ولا يزال العقل،غير المُؤيّد بنور الإيمان الغالب على نور العقل،في إضطراب وحيرة ومُنازعة،عن قبول أوصاف إله الرسل. فإن وجد سبيلاً إلى إحالتها إلى ما تُعطيه معرفته،فَعل وإستراح،لظنّه أن ذلك هو المطلوب،وهيهات وهيهات..
والذي نتكلّم فيه مع العقل،إنما هو الألوهة،وهي مرتبة للذات ما هي عين الذات،كالخلافة والسّلطنة للخليفة والسلطان. وأما الذات فلا كلام فيها للعقل،ولا يصل إليها بآلاته أبداً. ولكن من جهة الفيض الرحماني والتعريف الربّاني،تَهُبّ على العارفين منها نَسمات،لأن الذات لا تُعقَل،والكلام فيما لا يُعقل مُحال..
== (الموقف التاسع والتسعون) ==
قال الله تعالى: (ومن جاهد فإنما يُجاهد لنفسه إن الله لغنيّ عن العالمين) [العنكبوت: 6].
الجهاد هنا: أعَمّ من الجهاد الأصغر،الذي حَدُّه عند الفقهاء: قتال مسلم كافراً لإعلاء كلمة الله. ومن الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس والهَوى بإتيان المأمورات وإجتناب المَنهيات،وإرتكاب مَشاقّ الرياضات والمجاهدات..
أخبر تعالى في هذه الآية أن فاعل ما ذكر،إنما يفعله لنفسه،أي حقيقته التي بها هو هو،وهي الحقيقة السارية في كل إنسان،التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: (من عرف نفسه فقد عرف ربّه). وهي المُسماة بالبرزخ وبالصورة الرحمانية،وبمرتبة الأسماء والصفات،وغير ذلك من الأسماء بحسب ما لها من الوجوه والإعتبارات.
فهذه المرتبة هي مرتبة الألوهية،وهي الطالبة للعباد بحقيقتها وهي المُقتضيّة لعبادتهم. وهي الربوبية الطالبة للمربوبين. وليست هي الذات،وإنما هي مرتبة كسائر المراتب والحكم والفعل،والتأثير لها لا للذّات..
وأكثر المتكلمين أو كلّهم،والعابدين من غير أهل الله العارفين: لا يُفرّقون بين الذات والمرتبة.
فإشارة الآية الكريمة: أنه لا يعبُد عابد ولا يتقرّب مُتقرّب،إلا إلى مرتبة الألوهية والربوبية،التي هي مَنشأ العالم جميعه،المُقتضيّة لإيجاده ولكل ما يصدُر عنه.. قال تعالى: (كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) فنفس كل إنسان هي الحَسيبة عليه،المُحصية لأفعاله. وهي غير نفسه المأمورة في مقام الفرق،وهي هي في مقام الجمع وإسقاط الإعتبارات.
وأما الذات العَليّة عَيْنُها،فهي غنيّة عن العالمين،لا تتعلّق بها عبادة عابد ولا معرفة عارف،ولا تُعطي ولا تَمنع،ولا تضُرّ ولا تَنفع،ولا تطلُب مخلوقاً ولا مربوباً ولا عابداً ولا عارفاً.. فهي غنية حتى عن أسمائها،الطالبة لظهور آثارها بظهور العالَم،وهي المُسماة ب(الأحد) وب(الله). ومن هنا قال من قال في إسم الله: إنه علم مُرتَجل،لا صفة ولا مُشتقّ من شيء،حيث كان عَلماً على الذات الذي لا يوصَف ولا يُعلم ولا يُحدّ ولا يُرسَم. وفي الحديث: (ليس وراء الله مَرمى) بمعنى أنه فوق المراتب كلّها،وليس فوق المراتب كلها إلا الذات.. فالأمر الإلهي ما ورد إلا بعبادة الصّفة للصّفة،وهي عبادة المربوب لربّه والمألوه لإلهه.. وأما من قال في إسم الله: إنه صفة أو مُشتقّ من كذا أو كذا،فقد جعله لمرتبة الألوهية. ووروده في القرآن يحتمل الوجهين. وقول من قال: لا يجوز التخلّق بالإسم (الله)،يُريد الأول. وقول من قال يُتَخلّق بالإسم الله،فإنه كسائر الأسماء،يُريد الثاني..
فمن قال من العابدين: أصَلّي وأصوم أو أفعل كذا،قياماً بحَقّ الله أو الأحد،لم تُقبَل عبادته إن قَصد الذات الغنية عن العالمين. فإن الذات لا تَقبله،والأحدية تَرمي به.. فهو يعبُد في غير مَعْبد،ويعمل في غير معمل. إلا رجالاً من خاصة الخاصة،فإن عبادتهم ذاتيّة،لأنهم لما تَجلّت لهم نفوسهم وعَرفوها،رأوا إستفادة وجودهم من غيرهم،فأعطتهم رؤية أنفسهم العبادة الذّاتيّة،لا عبادة المرتبة كغيرهم،لأن مرتبتهم شُهودية،ما هي علمية كغيرهم. وهم الزنادقة الذين قال فيهم الجنيد: [لا يكون الصدّيق صدّيقاً،حتى يَشهد فيه مئة صدّيق بأنه زنديق]. ومن تَسلّق على هذا المقام،وليس من أهله،هَلَك..
__ ذكر الشيخ الأمير في [الموقف السابع بعد المائة]:
قال الله تعالى: (من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضَلّ فإنما يضلّ عليها) [الإسراء: 15].
نفس الإنسان وروحه هي كل شيء يصحّ أن يُعلَم وتُقصَد معرفته،من حق وخَلق،وجوهر وعَرض،وحادث وقديم. فإذا طلب الإنسان الهداية إلى شيء ليعرفه،ووَصل إليه وعرفه،فذلك الشيء نفسه وروحه،فهي التي تَصوّرت له بصورة ذلك الشيء المطلوب المُهتَدي إليه..
== (الموقف المائة) ==
قال الله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) [الفتح: 10].
لما أراد الحق تعالى الظهور لذاته،من حيث الإطلاق،بذاته،من حيث التّقييد،والمطلق عين المُقيّد: جَعل نوراً بمثابة المرآة،ثمّ تَجلّى في ذلك النور،فإنطبعت الصورة الإلهية في ذلك النور إنْطباع الصور في المرايا: (ولله المَثَل الأعلى).
وصورة الشيء مجموع أوصافه،لا عين ذاته. والترتيب حُكمي لا زماني،فإنه لا زمان هناك،ولكن للتّفهيم.
وسَمّى الحق تعالى هذا النور والمُنطَبع فيه: حقيقة محمدية وروحاً كُلّية،ونحو ذلك. فالمُتوجّه على المرآة هو الحق تعالى،والمُنطَبع في المرآة حقيقة محمدية وصورة رحمانية. فالمُتوجّه على المرآة والصورة في المرآة والمرآة شيء واحد،إذ ليس إلا وجود واحد هو الحق تعالى..
فالحقيقة المحمدية هي تَعيّن الحق لنفسه بجميع معلوماته ونِسَبه الإلهية والكونية،فهي الحق،إذ التعيّن أمر إعتباري لا عين له،فليس هناك إلا المُتَعيِّن،قال تعالى: (قل الروح من أمر ربّي)..
ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: (من رآني فقد رأى الحق) يعني رؤية حقيقية،فلا مُغايرة إلا بالإعتبارات العَدميّة،كالإطلاق والتّقييد. ومن هنا قال بعض الأكابر: [الوجود الحق تعالى ظَهَر في الحقيقة المحمدية بذاته،وظهر في سائر المخلوقات بصفاته]،يُريد أن الحقيقة المحمدية ظهرت بالتجلّي الذاتي،موصوفة بجميع صفات الحق تعالى ونِسَبه الإلهية والكونية،وفَوّض إليها تدبير كل شيء يوجد بعدها. فهي المُتَصرّفة في معلوماته تعالى حسب إرادته ومَشيئته تعالى،فتَستمدّ من العلم وتُمدّ الخَلق. فما صَدَر عن الله تعالى بغير واسطة،إلا هذه الحقيقة. وكل ما عَداها،حتى العقل الأول،إنما كان بواسطتها. وإن كان الحق تعالى له الخَلق والأمر،فهي الظاهرة في الأشياء وهي السارية في الوجود..
__ لما أوجَد الله تعالى حقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،قال له: [أعطيتُك أسمائي وصفاتي،فمن رآك رآني،ومن عَلمك عَلمني،ومن جَهلك جهلني. غاية من دونَك أن يَصلوا إلى معرفة نفوسهم منك،وغاية معرفتهم بكَ العلم بوجودك،لا بكيفيّتك. وكذلك أنت مَعي،لا تعرفني إلا من حيث الوجود].
فحقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي المَشهودة لأهل الشّهود،وهي التي يَتغزّلون بها ويَتلذّذون بحَديثها في أسْمارهم،وهي المَعنيّة ب”ليلى وسَلمى”،وهي المُكَنّى عنها: ب”الخمر والشّرب والكأس والنار والنور والشمس والبَرْق ونَسيم الصّبا والمنازل والرّسوم والربا”. وهي نهاية سَيْر السائرين،وغاية مَطلوب العارفين.
وبعدما كَتبت هذا الموقف [الموقف الأول بعد المائة]،خَطر في بالي أنه إذا وَقف عليه بعض مَن لم يُكشَف له سِرّ الحقيقة المحمدية،ربما يقول ما قال الحافظ إبن تيمية لما وَقف على شفاء عيّاض: [لقد تغالى هذا المُغَيربيّ]. ثُمّ نِمْتُ فقيل لي في المنام: زِدْ،وهي: “نار موسى وعصى موسى،ونفس عيسى الذي كان يُحيي به الموتى ويُبرئ الأكمه والأبرص”،فلما إستيقظت زِدْتُها.
== (الموقف الثاني بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (إنك لا تَهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) [القصص: 56]،(وإنك لتَهدي إلى صراط مستقيم) [الشورى: 52].
لا يُفهَم أنه صلى الله عليه وسلم أحَبّ غير ما أحبّ الله تعالى أو أراد غير ما أراده،فإن المحبّة غير الإرادة. وإذا كان الوَليّ،الذي هو قطرة من بحره الذي لا نهاية له،يَصل عند نهاية كماله إلى أن تتّحد إرادته بإرادة الله تعالى،فلا يُريد غير ما تعلّقت به الإرادة القديمة،وإن كَره ذلك شرعاً أو طبعاً،أو أحبّ ضدّه شرعاً أو طبعاً،ولهذا يقول للشيء (بسم الله) بمعنى (كُن فيكون).. وقالوا: [حقيقة الكامل هو الذي لا يمتنع عن قُدرته مُمكن،كما لا يمتنع عن قُدرة خالقه مُحال. خزائن الأمور في حُكمه ومَفاتحها بيده،يُنزّل بقدر ما يشاء]. فكيف به صلى الله عليه وسلم الذي هو البرزخ بين الحق والخلق؟،وهو الحق المخلوق به،وهو المُنَفّذ لمُراده تعالى في عباده: من ضَلال وهُدى،وكفر وإيمان،من حيث حقيقته.. فلا يُريد رسول الله إلا ما أراد الله تعالى،ولا يُحبّ إلا ما أحبّه الله تعالى،وهو الواسطة بين الحق والخلق،ولا شيء إلا وهو به منوط،فهو مَظْهر مرتبة الصفات التي لها الفعل والتأثير..
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس له وجود مع الحق تعالى،وإنما هو ظهور الحق تعالى لنفسه بنفسه،فهو كناية عن علم الحق بنفسه.. فكانت قوة الكلام: الهادي هو الله تعالى،وهو المدعُوّ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا يَفهم عنّا إلا أهل طريقتنا،إذ لا يفهم عنك إلا من أشْرَق فيه ما أشْرَق فيك..
__ [الموقف 161]: فهو صلى الله عليه وسلم المُمدّ لكل نبيّ ووَليّ،من لدُن خَلق العالَم إلى غير نهاية،عَرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. فإذا قال الوليّ: [قال لي الحق تعالى كذا وكذا]،فليس ذلك إلا بواسطة روحانيته صلى الله عليه وسلم،والأكابر لا يجهلون ذلك..
== (الموقف الثالث بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (الله نور السماوات والأرض ــ إلى ــ والله بكل شيء عليم) [النور: 35].
أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الله،الإسم الجامع،من حيث الإسم (النور): نور السماوات والأرض،أي مُجريها وقَيّومها ومَظهرها. إذ بالنور ظهر ما كان في ظُلمة العدم مَستوراً،فالنور سَبب ظهور الكائنات..
وإنما خصّ (السماوات والأرض) بالذّكر،لأن السماوات مَحلّ الروحانيات،والأرض محلّ الجسمانيات. والكل مُستنير بنور واحد،لا يتجزّأ ولا يتبعّض ولا يتقسم.
ولما كان النور المحض لا يُدرَك،كما أن الظلمة المحضة لا تُدرك،تَجلّى النور على الظلمة: فأدْرِكَت الظلمة بالنور،وأدرِك النور بالظلمة.. وهو معنى قول القوم: [الحق تعالى ظَهر بالمخلوقات،وظهرت المخلوقات به]. خَلق بلا حق لا يوجد،وحق بلا خلق لا يَظهر. وليُعلَم أن الحق تعالى في ظهوره لذاته بذاته،غير مُتوقّف على المخلوقات،فإنه من حيث الذات غنيّ عن العالمين.. ولكن في ظهوره بأسمائه وصفاته،بظهور آثارها،هو مُفتقر إلى المخلوقات.. ولا نقص في إفتقار الأسماء إلى مظاهرها،بل هو عين الكمال الأسمائي والصّفاتي..
فالسماوات والأرض،وجميع الكائنات،التي نورها الإسم (النور)،هي ظلال الأسماء والصفات. والذي ظهر عليه هذا الظلّ هي الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية،إذ لا بدّ للظلّ من شيء يَظهر عليه. فالنور يُظهر الظلّ،والشاخص ــ وهو مرتبة الأسماء والصفات ــ يَرسُمه.. والنور هو الوجود الفائض على الممكنات..
وهذه الإنارة من غير إتّحاد ولا إمتزاج ولا إتّصال،وهي بواسطة الحقيقة المحمدية،التي هي التعيّن الأول وبرزخ البرازخ ومظهر الذات ومَجلى النور،وهي المُكنّى عنها ب(الزجاجة).
وأما (المشكاة) فهي جميع الكائنات،ما عدا الحقيقة المحمدية،فإن النور ذائماً سَرى من الزجاجة وبواسطتها.
ف(المصباح) هو النور الوجودي الإضافي،ظهرت به السماوات والأرض. و(الزجاجة) هي الحقيقة المحمدية. و(المشكاة) هي جميع الكائنات..
ثمّ أخبر تعالى أن هذه (الزجاجة)،التي هي الواسطة في وصول النور إلى المشكاة،في لطافتها وبَساطتها وصَفائها وإستعدادها لقبول النور وإفاضته على المشكاة ــ كأنها (كوكب دريّ يوقَد)،أي يستمدّ هذا المصباح،وهو النور الوجودي الإضافي. (من شجرة)،أي من أصل منبع. (مباركة) ثابتة البركة والزيادة،لا ينفُد مَددها. (لا شرقية ولا غربية) فإنها كُنْه الذات التي لا يُحكم عليها بشيء،لأنها لا تُعقَل.. ولم يكُن (زَيْتُها) ما تُمدّ به المصباح يُضيء،يَظهر لذاته بذاته من غير إقتران بشيء،الإقتران المعنوي. (ولو لم تمسسه نار) كناية عن المظاهر التي يقترن بها المُكنّى عنه بالزّيت،الذي هو حقيقة المصباح،والمصباح لا يُظهر ضَوءه إلا بمماسة النار.. (نور على نور) أي النور المُضاف إلى السماوات والأرض،هو عين النور المطلق الذي لا يُقيّد بالسماوات والأرض؟ ف(على) بمعنى (نحن). (يَهدي الله) بتعريفه وتجلّيه،لمن يشاء من عباده،لنوره المطلق غير المُضاف إلى شيء.. (ويضرب الله الأمثال للناس) ليُبيّن لهم الأمر،فإنه بكل شيء عليم. وأما الناس فقد قال لهم (فلا تضربوا لله الأمثال) فحَجّر عليهم لجَهلهم،لأنهم لا يعلمون كيف يَضربون الأمثال،والتّحْجير إنما هو في الإسم الله الجامع،وأما غيره من الأسماء فلا تحجير،والله أعلم وأحكم.
== (الموقف الخامس بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (يُحبّهم ويُحبونه) [المائدة: 54].
محبة الحق تعالى لمخلوقاته على أنواع،نوع قبل خَلقهم ونوع بعد خلقهم. وهي على نوعين: نوع للخاصة،ونوع لخاصة الخاصة.
أما النوع الأول: فهو عام في جميع المخلوقات،على إختلاف أجناسهم وأنواعها وأشخاصها،وهو قوله في الخبر المشهور عند القوم: (كنت كنزاً مَخفياً فأحببت أن أعرف) الحديث. وهذه المحبة هي السّبب الأول لوجود العالَم،وهي المَيْل إلى الظهور بالأسماء والصفات. وهو ذاتيّ ما تَخلّله إسم ولا صفة،إذ لا ظهور للأسماء في هذا الإعتبار. ثُمّ سَرى هذا المَيْل ومحبة الظهور،في جميع الأسماء الإلهية،فطلبت الظهور بظهور آثارها وقد كانت مُستَجنّة في الذات،مُستهلكة في الأحدية. ثمّ لما خلقهم عَرفوه كما أراد،لأن خلاف الإرادة مُحال..
وأما النوع الأول من نَوعي المحبة الخاصة: فهي محبته تعالى لبعض خواص عباده،كقوله: (إن الله يُحبّ التوابين).. ولكنها محبة على الحجاب وشُهود البُعْد. وهذه المحبة هي المَنفيّة عن أقوام مخصوصين،كقوله: (لا يُحبّ الظالمين)،(لا يُحبّ الكافرين)..
أما النوع الثاني من نوعي المحبة الخاصة: فهي المحبة المُشار إليها بقوله تعالى: (لا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه) الحديث. أي كشف له أن هُوية الحق تعالى هي حقيقة قواه الظاهرة والباطنة. وهذا النوع من المحبة على كَشف من المحبوب،وثمرته ظاهرة في الدنيا لأجل ما يحصُل له من المُشاهدة والرّؤية،على التّخييل.. وأما النوع الذي قبل هذا من المحبة فهو على الحجاب،باعتبار شُهود صاحبه للغَيريّة والإثنينيّة،ولا تظهر ثَمرته إلا في الآخرة. ولذا قال صاحب الحكم: [خَرج العُباد والزهّاد من الدنيا،وقلوبهم مَشحونة بالأغيار].
== (الموقف السادس بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (ونُنزّل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82].
يقول الله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) هاتان الآيتيان جَمعتا التنزيه والتشبيه.
الكاف هي كاف الصّفة،كما هو رأي العارفين بالله تعالى.. فمعنى الآية الكريمة: إثبات المِثْل له تعالى،وهو التّشبيه ونَفْي المُماثلة عن هذا المِثْل،وهو التنزيه. فإنه إذا كان لا مِثْل لمِثْله،كان نفي المثل عنه تعالى أولى وأحقّ.
واعلم أن الحق تعالى من حيث إسمه (الباطن) وإسمه (الأول)،لا كلام فيه لعقل،ولا خَبر عنه لرسول. ولكن من حيث إسمه (الظاهر) وإسمه (الآخر) أمْكَن للعقول الإستدلال عليه،وللرسل أن تُخبر عنه..
فالمُماثلة إنما هي بين الصورة الأولى التي هي صورة الحق تعالى،وبين الصورة الثانية التي هي صورة الإنسان الكامل. فيكون المعنى: ليس مثل مثله شيء،فالمثل المُنَزّه هو الإنسان الكامل،أثْبَت له المِثليّة ونَفى عنه أن يكون له مثل،إذ هو الأصل في إيجاد العالَم ولو تأخّرت صورته..
== (الموقف التاسع بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (لا تُدركه الأبصار) [الأنعام: 103].
سُئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربّك؟ فقال: (نور أنى أراه). وقال لسائل آخر: (نعم رأيته).
والتحقيق عندنا: أنه رآه يقظة ليلة الإسراء،وما زاغ البصر وما طغى.
وجوابه للسائل في الرؤية الأولى: إما لكونه صلى الله عليه وسلم عرف منه أنه لا يعرف إلا رؤية الذات البَحْت مُجرّداً عن المظاهر،ولا يعرف هذا السائل أمر التجلّي،فكان هذا الجواب الساذج أولى به. وإما أن يكون السائل لا يعرف إلا الرؤية المُعتادة عند العامة،التي تمنع أنوار الأشعّة الرّائي من تحقيق ما رأى،فوَرّى له صلى الله عليه وسلم بأن الحق تعالى إسمه النور..
فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربّه يَقيناً في مَظهر،وهو التعيّن الأول،وهو خاص بسيدنا محمد،لا يُشاركه فيه غيره من رسول ومَلَك. والرّؤية في غير تعيّن مُحال. وهذه الرؤية التي حصلت لسيدنا محمد من غير سؤال،هي التي سألها موسى عليه السلام فمُنعها على حسب سؤاله لا مُطلقاً،وما حصلت له حتى صُعق..
والمحققون من العارفين لا يقولون: إنهم يَرون الحق تعالى حالة شُهودهم،بل يقولون: إنهم ما رأوه قطعاً،وإنما يرون صورهم ومراتبهم وإستعداداتهم في الوجود الحق تعالى،فلا يُشاهد إلا نَفسه. لأن المُشاهدة على قدر ما يعلمه منه،وإن كان العلم خلاف الشّهود والرّؤية. فكل مَشهود معلوم ما شُهِدَ منه،وما كل معلوم مشهود.. ولذا كان علمنا بالله شعوراً فقط،والشعور علم إجمالي يُعطي أن ثَمّ مَشعوراً به،ولكن لا تعلم ما هو؟..
حارَ العارفون،وحُقّ لهم أن يَحتاروا. وأرادوا أن يجعلوه تعالى عين العالَم،فما صَفا لهم ذلك،لنَزاهته وقُدسه. وأرادوا أن يجعلوه غير العالَم،فما صحّ لهم ذلك،لأن العالَم ليس بشيء زائد على نِسَب علمية،مع إعتبار العلم عين الذات. فالعارف في حجاب،والجاهل في حجاب،وإن إختلفت الحُجُب. والعالِم في حجاب،والرّائي في حجاب،والمُشاهد في حجاب،والمُكَلّم في حجاب. وكل ما أشْعَر بالإثنينيّة،فهو حجاب. وإنما الشّأن في العَيْنية،وهي لا تُجامع الشعور بقَيْد من قُيود الغيريّة.
== (الموقف العاشر بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (وقل رب زدني علماً) [طه: 114].
إعلم أن رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مَلّكه الله تعالى كلّ فضيلة،وزَيّنه بكل خِصْلة جميلة. وما أمره بطلب الزيادة من شيء،إلا العلم لعِظَم شَرفه. ولشَرفه على سائر الأسماء والصفات،جعله بعض سادات القوم إمام الأئمة،وإعترض على الشيخ الأكبر حيث جعل الإسم (الحيّ) إمام الأئمة..
وليس المُراد بالعلم المأمور بطلب الزيادة منه،علم الشرائع والأحكام،من واجب ومُباح وحرام،فإن هذا النوع من العلم كان صلى الله عليه وسلم يَكره الزيادة منه،ويقول لأصحابه الكرام: (أتركوني ما تركتكم)..
وإنما المراد بالعلم،المأمور بطلب الزيادة منه،هو علم التجلّيات الربانيّة وعلم الأسماء والصفات الإلهية. وهو العلم الذي لا تزال ثَمرته مُلازمة لصاحبه في الدنيا والآخرة،في جميع مواطن القيامة وفي الخلود وفي الجنة،أبد الآباد. وأما غيره في سائر العلوم،فإنما يُحتاج إليه في الدنيا،دار التكليف والإحتياج والفاقة.
واعلم أن العلم حقيقة معنوية بسيطة،لا توصف بالزيادة والنقص والقلّة والكثرة،إلا من حيث المعلومات المُنكشفة بها،فحينئذ تتعدّد بتعدّد المعلومات. كما أن كل معلوم حقيقة واحدة،لا تتعدّد ولا تتجزأ ولا تتبعض،ولكن كل وحدة لها كثرة بحسب وجوهها وإعتباراتها،فيها يَلحق العلم القِلّة والكَثرة والزيادة والنقص..
ولا يعلم المعلوم إلا العلم،وأما العالِم فإنما يُدركه بواسطة العلم. فلهذا كان العلم حجاباً بين العالِم والمعلوم. فلا تقُل: إنّك أدركت شيئاً،قديماً أو حادثاً،وإنما أدركت العلم،وكل الأشياء تُدرك بالعلم،والعلم يَعلم نفسه..
الوجود ليس إلا للحق،وكذا توابع الوجود: من علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام وحياة.. فما لا وجود له،لا شيء له..
== (الموقف العشرون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين) [الشعراء: 32].
إعلم أن قول الحكماء وبعض المتكلمين بأن إنقلاب الحقائق مُحال،والأعيان لا تنقلب،ونحو ذلك من عباراتهم،يريدون: أن الجماد لا ينقلب حيواناً مثلاً،لكون الجماد له حقيقة بها هو هو،تُغاير حقيقة الحيوان التي بها هو هو،لا يصحّ.. فمن المعلوم أن حقيقة الشيء ما به هو هو،وكل شيء في العالَم،أجناسه وأنواعه وأشخاصه،إنما هو هو بحقيقة واحدة لا تتعدّد ولا تتجزأ ولا تتبعض. وهذه الحقيقة،مع وحدتها،هي المُقوّم لجميع أجناس العالم وأنواعه وأشخاصه وجزئياته،والعالَم قائم بها،ولا يصحّ إنقلاب الواحد بالوحدة الحقيقية،لأنه لو إنقلب،إنقلب إلى غيره،ولا غَيْر،أو ينقلب إلى لا شيء وذلك لا يُعقل.
فلو كان لكل فرد من أفراد العالَم حقيقة تخُصّه،وهو مُركّب من الحقيقة التي تخُصّه والعَرَض،لما صَحّ إنقلاب العصا ثعباناً مُبيناً،ولا نحو ذلك من معجزات الرّسل كإنقلاب النار بَرداً وسَلاماً،ولا صحّ قول الحكماء بالشكل الغريب.
فثَبت أن العرش وما حَوى،ممّا قسّموه إلى جواهر وأعراض ومُجرّدات،كُلّه أعراض،وحقيقته التي بها هوهو واحدة،وهي المُقوّمة له. وهي لا تُدرك على حِدَتها بشيء من الحواس،فوجودها في الخارج هو وجود الصورة،ولا هي داخلة في العالم ولا خارجة عنه.
وهذه الحقيقة تَلتبس أعراضاً وتَخلعها،وهكذا على الدّوام،كما لَبست الأعراض التي تخُصّ العصا ثُمّ خَلعتها،ولبست الأعراض التي تخصّ الثعبان ثمّ خلعتها،وهكذا. وهي في حدّ ذاتها لا تتبدل ولا تتغير عن حقيقتها،فهي هي في كل حال..
فالحرارة لا تنقلب بُرودة،ولكن الحقيقة التي قامت بها الحرارة،لمّا إنعدمت الحرارة،قَبلت قيام البرودة بها،وهكذا في جميع الأعراض..
فلا يُمكن حمل قولهم “إنقلاب الحقائق مُحال” على الأعيان الثابتة،التي هي حقائق الأشياء في العلم،فإنها ما خرجت عن العلم إلى العين حتى يُتصوّر فيها الإنقلاب. ولا أنهم أرادوا بالحقائق “أحكام الإستعدادت”،التي ظهرت بها هذه الحقيقة الكُلّية المشتركة بين أفراد العالم جميعه،فإن هذا ليس من علومهم العقلية.
وكذا قولهم ب”الإستحالة”،أعني قولهم: إستحال الماء هواء،والهواء ناراً،ونحو ذلك،لا يصحّ،بل هو من نَمط ما ذكرنا من خَلْع الحقيقة الكُلّية عَرَضاً ولَبْسها آخر مثله أو ضدّه،على الدّوام.
فإذا عرفت هذا،عرفت ما يُزهّدك في علوم العقلاء والحكماء والمتكلمين،ويُرغّبك في علم العلماء بالله. وهذه المسألة وما شاكلها،من الأوليات الضروريات عند القوم. وقد خطر لي،إن كان في العمر سِعَة،تأليف كتاب أجمع فيه ما وصل إليه علمي من غَلطات الحكماء والمتكلمين،أسمّيه (الإعلام بأغاليط الأعلام) إن شاء الله تعالى.
== (الموقف السادس والعشرون بعد المائة) ==
روى مسلم في صحيحه،أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنه ليُغان على قلبي فأستغفر الله في كل يوم مائة مرة) الحديث.
تكلّم الناس على هذا الحديث،في القديم والحديث،من علماء الشريعة وعلماء الحقيقة.. وقال العارف الكبير أبو الحسن الشاذلي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث فقال لي: (يا مُبارك: هو غَيْن أنوار،لا غين أغيار) ولم يزد شيئاً..
(الغَيْن): يُطلق: على الرّين،وعلى ما يَغشى القلب من الشهوات،وعلى التّغطيّة. والمُراد هنا المعنى الأخير.
أخبر صلى الله عليه وسلم أن أنوار القُرب،الموجبة للفناء بالمُشاهدة والمَحْق،كانت تُغطّي على قلبه الشريف تَغطية لائقة ومُناسبة لمقام النبوة،بحيث لا يُخلّ بأقلّ القليل ممّا يطلُبه الحق أو الخلق.
والمراد ب(القلب) هنا (العقل)،فإنه المُدبّر للمملكة الإنسانية،وبه يكون القيام بحقوق الخلق والحق. فإذا غطّى عليه،لم يبق هنالك شعور بغير،لا من نفسه ولا من غيره،ولا إدراك لرسالة ولا لمُرسَل إليهم. فإنه في هذه الحالة تنتفي الغيريّة وتزول الإثنينيّة،فيتّحد المطلق بالمقيّد. فإذا رجع صلى الله عليه وسلم من هذه التغطيّة،الموجبة لعدم شهود العبودية،يستغفر الله تعالى،أي يطلب منه السّتر والحَيلولة عن ذلك،لأن هذه الحالة ربوبيّة مَحضة..
وهذا كان له صلى الله عليه وسلم في بداية أمره،فكان يطلب السّتر عن ذلك. لأنه صلى الله عليه وسلم عَلم الحكمة في إيجاد هذا الموجود،وأنه تعالى ما أوجَده في صورة المُغايرة الإعتبارية إلا ليعرفه فيعبُده. لأنه تعالى لا يَعبُد نفسه من حيث هو هو،من غير مُغايرة إعتبارية. ولأنه تعالى أحَبّ أن يرى ذاته في صورة غير،لأن رؤيته نفسه في نفسه،ما هي مثل رؤيته نفسه في غير،ولا غير إلا بالإعتبار الذي هو عدم في نفسه. وعَلم صلى الله عليه وسلم أن الدار دار محنة وتكاليف،لا تصلُح لهذه الأحوال،ولا للظهور بأوصاف الربوبية،لا قولاً ولا فعلاً،لضَيقها وللتّحجير الواقع فيها..
ولهذا أنِفَ الأكابر من المتحقّقين بالوراثة المحمدية،من هذه الأحوال التي تحول بينهم وبين شهود العبودية،ومن التّظاهر بصفات الربوبية،وطلبوا الترقّي عن ذلك بدوام شهود العبودية والإفتقار والعجز.. وإذا أنف الكُمّل من هذا،فكيف بالأنبيا؟ فكيف بسيّد الأنبياء وأكملهم صلى الله عليه وسلم؟..
فزمان الفناء بالمشاهدة عن المخلوقات،زمان ترك عبودية،يُفوّت مقامات عظيمة من مقامات الأدب.. فالكمال،الذي هو مقام النبوة،هو الإعتدال،وهو القسطاس المستقيم الذي أمر الحق تعالى عباده بالوزن به. فمتى غلب النور،الذي هو الحق،على الظلمة،التي هي الخلق،زالَ الإعتدال فزالَ الكمال،وذلك غير لائق بمَنصب النبوة الأسمى. فإستغفاره صلى الله عليه وسلم إنما كان خوفاً من غَلبة النور على الظلمة،فطلب البقاء على الإعتدال دائماً،ليؤدّي كل ذي حقّ حَقّه. فإن الظلمة الطبيعية لها شرف عظيم لأداء العبودية عند شهودها.
== (الموقف السابع والعشرون بعد المائة) ==
قال الله تعالى،خطاباً لعائشة وحفصة: (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) [التحريم: 3].
قال أمام العارفين شيخنا محيي الدين ما معناه: لَقيت بعض العارفين فقلت له: إن الله تعالى يقول: (ولله جنود السماوات والأرض) والجنود لا يُحتاج إليها إلا لمقابلة عدُوّ عظيم،ومن هو هذا العدوّ العظيم،المُضادّ له تعالى،حتى يحتاج لمُقابلته بجنود السماوات والأرض؟ فقال لي: ألا أدُلّك على أعجَب من هذا؟ ثُمّ تَلا: (وإن تظاهرا عليه) الآية. قال: فإزددت إعجاباً،وما عرفت السِرّ الذي كانت به هذه القوّة لعائشة وحفصة،حتى خاطبهما الحق بهذا الخطاب المبين،لعظيم قوّتهما،فسألت الله تعالى كَشْفه فكَشفه. اهـ.
وما كشف الشيخ هذا السرّ. ولما وقفت على كلام الشيخ هذا،تعلّقت همّتي بكَشفه،فكشفه الحق لي مَناماً،فأخبرني أن هذه القوة الحاصلة للمرأتين إنما كانت للمُشابهة بحَضرة الإنفعال،وهي الحضرة الإمكانية،وزادا على ذلك: بكونهما مَظهرين كاملين للحقيقة الفعلية الوجوبية لكمالهما الإنساني،فجمعا بين حضرتي الفعل والإنفعال.
فجنس المرأة،لمّا كانت مَحلاً للتّكوين،كان أقرب إلى المُكَوَّن. وإن حضرة الإنفعال لها شرف عظيم وفضل فخيم وقدر جسيم،من حيث أن حضرة الفعل والوجوب والتأثير،إنما ظهرت بها وتعيّنت بسَببها. فلو كانت هذه الحضرة غير قابلة للإنفعال والتأثير،ما حصل تأثير أصلاً،ولا كان لحضرة الفعل والوجوب ظهور. ألا ترى العدم المطلق،وهو المستحيل،حيث ما كان قابلاً للإنفعال والتأثّر،ما حصل فيه تأثير،ولا كان لحضرة الفعل والوجوب بها ظهور؟.
فهذه الحضرة الإنفعالية،التي هي مظهر للحضرة الفعلية،الجامعة لجميع الأسماء والصفات،على الإجمال والتفصيل ــ لا تُقابلها إلا الحضرة الجامعة للأسماء والصفات على الإجمال والتفصيل،وهي الإسم الجامع (الله)،وحضرة التفصيل وهي جبريل وصالح المؤمنين والملائكة جميعهم.
ولإنكشاف هذا السرّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حُبّب إليّ من دنياكم ثلاث: النساء..) الحديث. يعني حَبّبهُن الله إليّ بكَشف هذا السرّ الذي فيهن. وما قال (أحْبَبت)،فيكون حُبّه لهن كسائر الناس من أهل الحبّ الطبيعي والمَيْل الشّهواني.
قال سيدنا محيي الدين: [كنت أبغضَ الناس للنساء،مُدّة ثماني عشرة سنة،والآن أنا أشدّ الناس حُباً لهن]،وما ذلك إلا لإنكشاف هذا السرّ له..
== (الموقف الثاني والثلاثون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (وهو معكم أين ما كنتم) [الحديد: 4].
(الهو) هنا: كناية عن البطون الذّاتي الذي يَستحيل أن يصير شَهادة لمخلوق ما،وفي حال ما،دنيا وآخرة..
والمَعيّة،في أصل الوضع اللساني،تُطلق على مُصاحبة شيئين مُستقلّين بالوجودية،ولا تطلق على الجوهر والعَرض،إذ العرض لا إستقلال له بالوجودية،لأن قيامه بالجوهر.. وإن كان ما سوى الحق تعالى يوصف بالوجود،فهو مجاز،فإنه وجود خَيالي..
فلولا معيّة الحق تعالى بذاته،التي هي عين وُجود،ما صحّ نسبة مخلوق إلى الوجود،ولا وقع عليه إدراك حِسّي ولا خيالي ولا عقلي. فمعّيته تعالى هي الحافظة على الموجودات نسبة الوجود،بل هي عين وُجوداتها. وهذه المعية عامة لكل موجود،من جليل وحقير،كبير وصغير. فهي القيّوميّة التي قامَ بها كل شيء،وهي محض الوجود الذي به كل شيء موجود..
فمعيّته تعالى بذاته،وهي المُعبّر عنها بالهُويّة السارية،من غير سَريان ولا حلول ولا إتّحاد ولا إمتزاج ولا إنحلال،لأن هذه المذكورات تُقال على وجودين،كما هي عند العموم. وليس عندنا إلا وجود واحد قديم،مُنزّه عن قيّام الحوادث به وقيامه بالحوادث.
ومن قال: مَعيّته تعالى بعلمه،كما هو الرأي المشهور عند الجمهور. فإن أرادوا بذلك تنزيه الذات عن معيّة المخلوقات،فمعلوم أن ما ثَبت في النّزاهة للذّات،هو ثابت للصفات. وإن أرادوا أن الذات حقيقة أحديّة،لا تتجزّأ ولا تتبعّض،والموجودات متعدّدة،فكذلك العلم حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعّض..
وإذا سمعت من عارف أو رأيت في كلامه: أن معيّته تعالى بالعلم،فلا يعنون العلم الذي يَعنيه المتكلمون،وإنما يعنون شيئاً آخر،فيُبهمون الأمر على المُخالف المُشغِب.
قال شيخ العارفين محيي الدين: [القول بأن معيّته تعالى مع كل شيء بالعلم،أقرب إلى الأدب. والقول بأن معيّته بالذات،اقرب إلى التّحقيق]. يُريد بالأدب عند المحجوب وعلى زَعمه،أو أعَمّ من حيث أنه ليس كل حَقّ يُقال ولا كل ما يُعلم يُقال..
وله تعالى مَعيّة خاصّة بخاصّة العامّة،وهي معيّة الإمداد بمكارم الأوصاف وجميل الأخلاق..
وله تعالى أيضاً معيّة خاصة بخاصة الخاصة،وهي للرّسل والأنبياء،ومن كان من وَرثتهم: وليست إلا غَلَبة أحكام الوجود والوجوب والقِدَم،على أحكام الإمكان من حدوث وعدم. كقوله تعالى لموسى وهارون: (إنني معكما أسمع وأرى) أي أسمع بكما وأرى بكما،لأن معيّتي غَلبت عليكما. فإنما أنا أنتُما،إلا من حيث الصورة فقط. وهذا المقام معروف عند القوم ب(قُرب الفرائض)،فهو ظهور الربّ وبطون العبد. وصاحب هذا المقام إذا نودِيَ ب(يا فُلان)،يقول الحق نيابة عنه: (لبّيك). وهو أعلى من (قُرب النوافل)،فإن صاحب هذا المقام إذا نادى مُناد وقال: (يا الله)،يقول هذا العبد: (لبّيك)،نيابة عن الحق تعالى..
__ فللحق تعالى المَعيّة،ولنا التبعيّة لا المعيّة.. وأكثر ما تَرد الخطابات الإلهية في الكتب المنزّلة على ألسنة الرسل،بما تَقرّر في عقول العامة وغَلَب على أوهامهم. إذ ليس في نفس الأمر والحقيقة،إلا الوجود الظاهر بأحوال الممكنات،وهو المُقَوّم لتلك الأحوال بمَعيّته،التي هي عين وجوده،وهي تابعة له تَبعيّة العَرض للجوهر،ولله المثل الأعلى..
فمعيّته تعالى هي رحمته بكل شيء،حيث يقول: (ورحمتي وسعت كل شيء). وما وَسع كل شيء إلا الوجود والعلم،اللذان هما عين الذات،رَبّنا وَسعت كل شيء رحمة وعلماً،وهي وَجهُه أينما نَتولّى..
فمعيّته تعالى بذاته الجامعة لصفاته،لا بصفة العلم،على المعنى الذي يعرفه علماء الرّسم،ولو قالت به ألف فرقة.
ولما كانت معيّة الحق تعالى لنا،بالمعنى الذي ذكرنا،وهو معنى وحدة الوجود،وأنه لا وجود إلا وجوده تعالى،ولا صفات إلا صفاته تعالى ــ كان الوجود المنسوب إلى المخلوق مَجازاً،هو وجوده تعالى،كما قال: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى).. فهو تعالى مع مخلوقاته بالوجود،وتوابع الوجود.
وقد ورد في الخبر: (كان الله ولا شيء معه) أي: كانت صفات الألوهية،التي بها سُميَ إلهاً،ثابتة له أزلاً،حيث لا شيء معه من المخلوقين المألوهين ــ موصوف بالوجود وإن كانوا موصوفين بالثّبوت. ولما كانت هذه العبارة يوهِم ظاهرها أنه صارَ معه تعالى،بعد إيجاد المخلوقات،شيء،أدْرَج الراوي: (وهو الآن على ما عليه كان) دَفعاً لهذا التوهّم،بمعنى أن معيّة شيء له تعالى مُنتَفيّة أزلاً وأبداً،قبل نِسبة المَوجودية لشيء وبعدها. والذي حمل الراوي على هذا،هو فَهمه أن (كان) ناقصة،والأصوب أنها تامّة وأنها للوجود،كما هي عند سيبويه. بمعنى: الله وُجود،ولا شيء معه له وجود غير وجوده تعالى،أزلاً وأبداً..
وهذا الخبر تداوله أئمة القوم،وقال الحُفّاظ: إنه غير ثابت في شيء من كتب الحديث. والذي في صحيح البخاري: (كان الله ولم يكن شيء غيره،وكان عرشه على الماء). ف(كان الأولى) بمعنى الوجود أزلاً،لا رائحة للزمان فيها،فهي للوجود. و(كان الثانية) بمعنى الكون بعد العدم،إذ العرش حادث مَسبوق بالعدم،فهي للزمان.
فمن عَلم المَعيّة على ما قُلنا،عِلماً ذَوقيّاً حاليّاً،كان السيّد الكامل. ومن عَلمها علماً خيالياً،كان العالِم الفاضل. ومن آمَن وسَلّم،كان المؤمن العاقل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
== (الموقف الرابع والثلاثون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (ألم تر إلى ربّك كيف مَدّ الظّلّ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يَسيراً) [الفرقان: 45_46].
للحق تعالى ثلاثة ظِلال:
الظّلّ الأول: هو الوجود الإضافيّ المُسمّى ب[نَفَس الرحمن،والتعيّن الأول،والوحدة المطلقة،والحقيقة المحمدية]. وهو ظلّ مُجمل غير مُفصّل.
الظلّ الثاني: هو المُسمّى ب[التعيّن الثاني،ومرتبة الواحدية،والإنسان الكامل]. وهذا الظلّ مُفصّل تفصيلاً معنوياً علمياً.
الظلّ الثالث: هو العالَم كلّه،مُلكُه ومَلكوته،المُسمّى ب[الصُور الخارجيّة،والأعيان المُفَصّلة،والوجود الخارجيّ].
فهي ثلاثة ظلال في مقام الفرق،وظلّ واحد في مقام الجمع،بل ولا ظلّ أصلاً بالنّسبة إلى الوجود..
فالظلّ الأول: ظلّ الذات. والظلّ الثاني: ظلّ الأسماء والصفات،باعتيار الذّات. والظلّ الثالث: ظلّ الصفات والأسماء،لا باعتبار الذّات. فافهم أو سَلّم.
وإمتداد الظلّ هو تَعيّنه وتَميّزه،تَمييز المُقيّد عن المطلق. وليس للمُقيّد حقيقة مُغايرة للمطلق. والإمتياز والتعيّن،أمور عَدميّة في الخارج كسائر النّسب. ولو شاء لجعله ساكناً باطناً في الذات،غير مُتميّز عنها التميّز النّسبي لا الحقيقي،إذ ليس الظلّ وُجود مُغاير لوجود ما إمتدّ عنه. والقضيّة الشّرطيّة لا تقتضي الوقوع ولا الإمكان،كما قال تعالى: (ومن يقُل منهم إنّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم) ومُحال أن يقول المَلَك إنّي إله.. فلا تتعلّق المشيئة بالمُحال،إذ لا يَشاء تعالى إلا ما عَلم قبوله للإيجاد،وما علم تعالى للمُحال قبول إيجاد،فلا تتعلّق به قُدرته،لأن إسمه تعالى (الحكيم)،فيُعطي كل مُستعدّ إستعداده،وليس للمُحال إستعداد قبول الوجود،لا عجزاً،فإنه على كل شيء قدير..
للوجود الحق كَمالين: كمال ذاتيّ،وهو في هذا الكمال غنيّ عن العالمين،وعن أسمائه وصفاته أيضاً. وكمال أسمائي،وهو المُقتضي لظهور الأسماء والصفات بآثارها،فالمُقتَضي هي الأسماء والصفات المُؤثّرة،لا غير..
(ثُمّ جَعلنا الشمس عليه دليلاً): علامة منصوبة لمعرفة أحوال هذا الظلّ المذكور.. فكما أنه في الحسّ،لولا نور الشمس ما ظهرت للشّخوص ظلال،فكذلك هذا الظل،لولا الذات من حيث إسمه تعالى (النور) ما ظهر لهذا الظلّ عين. وكما أنه في الحسّ،لولا الشاخص الذي يرسُم الظلّ ما ظهر للظلّ عين،فكذلك هنا،لولا مرتبة الصفات والأسماء ما ظهر هذا الظلّ. وكما أنه في الحس،لا بُدّ من مَحلّ يمتدّ عليه الظلّ كالأرض والماء،فكذلك هذا الظلّ،لولا الأعيان الثابتة في العلم والعدم ما ظهر هذا الظلّ. وكما أنه في الحسّ،قُرب غروب الشمس تُظهر للشخوص ظلال مُمتدّة لا نهاية لها،فكذلك هذا الظلّ لا نهاية لإمتداده،بحسب ما يمتدّ عنه من أحوال كل عين من الأعيان..
(ثمّ قبضناه إلينا قبضاً يَسيراً): قَبضُه هو ما يَلحق كل عين عند نهاية أمَدها المُقَدّر لها،من عدم صورتها. فقبض الظلّ هو رجوعه إلى ما إمتدّ عمه،فيصير إلى العلم بعد العين،أعني صورته،وأما حقيقته وجوهره فلا يَلحقها عدم أصلاً بعد الوجود. وهذا القبض هو معنى قوله: (وإليه يُرجَع الأمر كلّه)..
== (الموقف السادس والثلاثون بعد المائة) ==
رُويَ في صحيح البخاري ومسلم،في حديث جبريل المشهور،أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان،فقال: ما الإحسان؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: (الإحسان أن تعبُد الله كأنك تراه،فإن لم تكن تراه فإنه يراك).
إعلم أن الإحسان مقام جليل،وهو مشتمل على مقامات،وخَصّ صلى الله عليه وسلم هذين المقامين لأنهما أساس لما بعدهما من المقامات..
فيجب السّعي في تحصيل مقام الإحسان بتحصيل أسبابه،وذلك واجب بإجماع العارفين،بل والفقهاء،من حيث أنهم مُجمعون على وجوب النيّة وهي القصد إلى العبادة. ولا شكّ أن العابد لا يعبد مَن لا يعرفه،ولو بوجه،وإذا عرفه إستحضره على حسب معرفته،وذلك ضرب من الإحسان.
ومقام الإحسان أشرف وأعلى من مقام الإيمان،إلا من حيث التقدّم،فالإيمان أشرف. ومقام الإيمان أعلى وأشرف من مقام الإسلام،على القول بتباينهما. فالإحسان باطن الإيمان ولُبّه،والإيمان باطن الإسلام ولُبّه،والإحسان لُبّ اللّبّ..
(كأنّك): “كأنّ” هنا للتّحقيق،كما هو الأمر عليه في نفسه،وكما ذاقَه من ذاقَه من أهل الكشف والعرفان..
(فإن لم تكن تراه فإنه يراك): زيادة منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن بعد هذه المرتبة ثلاث مراتب: الأول هو الذي وقع السؤال عنه،والثاني أن يَشهد العابد الحق تعالى جميع قواه التي يفعل بها،والثالث أن يشهد العابد الحق تعالى فاعلاً به. فلا خروج لصاحب مقام الإحسان عن هذه الثلاث المُشاهدات: الأولى تعليم وتدريج،والثانية والثالثة هُما حقيقة الأمر. فقوله (تَراه): أصله ترى به،حذف الجار فإتّصل الضمير بالفعل.. وهو أن يَشهد العابد نفسه حال العبادة،بل وفي غيرها من سائر الأفعال والإدراكات،أنه بالله.. فيكون العبد ظاهراً،والحق باطناً. وهذا المقام هو المسمّى عند القوم ب(قُرب النوافل)،وهو ثابت ذوقاً ووجداناً..وصاحب هذا المقام ما تَخلّص بعد،ففيه بَقيّة نفس هي الفاعليّة بالحق تعالى والسّمعية به والبصيرة به..
(فإن لم تكن تراه فإنه يراك): هو تعريف للمقام الثالث من مقامات الإحسان،أي: إن لم تكن لك نفس،ولم تبق فيك بَقيّة،ولا لك مُغايرة للوجود الحق،ولم تكن لك حقيقة ترى به كما في المقام الأول ــ فإنه يراك،أي يَرى بكَ.. وفي هذا المقام يَشهد العابد نفسه وقواه الباطنة وأعضاءه الظاهرة،آلة الحق،والحق تعالى المُصَرّف لها،المُؤثّر بها: فيَسمع بسمع العبد ويُبصر ببَصره،إلى آخر المُدرَكات. فيكون الحق تعالى ظاهراً،والعبد باطناً. وهذا يُسمّى ب(قُرب الفرائض). ودليل هذا المقام،بعد الذّوق والوجدان،قوله تعالى: (فأجره حتى يسمع كلام الله) وما سَمع هذا الأحد الكلام،في ظاهر الأمر،إلا من صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،فالمُتكلّم الله بلسان محمد. وقوله تعالى: (قاتلوهم يُعذّبهم الله بأيديكم) فالمُعذّب الله بأيدي الصحابة. وفي الحديث: إن الله قال على لسان عبده: (سَمع الله لمن حَمده)..
وقد أخبر الوارد: أن هذا المعنى لهذا الحديث،ما تَقدّم لأحد كتابته،والله أعلم.
== (الموقف الثامن والثلاثون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تُلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) [المنافقون: 9].
إمتثال النّهي عن المَنهي عنه،يَحصُل بفعل الضدّ،إذ لا تكليف إلا بفعل..
والمأمور في ضمن النّهي صنفان من الناس: مؤمن مَحض،ومؤمن مَجازاً.
المؤمن المحض: مَنهي من مقام إيمانه،وهو أن ينظُر إلى أمواله وأولاده وجميع ما أنعم الله به عليه،بذكر الله،بحمده وشكره،وأنه تعالى مُتفضّل مَنّان فيما أعطى،وأن أحداً لا يستحقّ على الله تعالى شيئاً ممّا أنْعَم.
والمؤمن مجازاً: مَنهي من مقام معرفته ومُشاهدته،وهو مأمور بأن يرى أمواله وأولاده وجميع ما أنعم الله به عليه،تجلّيات الحق تعالى عليه وظهورات من ظهوراته تعالى لديه،فيُشاهد المُنعم في النّعمة،فهو لا يرى إلا الحق تعالى ولا يلتذّ إلا بالحق.
فالأول يَرى النّعمة،والثاني يَرى المُنْعم. أو قُل: الأول يرى الأثَر،والثاني يرى المُؤثّر. أو قُل: الأول يرى الإسم،والثاني يرى المُسمّى..
== (الموقف الثالث والأربعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (فانظُر إلى ءاثار رحمت الله كيف يُحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمُحيي الموتى وهو على كل شيء قدير) [الروم: 50].
أثَر الرحمة هو إدرار العلوم الربانية الوَهبية،والأسرار العرفانية الغيبية. كما قال في الخضر: (آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدُنا علماً)،وقال نوح: (وآتاني رحمة من عنده فعُمّيَت عليكم)..
الحق تعالى يُحيي أرض أيّ نفس من رحمة الرحمة الإختصاصية بالعلم الإلهي،من غير واسطة مُعلم مَشهود.. فحياة أرض النفوس ليست إلا بالعلم الربّاني..
أفرد الله (النور) وجَمع (الظلمة): لأن النور،الذي هو العلم،الذي يَهدي إلى الصراط المستقيم،وهو واحد،صراط المُنعَم عليهم،أهل السعادة. والظلمة،التي هي الجهل،مُتعدّدة،لأنها تَهدي إلى سُبُل الغواية..
والإشارة: أن مَن ظَهر عليه أثَر رحمة الله الإختصاصية،وأحياه الله بالعلم الرباني،لمُحيي بالعلم المَوتى بالجهل،بما حَصل له من الرحمة التي ظهر عليه أثرها. (وهو على كل شيء قدير) بقُدرة الله تعالى،لإتّحاد إرادته بإرادة الحق تعالى،فهو يفعل ما يُريد ويُريد ما يَعلم. فأما ما لا يعلمه فلا يُريده. وهو الإنسان الحقيقي الخليفة.
== (الموقف الرابع والأربعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (وعلّم آدم الأسماء كلها) [البقرة: 31].
أطْلَع الحق تعالى آدم على الأعيان الثابتة،التي هي حقائق الأشياء الخارجية،فالأعيان الخارجية بمثابة الظّلال لهذه الأعيان الثابتة. وإطّلاعه عليه كان في الموطن الثاني من مواطن العالَم المُسمّى بظاهر العلم والوجود.
فعَرف،من إطّلاعه على الأعيان الثابتة،أسماء الحق تعالى المُتوجّهة على إيجاد الأعيان الخارجية،إذ كل عين لها إسم يخُصّها.
والعارف يعرف الإسم الإلهي بأثَره،فيكون الإسم كالروح،والأثر بمثابة الصورة. وهذه المعرفة دون معرفة آدم،كما أن معرفة آدم دون معرفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ سيدنا محمد عرف الأسماء في موطنها الأول،وهو المُسمى بباطن العلم والوجود،حيت تُسمّى شؤوناً،ثمّ نَزل إلى الموطن الثاني الذي تُسمّى فيه أعياناً ثابتة وإستعدادات،ثمّ عرفها في موطنها الثالث حيث تسمّى أعياناً خارجية. فسيدنا محمد عرف الأصل،ثمّ تَدلّى إلى الفرع. بخلاف آدم فإنه عرف الفرع،ثم ترقّى إلى الأصل..
وتعليم الحق تعالى الأسماء لآدم،ما كان بدراسة ولا إنزال وَحي ولا إرسال مَلَك،وإنما حصل له ذلك بأن كَشف لآدم عن إنسانيته التي هي حقيقته،فوجدها مجموع الأسماء الإلهية والكونية في مقام الفرق.. وإنما كانت حقيقة آدم بهذه المنزلة،لكونه برزخاً جامعاً بين الوجوب والإمكان،فهو البرزخ الجامع بين الطرفين المُتقابلين..
== (الموقف التاسع والأربعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (فولّ وجهك شطر المسجد الحرام) [البقرة: 144].
أي: وَجّه وَجهك الخاص بك،وهو الذي قال تعالى فيه: (ويبقى وجه ربك). وهو سِرّك الذي قامت به روحك،كما قام جسدك بروحك،فإنه هو المُراد من الإنسان المقصود بالأمر. فإن الله لا ينظُر إلى صوركم،وإنما ينظر إلى قلوبكم،وهو وجوه الحق تعالى التي لكم ومَنسوبة إليكم،وهي التي وَسعت الحق منكم..
فمن نَظر بعينه المُقيّدة لا يَرى إلا الأشياء المقيّدة،وهي الأجسام والألوان والسّطوح. ومن نظر بعين روحه الباطنة،رأى الأشياء الباطنة من الأرواح وعالَم المثال المطلق والجن،وكلها أكوان وحُجُب. ومن نظر بوجهه،وهو سِرّه،رأى وجوه الحق تعالى التي له في كل شيء،فإنه لا يرى الله إلا الله ولا يعرف الله إلا الله. وهذه الأعيُن الثلاثة هي عين واحدة،إختلفت بإختلاف مُدرَكاتها..
ولهذا الوجه قال تعالى: (يا إبن آدم مَرضت فلم تعُدني،وجُعت ولم تُطعمني،وظمئت ولم تسقني). ولهذا الوجه قال تعالى: (كنت سمعه وبصره) الحديث. ولهذا الوجه قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) فإنه هو الذي عُبد في كل مخلوق،عُبد في نار وشمس ونجم وحيوان وجنّ ومَلَك..
فمُلاحظة هذا الوجه لازمة في كل عبادة وعادَة. فإذا توجّه إلى القبلة للصلاة،يرى أن المُتَوجِّه حَقّ والمُتوجَّه إليه حقّ. وإذا تَصدّق،يرى أن المُعطي حقّ والمُعطى حق،كما قال تعالى: (ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات)،وفي الحديث: (الصدقة أول ما تَقع في يد الرحمن) الحديث.. وإذا نَظر إلى شيء،يرى أن الناظر حقّ والمنظور إليه حقّ.. وإحذر أن تعتقد حُلولاً أو إتحاداً أو سَرياناً أو تولّداً..
(المسجد الحرام): هو وإن ورد في المسجد المحسوس،فيؤخَذ منه أن المسجد هو الحضرة الجامعة لأسماء حضرة الألوهية،فهي مَحلّ سُجود القلب لا سجود الأجسام.. وهو (حرام) عن أن يدخُله قلب لم يتجرّد من مُحيط النفس ومُحيط الأكوان..
(وحيثما كنتم فوَلّوا وجوهكم): أي حيثما كنتم في عاداتكم وعباداتكم،شاهدوه في كل مأكول ومَشروب ومنكوح،وعلى أنه الشاهد والمَشهود..
== (الموقف الواحد والخمسون بعد المائة) ==
قال الله تعالى،حاكياً قول موسى للخضر: (هل أتّبعك على أن تُعلمن مما عُلّمت رُشداً) [الكهف: 66].
إعلم أن المُريد لا ينتفع بعلوم الشيخ وأحواله،إلا إذا إنقاد له الإنقياد التامّ،ووَقف عند أمره ونَهيه،مع إعتقاد الأفضلية والأكمليّة. ولا يُغني أحدهما عن الآخر..
كان موسى،أولاً،ما عَلم أن إستعداده لا يقبل شيئاً من علوم الخضر. وأما الخضر فإنه عَلم ذلك أوّل وَهْلة،فقال: (إنك لن تستطيع معي صبراً).. فبعد الفعلة الثالثة من الخضر،تبيّن لموسى أنه ليس فيه قابلية لحَمْل شيء من علوم الخضر،فطلب الفراق بسؤاله ثالثاً. كانت الأولى من موسى نسياناً،والثانية شَرطاً،والثالثة عَمْداً..
وعندما أزْمَع الفراق ووَقفا للوداع،قال الخضر لموسى: (أنت على علم عَلّمك الله،لا ينبغي أن أعلمه. وأنا على علم علّمني الله،لا ينبغي لك أن تعلمه). يُريد: أنت على علم الرسالة،وملاحظة الأسباب في الأفعال والتّروك،والحُكم بالشّاهد واليَمين،والإقرار والإنكار،ونحو ذلك من الوقوف مع ظواهر الأشياء ــ مأمور بسياسة بني إسرائيل والتنزّل لعقولهم،فلا ينبغي لي أن أعلمه،بمعنى لا فائدة لي في العلم به،إذ العلم المُتعلّق بالأكوان إنما يُراد للعمل به،وأنا مأمور بالحُكم بخلافه وهو: الحُكم بالكَشف،ومُلاحظة الأمور والأسباب الغائبة،وبما يَرد على القلب من الخواطر الربانية التي لا تُخطئ،فلا ينبغي لك أن تعلمه لأنك مأمور بالحُكم بخلافه.
وهذا الإختلاف بينهما إنما هو في العلوم المتعلّقة بالأكوان. وأما العلم بالذات العليّة والصفات الإلهية،فكل منهما على غاية الكمال،كما يَليق بمقام النبوة وبمقام الولاية العظمى،مقام الأفراد،وهو للأفراد،والخضر منهم..
فأكمليّة الشيخ في العلم المطلوب منه،المقصود لأجله،لا يُغني عن المريد شيئاً،إذا لم يكن مُمتثلاً لأوامر الشيخ،مُجتنباً لنواهيه.. وإنما تنفع أكمليّة الشيخ،من حيث الدّلالة الموصلة إلى المقصود. وإلا قالشيخ لا يُعطي المريد إلا ما أعطاه له إستعداده،وإستعداده مُنطَوٍ فيه وفي أعماله.. وعدم إمتثال المريض،دليل على أن الله تعالى ما أراد شِفاءَه من عِلّته..
== (الموقف الخامس والخمسون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (يا أيها الناس اتّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء) [النساء: 1].
(خلقكم من نفس واحدة): حقيقة واحدة،هي الحقيقة المحمدية،المُسمّاة بالعقل الأول وبالقلم الأعلى. فالمخلوقات كلها منها،إلى غير نهاية،فهي الأصل والمنبع،فهي ذرّات العالَم،والعالم جمعيّة الحروف المُستخرجة منها،سواء المخلوقات الروحانية والجسمانية،الطبيعية والعنصرية.
(وخلق منها زوجها): الواو لا تُفيد ترتيباً،فإن خلق الزوجة مُقدّم،وهي النفس الكُليّة المُسماة باللوح المحفوظ،خَلقها منه،كما خلق حواء من آدم. يقول الشيخ محيي الدين: [النفس خَطْرة من خَطرات العقل الأول،وهي مَحلّ تفصيل ما أجمل في العقل الأول من العلوم].
(وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء): فَرّق ونَشر في العالم العلوي والسفلي منهما،من النفس الواحدة وزوجها،رجالاً كثيراً،أرواحاً كثيرة فاعلة،ونساءً،نُفوساً جسمانية طبيعية مُنفعلة.. فكل روح أب،وكل جسم أمّ. ولما كان الروح،الذي هو الأب،لا يتعيّن من الروح الكُلّي،الذي هو النفس الواحدة،إلا بعد تَسوية الجسم،الذي هو الأمّ،وتَعديله،كما قال تعالى: (فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي) ــ صَحّ أن يُقال الجسم والد للروح..
== (الموقف السابع والخمسون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (وقال اركبوا فيها) [هود: 41] الآيات.
قال نوح ــ العقل ــ الذي هو وزير الروح ومُدبّر مملكته الإنسانية،لمّا خاف هَلاك مملكة الخليفة،عندما فارَ تَنّور الهَوى بالإفساد وإيقاع الإختلاف في المملكة،لمَن أطاعه وإتّبعه: (اركبوا فيها) في سفينة الروح الجامعة بين الشريعة والحقيقة،فإنها المُنجيّة من كل هَلاك،فاسمتسكوا بها،وليس ركوبها إلا طاعتها وإتباعها فيما تدعو إليه: (بسم الله مُجراها ومُرساها)..
(وهي تجري بهم في موج كالجبال): هي أمواج الأكوان،تجري من كون إلى كون،من عالم إلى عالم،من موطن إلى موطن. وشَبّه الأمواج بالجبال لأن خروج النفس والجوارح عن الأكوان والمألوفات أثْقَل عليها من حَمْل الجبال.
ونادى نوح العقل إبنه الهوى،سمّاه إبناً شَفقة عليه ورحمة. وكان الهوى في مَعزل عن الروح والعقل،فإنه ضدّ الروح،المُنازع له،الثائر لطلب أخذ المملكة من يده،المُفسد عليه صَلاح زوجه: (اركب معنا ولا تكن مع الكافرين) أطِعْ الروح وانْقَدْ له وكُن معه،ولا تكن مع السائرين الجاحدين فَضْل الروح وشَرفه وسَعادته.. قال الهَوى: (سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) سأتعلّق بكون من الأكوان العظيمة،يُنجيني من الهلاك،كما قال الفيلسوفي: [أسْلُك من عالَم العناصر إلى عالَم العقول والطبيعة] فذلك عنده النجاة وبه يحصُل السعادة..
فقال نوح العقل،لكمال معرفته ونُفوذ بَصيرته: (لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحِمَ) لا يُنجي من غرق الأكوان وطوفان الأغيار،كون من الأكوان،وإن عَلا وعظُم،فإن الكون كلّه مُمكن،فقير عاجز،فلا يَعصم كون من كون.. فلا نجاة لمن تعلّق بالغير والسّوى،وإنما تحصُل النجاة والسعادة لمن تعلّق بالله تعالى وإنحاش إليه،وأفرد التوجّه إليه والتوكل عليه،فرحل من الأكوان إلى مُكوّنها..
(وحال بينهما الموج): فعَرج الروح بمن أطاعه وتعلّق به إلى حضرة الصفات وبَحبوبة الذات،فنجوا وسَعدوا سعادة الأبد. وبَقي الهوى ومن أطاعه في شَرَك العناصر وأسْر الأغيار: (فكان من المُغرَقين)..
== (الموقف الثامن والخمسون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) [النساء: 5].
(السّفيه)،عند العامّة،من يُبذّر الأموال ويُضيعها،ولا يُحسن التصرّف بها،فلا يضع الأموال مَواضعها المُستحقّة لها. وعند الخاصّة: السّفيه من يُبذّر الأسرار الإلهية والمعارف الربانية،فيُذيعها في غير مواضعها،ولا يَستودعها أهلها فيُضيعها..
والمال مالان: مال تَميل إليه النفوس ويُميلها،وهو المال المحسوس،مال العامة،وبه قوام النفوس،فلا بقاء لها بدونه. ومال تَميل إليه الأرواح ويُميلها إليه،وهو المال المعنوي،مال الخاصّة.
(التي جعل الله لكم قياماً): أي قَواماً وحياة لأرواحكم،إذ لا بقاء للروح ولا حياة إلا بالعلم الربّاني. أما السالك المبتدئ،فلا أضَرّ عليه ولا أسرع بالهلاك إليه من إفشاء ما مَنحه الله تعالى من أسرار التوحيد مطلقاً،لأهله ولغير أهله،إلا لشَيخه.. وقد شاهدنا في زماننا من المريدين من سَمع بعض أسرار الألوهية وبعض الحقائق من مشايخهم،فصاروا يتكلّمون بها في المجالس العامة،وظهرت منهم أمور فظيعة من الجسارة والقَباحة والتهجّم على الحناب الأعلى الإلهي،والتكلّم بكلمات ما عرفوا لها أصلاً ولا ذاقوا لها طعماً. بل نظنّ أن مشايخهم إنما تلقّفوها من الكتب أو من غيرهم،وما ذاقوا لها طعماً ولا عرفوا لها حقيقة،إذ لو عرفوا حقيقتها لصانوها وشَحّوا بها،كما شحّوا بالذهب وأمور الدنيا التي عرفوا حقيقتها..
والقوم ما ألّفوا في الحقائق وأذاعوا أسرار التوحيد،وكَشفوا بعض أستار الربوبية،إلا لأصحابهم ومن سَلَك طريقهم،ممّن عرفوا فيه الأهليّة والثبات على الكتاب والسنة. وما ألّفوها للعامّة الهَمج الرّعاع،ولا تكلّموا بها في المجالس العامة كما هو الآن،يتكلّم المشايخ الجُهّال بالكلمة من الحقيقة،يتبجّح بها،فيتلقّفها منه من هم أجهل منه ويُطَيّرونها كل مَطار بغير علم،فضلّوا وأضلّوا..
(وارزقوهم فيها): أي ذَوّقوهم من حَلاوتها وأسقوهم من رَحيقها. (واكسوهُم) من حُلَلها المعنوية وأثوابها العَليّة،ولباس التقوى ذلك خير،ليَشتاقوا إلى الخروج من الحَجْر والتصرّف والإنتفاع بتلك الأموال من غير واسطة فيها،أي في المدّة التي هم فيها تحت نظركم وفي حُجوركم.
(وقولوا لهم قولاً معروفاً): خاطبوهم بما هو قريب لأفهامهم،لا يُحيّر عقولهم،ولا يُدخل عليهم شُبَهاً في عقائدهم. وكونوا ربانيين،عَلّموا الناس بصغار العلم قبل كباره،وذلك بالإشارات التلويحات وضرب الأمثال،حتى تأنَس عقولهم،ولا تُكافحوهم بصريح الحقيقة فيَهلكوا..
(وابتلوا اليتامى): اليتيم هو من عَرف منه أستاذه،بالفراسة النورانية،الإستعداد والقابليّة،وأنه يكون منه رجل فيما يأتي.. وكل من إدّخَر له أبوه،العقل الكُلّي،كَنزاً في إستعداده،مُخَبّأ تحت جدار جسمه،فهو يتيم.. إختبروهم،مرّة بعد مرّة،بالإشارات وقرائن الأحوال،لتعرفوا ما إزدادوه من الأحوال الشريفة.
(حتى إذا بلغوا النكاح): أي أوان أن يحصُل من نكاحهم نتيجة،وتوجد ثَمرة. بمعنى خَرج ما كان فيهم بالقوة والإستعداد،إلى الفعل والظهور،وصلحوا لأن ينكحوا،وصاروا للبَذر فيهم. فالشيخ له رُتبة الفاعلية،والمريد له رتبة القابلية والمَفعولية. فالشيخ رجل،والمريد زوجة.
(فإن آنستُم منهم رُشداً): أبْصَرتم بفراستكم النورانية،رُشدهم وبلوغهم أشدّهم،وأنهم قدروا على إستخراج كنزهم: بأن صاروا يقبلون الأسرار التوحيدية،ويتلقّونها بنفوس زكيّة طاهرة،وقلوب مطمئنة ثابتة على الأمر والنهي الشرعي،وإتباع الكتاب والسنة،لا بقلوب زائغة ونفوس ضالّة..
(فادفعوا إليهم أموالهم): الأسرار التوحيدية والمعارف الإلهية،ولا يجوز لكم حينئذ أن تُمسكوا عنهم شيئاً ينفعهم،ويكون زيادة في أحوالهم،إلا ما لا إذن فيه مطلقاً.
== (الموقف التاسع والخمسون بعد المائة) ==
ورد في الحديث: (أهل القرآن: أهل الله).
المراد بأهل القرآن: أهل االتوحيد الخاص،أصحاب تجريد التوحيد ومقام التّفريد.. وأهل الله،هنا،القريبون منه القُرب المعنوي،المُقرّبون عنده.. وهو مقام النبوة والولاية الكمالية..
والقائمون به: هم الدّاعون إلى معرفة الله تعالى وتوحيده،على طريق الصوفية،أهل الحقيقة والسلوك إلى الأحوال،من الفناء والبقاء والسكر والصحو،ونحوها،وقطع عقبات النفوس وطَيّ المقامات إلى الذروة العليا،والوصول إلى الوحدة الذاتية،وهو القرآن الكريم العظيم. وهؤلاء الحَملة،حاملون أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومُقابلهم: أهل الفُرقان،فهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم،الدّاعون إلى إقامة الشرائع الظاهرة،والسلوك على سبيل السنّة المُطهّرة،التي هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ظاهراً،والمشي على طريق أصحاب المعاملات. وهذه مرتبة الرسالة،والقائمون بها هم المجتهدون مطلقاً،أصحاب المذاهب..
فإذا دخل رسول الله حضرة الذات،دخل حملة القرآن،أهل الله،من ورائه. ودخل حملة السنة،أهل رسول الله،من ورائهم بالتبعيّة له صلى الله عليه وسلم،حيث إنهم ما دخلوها بأنفسهم..
فالفرق بينهما الذّوق وعدمه: فأهل الله كانت لهم حضرة الذات والصفات ذَوقاً. وأهل رسول الله كانت لهم حضرة الذات علماً لا ذوقاً،وحضرة الصفات ذوقاً. ولا شكّ أن الذّوق أشرف من العلم بغير ذوق. ولا يُفهَم من هذا أن من كان من حملة القرآن أهل الله،لا يكون من حملة الفرقان أهل رسول الله،وبالعكس،كَلاّ وحاشا،فإن كلاّ منهما من عند الله: (نَزّل الفرقان)،(إنا أنزلناه قرآناً)..
فإن حامل القرآن،إذا لم يكن من حَملة الفُرقان،كان زنديقاً مُلحداً مارقاً من الدين،فكيف يكون من أهل الله؟. وكذا حامل الفرقان،إذا لم يكن من حملة القرآن،كان فاسقاً فاجراً عاصياً. فلا فرق بينهما إلا ما ذكرنا. وكان الأمر هكذا في الصدر الأول،فلما طال الأمَد وبعُد زمن النبوة والخلافة،وإنتشرت الأهواء،صار الأمر أمرين والحزب الواحد حزبين،وضُرب بينهما بسور: فتَسمّى أهل القرآن ب”أهل الحقيقة والصوفية والفقراء”،وتسمّى أهل الفرقان ب”أهل الشريعة والعلماء والفقهاء”. فتباينوا،إلا من رحم ربّك.
== (الموقف الرابع والسبعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (أفَغير الله تَتّقون وما بكم من نعمة فمن الله) [النحل: 52_53].
نَفْي وإنكار على من يَتّقي ويَخاف غير الله.. فإن غير الله لا يَملك ضرّاً،فلا يُتّقى،مع أنهم في نفس الأمر ما إتّقوا إلا الله،ولكن إلتبس عليهم الأمر. إذ لا غَيْر أصلاً لوحدة الحقيقة،والغَيْران أمران وجوديان،لا إشتراك بينهما في صفة النفس. وهذا شيء لا وجود له في مَشرب التّحقيق.
فالأغيار أوهام وتخيّلات،لأن الوهم من حقيقته أن يُنْزِل النّسب والإعتبارات والإضافات،التي لا وجود لها،منزلة الحقائق المعقولة والمحسوسة.
فجَهلوا جَهالَتين: جهالتهم بالله وعَدم معرفته،وجهالة إتّقاء الغير مع إعتقادهم أنه غير. ولو عرفوا لإتّقوا الله في مظاهر أسمائه الإنتقامية،وهي مُقَدّراته ومُصَوّراته ومُكَوّناته،التي جعلها مَحالّ لأن يخلُق الضُرّ عندها وبها..
== (الموقف الخامس والسبعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (قل أعوذ بربّ الناس) [الناس: 1].
(الربّ): إسم للمرتبة الجامعة للأسماء: المُتعلّقة بالحق والخَلق،والمُختصّة بالخَلق.
فالمُتعلّقة بالحق والخلق،كالعليم والسميع والبصير،فإن علمه يتعلّق بذاته وبمخلوقاته،وكذا سمعه وبَصره ونحو ذلك.
والأسماء المُختصّة بالخلق هي أسماء الأفعال،كالخالق والمُصوّر وأمثالهما،فإنها لا تعلّق لها بالحق تعالى.
والربّ والمَربوب أمران مُتلازمان،تلازُم المُتضايفين والمُنتسبين،فلا يَنفكّ أحدهما عن الآخر. ربّ بلا مربوب لا يكون،ومربوب بلا رب لا يوجد..
(مَلِك الناس): المَلك إسم للمرتبة التي تحتها أسماء الأفعال،المُختصّة بالخَلق،فقط. وهذا هو الفرق بين مرتبة الربوبية والمَلكية..
فالمَلكية تحت الربوبية،كما أن الربوبية تحت الرحمانية،كما أن الرحمانية تحت الواحدية،كما أن الواحدية تحت الأحدية..
== (الموقف السادس والسبعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (وهو الخلاّق العليم) [يس: 81].
الحق خَلاّق على الدّوام،يوجد الأعراض التي هي صور،فإنها كلها أعراض سَيّالة في الزمان،كما يقول الحكماء. وكما يقول الأشاعرة: العَرض لا يبقة زمانين،فإنها لو بَقيت لإستغنت عن الحق تعالى وتَعطّلت أسماء الأفعال،وتعطيل الأسماء مُحال.
وليس للحق في هذا الخلق،إلا إعطاء الوجود لما تقتضيه حقائق الأشياء من الأحوال والأحكام،وإلا فهي ثابتة في العلم كأعيانها. فما يكون من الحق لها إلا الإيجاد،وهذا معنى قول سيدنا محيي الدين: [الأشياء ما إستفادت إلا الوجود]..
والخلق الجديد خاص بالصور المحسوسة،وأما الصور العقلية والخيالية والروحانية فهي باقية أبديّة لا يلحقُها زوال،فليس فيها خلق جديد. وهذه الصور هي النّسخة الحقيقة،المُنْتَسخة من الصورة الرحمانية المُرادة بقوله: (إن الله خلق آدم على صورته)..
العلم تابع للمعلوم في مرتبة التعيّن الأول،لأن المعلومات في هذه المرتبة غير مُتميّزة عن الذات. ولا شكّ أن العلم مُتأخّر عن الذات بالمرتبة،ضرورة تقدّم الذات على صفتها. وإن كان علمه تعالى عين ذاته،ولكن تَسميته علماً يقتضي تبعيّته. ويُطلق عليه في هذه المرتبة (علم فعلي)،من حيث أنه مبدأ تحقيق المعلوم. وأما في مرتبة التعيّن الثاني،فالمعلوم تابع للعلم،لأن المعلوم مُتميّز عن الذات لنفسه في هذه المرتبة،ويُطلق عليه (علم إنفعالي) من حيث أنه مبدأ إنكشاف المعلوم عَيناً قائماً مُتميّزاً. والإنكشاف فرع التحقّق،إذ لا ينكشف إلا مُتحقّقاً في نفسه. والعلم واحد في المرتبتين،والتعدّد نسبي.
== (الموقف الثامن والسبعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها) [الأحزاب: 72].
الأمانة هي الخلافة،كما قال تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) وهو آدم عليه السلام. أو معناها: التحقّق بجميع الأسماء الإلهية،فهو الإله في صورة آدمية،من غير حلول ولا إتحاد ولا إمتزاج،فأنا بريء من ذلك كله.
وعَرضها على السماوات والأرض والجبال،ليس لحَملها بالفعل،لأنها لا إستعداد لها لحمل الخلافة،والحَمْل بغير إستعداد مُحال. ولكن ليُظهر فضل الإنسان وشَرفه،حيث أبَت السماوات والأرض والجبال من حَملها،وأشفقن منها،لعلمها أن حاملها لا بد أن يظهر بالأضداد،ويوصَف بالأنداد،ويُشارك الحق تعالى في المملكة. إذ حامل الأمانة،بمعنى الخلافة،ربّاً صغيراً. فخافت من قبول الأمر،فإختارت السّلامة وأعرضت عن الربح حَذَر المَلامَة..
(وحملها الإنسان): الكامل بالفعل،لا مطلق المُسمّى إنساناً. إذ مُسمّى الإنسان: منه ما هو إنسان بالفعل والحقيقة،ومنه ما هو إنسان حيوان،إنسان بالقوة والصورة فقط.
(إنه كان ظلوماً جهولاً): (ظلوماً): كثير الظلم لنفسه،وهذا مدح له لأنه من المُصطفين الأخيار،كما قال تعالى (ثمّ أورثنا الكتاب) كتاب الوجود،الكتاب المسطور،(الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه) لا ظالم نفسه،فبين الظالم لنفسه والظالم نفسه فَرق،الأول ممدوح والثاني مذموم..
(جهولاً): كثير الجهل بنفسه وبربّه،لمعرفته بالأسماء الإلهية التي تتوارد عليه وتتعاقب على الدوام.. فتختلف عليه صوره لإختلاف الأسماء الإلهية،فإنها التي تتشكّل فيعرف في حال جَهله ويَجهل في حال معرفته.. وكذا جهله بربّه،لكثرة التجليات الإلهية،إذ لا يتكرّر تجلّ أبد الآبدين،ولا يُشبه تجلّ تجلّياً أبداً. فجهل العارفين هو حَيْرتهم،بحيث لا يصحّ لهم ولا يُمكنهم الحُكم على المُتجلّي بحُكم،وهو الذي سأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الزيادة منه فقال: (اللهم زدني فيك تَحيّراً)،لا حَيرة الحجاب. فكلما زاد العلم بالله تعالى زادت الحيرة والجهل،بالمعنى الذي ذكرناه. وقد قال إمام العارفين محيي الدين الحاتمي: [.. من إدّعى المعرفة بالله ولم يَحْتَر،فذلك دليل جَهله..]..
== (الموقف التاسع والسبعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: 5].
خَبر بمعنى الأمر. وهو تعليم لنا وأمر لنا أن ندعوه بهذا الدعاء.. فلا نمُرّ بالآية مُرور الحاكي لكلام الله تعالى،عن غير قصد الدعاء،بالحصول على ذلك،بل نقصد الإنشاء والطّلب.. والعبادة لغة: الخضوع والإنقياد والوقوف عند الأمر والنهي..
فأمر تعالى العبد المؤمن بسؤال ربّه أن يجعله مُشاهداً له في كل مَظهر يحصُل منه له تذلّل وخضوع وإنقياد.. ولهذه النكتة جيء بالمعمول مُقَدّماً لإفادة الحَصر،فإننا أمرنا أن نَشهد الحق في كل مَظهر،ونُعامله بحسب ذلك الظهور كما أمر تعالى. وليس ذلك برياء،فإن الرياء لا يكون إلا مع رؤية الغير،وأما رؤية الحق وشُهوده في ظُهوراته وتَعيّناته فلا رياء ولا سُمعة.
والحاصل: أننا أمرنا بطلب الخلاص من الشرك،وإفراد الخضوع والإنقياد لله تعالى،ولا يكون ذلك إلا برؤية وجه الحق في كل شيء. ووَجهه ذاتُه المُتعيّنة ببعض الأسماء.. فالعارف،خضوعه وتَذلله وإنقياده،لا يكون إلا لذلك الوجه الظاهر المُتعيّن،كما قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) بمعنى توحيد الطاعة وتخليص الإنقياد،ولا يكون إلا بهذا الشّهود..
وبمثل ما تَقدّم،أمرنا في (الإستعانة)،فنَشهد الحق في كل شيء نَستعين به،في الأسباب والوسائط..
== (الموقف البابع والثمانون بعد المائة) ==
ورد في الخبر القدسي: (ما وسعني أرضي ولا سَمائي،ووَسعني قلب عبدي المؤمن الهَيّن الوَرع).
ياء المتكلم في قوله (ما وَسعني): كناية عن الذات المطلق،وهو الشيء الذي تستند إليه الأسماء والصفات.. فالأرض والسماء لا يُطيقان التجلّي بجميع الأسماء الإلهية..
وأخبر أن عبده المؤمن وَسِعَه وأطاق تجلّيه بجميع الأسماء،بل أطاق تجلّيه المطلق. والمراد بالمؤمن: المؤمن الكامل. ف(أل) فيه للكمال،وليس إلا الإنسان الحقيقي،فهو الذي وَسع الحق لحُصوله على رتبة الإطلاق عن الصفات والنّعوت. وأعني بالإطلاق هو أن لا يكون مَغلوباً لإسم،ولا مقهوراً تحت حُكم صفة،بل له الظهور بجميع الأسماء في الآن الواحد..
والقلب الذي وسع الحق،هو قلب مخصوص،لا مطلق القلب المؤمن.. وهذا ما وَرد علينا وأعطاه لنا الكشف،وإن قال الإمامان الكبيران محيي الدين والجيلي،بخلافه بادئ الرأي..
يقول الجيلي في أول كتاب (لوامع البرق الموهن): [فهذا كتاب أذكُر فيه بعض الحضرات القُدسيّة التي إتّسعت لها القلوب المحمدية،حيث إلتحقت به في المكانة التصديقية بعروجها في أثره،مُستمسكة بما عَلمته من خبرة وخُبرة]. فهذا تصريح بأه ما وسع الحق إلا القلوب المحمدية،لا جميع القلوب..
== (الموقف الخامس والتسعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) [الكهف: 60].
في هذه القصة (قصة موسى والخضر) عدّة مسائل تتعلّق بالشيخ والمريد:
منها: أن الشيخ،ولو بلغ ما بلغ من العلم عند نفسه وعند أتباعه،وسَمع بمن هو أعلم منه،فينبغي له أن يرحل إليه ليزداد علماً ويَستفيد حكمة..
ومنها: أن الشيخ لا يرُدّ من جاءه بطلب علم،ولو عرف عدم إستعداده لما طلب،فإن الخضر عرف عدم صبر موسى أول ما لَقيه،فقال: (إنك لن تستطيع معي صبراً)،ومع هذا ما ردّه..
ومنها: أن للشيخ أن يشترط على الطالب شروطاً ويأخذ عليه عهوداً،بحسب ما يراه من المصلحة،ولهذا قال الخضر لموسى: (فلا تسألني عن شيء)..
ومنها: أن للشيخ،إذا رأى الطالب أخَلّ بشيء ممّا إشترطه عليه،أن يُذكّره الشرط والعهد،فإذا إعتذر التلميذ قَبل عُذره أولاً وثانياً. فإن الخضر قَبل عُذر موسى لما إعتذر بالنسيان،وقبل عُذره ثانياً.. وللشيخ أن لا يطرُد الطالب إذا عادَ إلى الإخلال بالشرط ثانياً،وإن لم يذكُر عُذراً،إذا رأى منه إنكساراً. فإن موسى إعتذر أولاً بالنسيان،وثانياً لم يذكر عذراً ولكنه إشترط على نفسه فقَبله الخضر. وللشيخ أن يُفارق الطالب إذا أخلّ بالشرط ثالثاً،فلذا قال الخضر في الثالثة: (هذا فراق بيني وبينك)..
ومنها: أنه يَلزم التلميذ الصبر والثبات،وعدم تزلزل العقد في الشيخ إذا رأى منه قولاً أو فعلاً خالَف فيه الحق والأمر الشرعي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَدِدْنا أن يكون موسى صَبر حتى يَقُصّ الله علينا من أمرهما)..
ومنها: أن التلميذ إذا ساء ظنّه بالشيخ فالأولى له أن يُفارقه،وبَقاؤه معه بعد تزلزل عقيدته فيه نِفاق وضَرر محض..
ومنها: أن للشيخ إذا عزم على فراق التلميذ،لإنكار التلميذ على الشيخ،أن يُبيّن للتلميذ وجه ما أنكره من الشيخ في قول أو فعل،ولهذا قال الخضر لموسى: (سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً).. وأما إذا صبر المريد حينما يرى من الشيخ ما يجهل وجه صَوابه،وما تغيّر عقده في الشيخ،فإن الله سيرحمه بكشف حجاب جَهله..
ومنها: أنه يجب على التلميذ أن لا يقول للشيخ: “لِمَ”؟،ولا “كيف”؟ في كل ما يصدُر من الشيخ من أمر أو فعل أو ترك..
ومنها: أن لمن أخذ علماً من غير طُرقه المُعتادة بين الناس،أن يُبيّن مأخذه بشرط الإضطرار إلى البيان. ولذا قال الخضر: وما فعلته عن أمري،بل عن أمر رباني وَرد على كِيّاني..
ومنها: أن العالِم الرباني إذا أنكر عليه مُتَشرّع،ليس من أهل طريقه،لا يشغل نفسه به ولا بردوده،بل يستقلّ بواجب وقته في ظاهره وباطنه،ولا يلتفت إليه. وإن كان ولا بدّ،فليقُل كما قال الخضر لموسى: (أنت على علم علّمكه الله،وأنا على علم علّمنيه الله)..
ومنها: أن للمُتشرّع الصادق المُخلص المُحتسب،أن يُنكر على الصوفي ما يُنكره ظاهر الشرع،ولكن في الأشياء المُجمع عليها،لا في الخلافيات،مع إعتقاد كمال الصوفي في الباطن.. إذ المُتشرّع طريقه أخصّ،فله أن يُنكر على الصوفي. والصوفي طريقه أعمّ،فليس له أن يُنكر على المُتشرّع..
إلى غير هذا من العلوم التي تُشير إليها هذه القصة..
__ [الموقف: 229 ]: قال تعالى،حكاية قول الخضر: (وما فعلته عن أمري) [الكهف: 82].
إعلم أن المخلوقات مُنقسمة إلى: عالَم أمر،وعالم خَلق. فلكل فرد من أفراد عالم الخَلق،حتى الذرّة،أمر يخُصّه من عالم الأمر يُدبّره. وعالم الخلق هو السبب في إيجاد عالم الأمر،من الأمر الكُلّ..
(فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي): وإن كانت “الواو” لا تقتضي الترتيب،لكنه يُحتمل أن تَسوية الصورة مُقدّمة على نفخ الروح. والذي عندي أنهما مُتلازمان،بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر. وإن ورد في الصحيح،في ذكر أطوار الخِلقة الإنسانية: نطفة،ثم علقة،ثم مُضغة،ثم يُنفخ فيه الروح. فيُحتمل أن يكون المُراد بنَفخ الروح هنا ظهور آثار الروح،وهو الحسّ والحركة والتغذّي. فعند إبتداء صورة الإنسان تكون روحها روحاً “جمادية”،بمعنى أنها لا تفعل إلا فعل روح الجماد،وهو إمساك أجزاء الصورة وجواهرها بعضها على بعض. وعندما تصير الصورة تنمو وتتغذّى،تكون روحها روحاً “نباتية”،بمعنى أنها تفعل ما تفعل روح النبات،وهو النموّ والتغذّي لا غير. وعندما يظهر في الصورة الإحساس والحركة،تكون روحها روحاً “حيوانية”،بمعنى أنها تفعل فعل الحيوان،وهو الحسّ والحركة والتخيّل. وعندما تظهر منها الآثار التي لا تظهر إلا من الإنسان،وهي الفكر والتدبير ونحوهما،فهي “إنسانية”. إختلفت أسماؤها بإختلاف ما يظهر عنها من آثار،زيادة ونقصاً،وهي واحدة لا تتعدّد في ذاتها،ولكن في صفاتها.. فصورة بغير روح لا تكون،وروح بغير صورة لا تكون،إما عنصرية أو طبيعية أو خيالية أو روحانية.. والروح لا تُدرك نفسها في غير صورة أبداً،لا دنيا ولا برزخاً ولا أخرى،ولو لم يكن لها مركب تُدبّره لإلتحقت بالعدم..
== (الموقف السابع والتسعون بعد المائة) ==
قال الله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون) [المائدة: 35].
في الآية إشارة لبيان سلوك طريق المعرفة: أمر تعالى المؤمنين بالتقوى،وهو المُعبّر عنه عند القوم ب”مقام التوبة”،الذي هو الأساس لسلوك الطريق والمفتاح للوصول لمقام التحقيق..
(وابتغوا إليه الوسيلة): أي بعد إحكام مقام التوبة بشرائطه،أطلبوا الوسيلة،وهو الشيخ الكامل بالنّسبة،العارف بالطريق وبالعلَل العائقة والأمراض المانعة،في الوصول إلى العلم بالله،الحاذق الخبير بالمعالجة والأمزجة والأدوية،وما يُوافق منها.
وقد إنعقد إجماع أهل الله: أنه لا بد من الوسيلة،وهو الشيخ،في طريق العلم بالله،ولا تُغني عنه الكتب،وذلك عند وُرود الواردات وبَوارق التجليات والواقعات،ليُبيّن للمريد المَقبول من المَردود،والصحيح من السقيم. وأما بداية السلوك فيكتفي بالكتب المُصنّفة في المعاملة والمجاهدة المطلقة.
(وجاهدوا في سبيله): أمر بالجهاد بعد الظفر بالشيخ،وهو جهاد خاص يكون بحسب أمر الشيخ وما يرسمه للمريد. فإن المجاهدة بغير شيخ لا يُعوّلأ عليها،إلا في الناذر. فليس هو جهاد واحد على طريق واحد،لأن الإستعدادات مختلفة والأمزجة متباينة،فلربما يكون الأمر النافع لزيد مُضرّاً بعمرو وبالعكس..
== (الموقف التاسع والتسعون بعد المائة) ==
حَصَل لي،أيام التوجّه،قَبْض وإستبعاد للطريق،لجهلي بنفسي وإعتقادي البُعد من ربّي. فغَيّبني الحق من نفسي،وألقى عليّ قوله: (والملائكة يُسبحون بحمد ربهم)،وقوله: (له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض)،وقوله: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودعوا الذين يلحدون في أسمائه)،وقوله: (هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مُبصراً).
أخبرني تعالى في الآيتين الأوليتين: أن الملائكة ــ مع كثرتهم التي لا يُحصيها إلا خالقهم ــ يُسبّحونه ويذكرونه. فلا تتوهّم أنك تذكُره وَحدك،فتَتدلّل بعبادتك وذكرك،فتُريد أن يفعل بك ما تُريد،لا ما يُريد.. فاعرف قدرك وتأدّب،فإن العبد يفعل ما يَليق بالعبودية،والربّ يفعل ما يليق بالربوبية..
وأخبرني في الآية الثالثة: أن لله أسماء كثيرة لا يُحصيها إلى هو: أسماء تنزيه وتشبيه،وأسماء ذات،وأسماء صفات،وأسماء أفعال. وكلها حسنى،فادعوه بها،أي إعرفوه في كل إسم تجلّى لكم به،وادعوه،لأنه المُتجلّي بأسمائه،وهي مراتب ظهوراته وتجلياته،ومن جملتها إسمه (القابض). فهو تعالى يُريد أن يتعرّف لعباده في أسمائه،فيعرفونه في كل إسم تجلّى به.. فمن عرف الحق في بعض تجلياته،في أسمائه،دون بعض،فما عرفه في مرتبة إطلاقه..
وأخبر تعالى في الآية الرابعة: أن القبض والبسط بمثابة الليل والنهار. فالقبض شَبيه بالليل،لما فيه من الإنكماش والإنقباض،وسُكون النفس بالقهر الذي نزل عليها،وتحقّقها بعجزها عن دفع ما نزل بها،فهي لا تَمرح ولا تدّعي ولا تَسترسل في الأماني والطلب. فلا حَظّ للنفس في القبض أصلاً،فلهذا كان الإنسان وقت القبض أقرب إلى السلامة وتَوفية الربوبية حَقّها والأدب معها،منه في وقت البسط. وأما البسط فهو شبيه بالنهار،لما فيه من نشاط النفس وتَسريحها بعدم حصول قاهر لها،وإسترسالها في الأماني والدّعاوى الباطلة. ولهذا كان وقت البَسط أقرب إلى العَطب من وقت القبض. قال بعض السادة: [لا يَقوم بحَقّ الأدب في البسط إلا القليل].
== (الموقف المائتان) ==
روى مسلم وغيره: (إن الحق تعالى يتجلّى لأهل المحشر في أدنى صورة من التي رأوه فيها) الحديث بطوله.
إعلم أن الناس في تحوّل الحق في الصور ثلاث فرق:
فرقة تُنكره في الدنيا والآخرة،وتُؤوّل الأحاديث الواردة في التحول في الصور إلى أمور تَليق بعقولهم،وهم علماء الظاهر.
وفرقة تُنكره في الدنيا وتُقرّه في الآخرة،تفويضاً،على مُراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يليق بجلاله تعالى،من غير تأويل،وهم عامّة السلف الصالح.
وفرقة تُقرّه في الدنيا والآخرة،من غير حلول ولا إتحاد ولا إمتزاج ولا تولّد،مع إعتقاد (ليس كمثله شيء). وهم العارفون بالله،أهل التجلّي والشهود في الدنيا. فإن كنت سالك طريقهم،فأيّ صورة أشهدك الله نفسه بها أو عندها أو فيها،فهي صورة تحوّل لك الحق فيها،من غير حلول ولا إتحاد..
التحوّل الوارد في الحديث هو لأهل الحَشر الخاص والعام منهم،فيُنكره العوامّ أولاً،لأن كل واحد منهم ما عرف إلهه إلا مُقيّداً بالصورة التي إعتقده عليها،حسيّة أو معنوية. ويعرفه الخواص،العارفون به في الدنيا،لأنهم عرفوا إلهاً مطلقاً مجرّداً عن جميع القيود والحدود،فلا يجهلونه في شيء من تجلياته،عرّفهم ذلك ذوقاً إختصّهم به..
والتحوّل في الصور،في الدنيا والآخرة،إنما هو في نَظر الناظر،وإلا فجَلّ الحق أن يتحوّل أو يتغيّر أو يتبدّل أو تحدُث له صفة لم يكن عليها..
== (الموقف الثاني بعد المائتين) ==
قال الله تعالى،في تعديد صفات السيّد الكامل صلى الله عليه وسلم: (وسراجاً مُنيراً) [الأحزاب: 46].
الإنارة لازمة للسّراج.. وكما يصحّ أن يكون (مُنيراً) صفة كاشفة،يصحّ أن يكون بمعنى “جَعل الغير مُنيراً”،فإنه وَرد مُتعدّياً ولازماً. فهو صلى الله عليه وسلم السّراج المُنير لكل سراج،أي يجعله سراجاً منيراً. وكما أن السراج المحسوس،إذا أسْرَجت منه سُرُج كثيرة،فلا شك أن ذلك السّراج الواحد كان مُتضمّناً لتلك السّرج الكثيرة كلها،فكانت فيه بالقوة،ثمّ خرجت إلى الحسّ وإنفصلت عنه بالوهم،فهي هو في الحقيقة والعلم،وهي غيره في الوهم والحُكم. فكذا الحقيقة المحمدية هي المُنيرة لكل سراج مُنير،حِسّاً ومعنى،من نبيّ ووَليّ ومَلَك وشمس وقمر ونَجم. فإنها المظهر الأول والحقيقة الكلية الجامعة. والسُرُج المنيرة كلها فيها بالقوة،وتَظهر بالفعل آناً بعد آن..
== (الموقف السابع بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد) [فاطر: 15].
خاطَب الله تعالى الناس،ويدخل معهم سائر العالَم بالأحرى.. والفقر هنا بمعنى الطلب،أي الطالبون منه ما أنتم مُحتاجون إليه،في كل نفس وحال،حال إمكانكم وعَدمكم..
والإسم (الله) في صَدر الآية،إسم للمرتبة التي له تعالى،كمرتبة الخلافة للخليفة والقضاء للقاضي،فهو صفة مشتقّ،لا إسم الذات. لأن الذي تفتقر إليه الممكنات وتطلب حوائجها منه،إنما هو المرتبة المُسماة بالألوهية،مرتبة الصفات والأسماء،التي تُنسَب وتُسند إليها جميع الآثار. فهي مرتبطة بالممكنات،والممكنات مرتبطة بها..
عَبّر الحق تعالى بالفقر في حق الناس،فعَلّمنا الأدب القولي،ولذلك فسّرنا نحن الفقر بالطّلب،حتى لا ينفر السامع لذلك في حقّه تعالى. وإن كان من هو أعلم وأفضل وأكثر أدباً (يقصد الشيخ الأكبر) عَبّر بالإفتقار في الجهتين.. غير أن بين الطّلبين والإفتقارين بوناً بعيداً،فلذا أوردت الآية بصيغة الحصر،أي أنتم الفقراء الفقر الحقيقي،لا الأسماء التي تطلُبكم لتَفعل وتُؤثّر فيكم،لأن معنى طلب مرتبة الألوهية للناس وغيرهم،إنما هو لتُظهر آثار الأسماء بظهور مؤثراتها.. وإنما كانت المرتبة طالبة للعالَم،لأن للحق كَمالين: كمال ذاتي وكمال أسمائي. فالكمال الأسمائي موقوف ظهوره على ظهور الأسماء بظهور آثارها..
(والله هو الغني الحميد): لفظة “هو” تأكيد،لأن الله هنا إسم الذات،لا باعتبار مرتبة،فهو إسم جامد غير مُشتق،أي الذات الذي هو الغيب المطلق،غنيّ عن الناس وعن جميع العوالم وعن الأسماء.. وهذا هو الكمال الذاتي والغنى المطلق. وهو تعالى في هذا الكمال الذاتي،يُشاهد جميع كمالاته الأسمائية شُهوداً علمياً غيبياً جَمعيّاً،فهي كمالات مُستهلكة في الذات غير مُتميّزة عنها،يَشهدها شُهود مُفصّل في مُجمل،كشهود النخيل الكثير والثمار والأغصان في النواة الواحدة..
== (الموقف التاسع بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (وكلّم الله موسى تكليماً) [النساء: 164].
القرآن،وهو ما بين دَفّتي المصحف،محكوم له بجميع أحكام من أضيف ونُسب إليه،وهو الله تعالى،من القِدَم والأزلية،والتقديس والتنزيه عن أوصاف المُحدثات. كما هو ذلك للمعنى النفسي القائم بالذات العليّة،حُكماً إليهاً شرعياً،لا لمُناسبة بين المعنى النفسي القائم بالذات وبين ما نقرؤه ونحفظه ونكتبه،ولا مشابهة بينهما ولا مماثلة،ولا لحلول ولا لدلالة من الدلالات..
الكلام المنسوب إليه تعالى معنى من المعاني،كالعلم ونحوه،وإنتقال المعاني عن مَحالها مُحال في الحادث،فكيف بالقديم تعالى؟ فلا ينتقل كلام أحد إلى أحد،ولا علم أحد إلى أحد،بعينه وذاته،وإنما يخلُق الله عند السامع والمُتعلّم معنى آخر يكون مثلاً كالظلّ لما عند المُتكلّم والعالِم. فهذه الظّلال التي للكلام القديم هي مدلولاته.. وكما أن الخارج إلى العقل والخيال والحسّ هي ظلال المعلومات،كذلك الخارج هي مدلولات الكلام لا عينه،فلا قديم إلا الكلام النفسي.. فالكلام النفسي ليس فيه ترتيب وتقديم وتأخير وسَبب وشرط،وإنما جاء الشرط والمشروط والسّبب والمُسبّب في الإيجاد العيني الخارجي..
الكلام الأزلي الأبدي،واحد مطلق قديم. والكلمات مُقيّدة بالزمان والمكان،متعدّدة متكثّرة متنوعة إلى معان: من أمر ونهي ونحو ذلك،وإلى أعيان وأعراض ونحو ذلك.. فكلامه تعالى واحد،وكلماته كثيرة،كما قال تعالى: (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر).. فليس الكلام النفس إلا مبدأ لإيصال مُراد المتكلم إلى المُخاطَب..
ليس الكلام إلا إظهار المَعلوم،وليس المعلوم إلا عين العلم،وليس العلم إلا عين الذات العالمة. فليس الكلام إلا ظهور الذات،فهي الظاهرة بكلامه،فكلامها وجودها،وكلماته موجوداتها،لأن الأسماء مَرائي الذات،بها تظهر وفيها تنظُر. فالمُتجلّي قديم،والمُتجلّى به له وجهان: وجه إلى المتجلّي فهو قديم أزلي،ووجه إلى المتجلّى له فهو حادث كالمُتجلّى به. ولا حلول في هذا،وإنما هو كتجلّي المعاني في الحروف والألفاظ..
كل كلام هو كلام الله،فلا كلام لغيره تعالى. إذ الكلام من توابع الوجود،فما لا وجود له إلا بالمجاز،فلا كلام له إلا بالمجاز..
ما من رسول ولا نبي ولا ولي،إلا ويُكلمه الحق بما شاء كيفما شاء: تارة بغير واسطة،وتارة بواسطة مشهودة وغير مشهودة. فإذا كلمهم بغير واسطة أو بواسطة غير مشهودة،سَمعوه بقلوبهم. وإذا كلّمهم بواسطة مشهودة،سَمعوه بآذانهم وقلوبهم. لأن الكلام النفسي مَحلّ سَماعه القلوب والأذهان،والكلام اللفظي محلّ سماعه الآذان. ويعلمون كلام الحق علماً ضرورياً،كسائر الضروريات التي لا يطرُقها رَيب ولا تردّد،بعلامات جعلها لهم في معرفة تجلياته وسَماع كلامه..
يقول الشاذلي: [وهَبْ لنا مُشاهدة تَصحبُها مُكالمة]،وقال الحاتمي: [إذا كَلّمك لم يُشهدك،وإذا أشهدك لم يُكلمك].
فالشاذلي طلب دوام المشاهدة في الصور،بحيث لا يرى إلا الله ولا يُكلّم إلا الله،ولا يكون إلا مع الله،في جميع ما يكون منه.. والحاتمي كلامه في المشاهدة التي هي غَيبة مَحض وفناء صرف،فلا تكون فيها مكالمة،لأن المقصود من الكلام الإفادة،والفاني الغائب لا يسمع ولا يُحسّ ولا يفهم،فمكالمته عَبث،ويتعالى الحكيم عن العبث. فالمشاهدة بهذا المعنى لا مكالمة فيها..
ممّا غلط فيه المتكلمون: قولهم،بعد إثبات الصفات الثبوتية والسلبية التي أثبتوها لله تعالى: (ويستحيل عليه تعالى أضدادها). مع أن الأمر ليس كذلك،فإن صفات الله تعالى لا ضدّ لها،لأن الضدّين إنما يتواردان حيث لا يخلو المحلّ عن أحدهما،وإنما ذلك في الحادث القابل للكمال والنقص. وأما الحق تعالى فإن ذاته لا تقبل النقص،فصفات الكمال الثابتة له لا ضدّ لها..
الصوفية،الذين هم سادات طوائف المسلمين،لا ينفون الصفات التي أثبتها الأشاعرة،كما نفاها المعتزلة والحكماء،ولا يُثبتونها كما أثبتها الأشاعرة. فإن قول الأشاعرة في صفات المعاني إنها موجودة في نفسها،زائدة قائمة بالذات،بحيث لو كشف لنا رأينا قيامها بالذات،يلزم منه إستكمال الذات بالزائد.. وهو تعالى كامل الذات،فمُحال إستكمال الذات بالزائد،فإن فيه نقص الذات،والنقص مُحال.. وقولهم في الصفات: لا عَين ولا غَيْر،وهو كلام لا روح له،خال عن التحقيق. ولا تُسمّي الصوفية ما يُنسب إليه تعالى من الكلام وغيره بالصفات،إلا على سبيل المُجاراة والتنزّل في مقام التّفهيم والتعليم،وإنما تُسمي ذلك بالأسماء. فإنه تعالى ما أطلق في كتبه ولا على ألسنة رسله لفظة الصفة ولا النّعت،وإنما ورد الإسم،قال تعالى: (سبح إسم ربك)،(له الأسماء الحسنى). بل نَزّه نفسه عن الصفة فقال: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون). وتسميتها أيضاً ب”النّسب”،لأن النسب أمور معقولة،لا موجودة ولا معدومة..
== (الموقف العاشر بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) [محمد: 19]. وقال تعالى: (ويُحذّركم الله نفسه) [آل عمران: 28].
مُتعلّق الأمر بالعلم إنما هو المرتبة الألوهية،فهي التي تُعلم ولا تُشهد من كل وجه. والعلم المأمور به،العلم الزائد على ما في الفطرة،لأن الأمر بتحصيل الحاصل مُحال..
(ويُحذّركم الله نفسه): مُتعلّق النّهي والتّحذير،إنما هو الذات. فإنها التي لا تُعلم ولكن تُشهد. فإذا عَلمت فلا تقل إنك شَهدت،فما كل معلوم يُشهد. وإذا شهدت فلا تقل إنك عَلمت،إذ العلم يقتضي الإحاطة،والإحاطة مُحال،فالعلم مُحال.
وكل حقيقة،العلم بها غير الجهل بها،إلا هذه،فإن الجهل بها عين العلم بها..
== (الموقف التاسع عشر بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون) [الأعراف: 156].
إعلم أن الرحمة: ذاتية وصفاتية. وكل منهما: عامة وخاصة.
فالذاتيتان هما المذكورتان في البسملة في قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم). والصفاتيتان هما المذكورتان في الفاتحة في قوله: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم).
فإسم الرحمة في قوله: (ورحمتي) أعَمّ من الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية،فإسم الرحمة يتناولهما لفظاً،أعني: الرحمة الذاتية العامة والرحمة الذاتية الخاصة. ولذا أضيف لفظة الرحمة إلى الضمير،الذي هو كناية عن الذات،الذي تُضاف الأشياء إليه ولا يُضاف هو إلى شيء،وهو غيب الغيب وحقيقة الحقائق.
وتُسمى الرحمة الذاتية ب”الإمتنانية الحُبيّة”،لأنها عبارة عن التجلّي الذاتي الأقدس،الذي كانت به الإستعدادات الكُلية للأشياء،لقبول التجلّي. فهي الوجود من حيث إنبساطه على الحقائق العلمية والأعيان الشهودية. وهذه الرحمة واحدة بالذات،متعدّدة بتعدّد النّسب والإعتبارات،والتعدّد عَيّن المُتعدّد.
وعموم هذه الرحمة شَمل كل شيء،حتى الغضب والآلام والعذاب ونحو ذلك،ممّا يُتخيّل أنه مُناف لها،لأن الكل تجلّ من تجليات هذه الرحمة العامة التي وسعت كل شيء.. ولفظ الشيء يعُمّ كل ما يَصحّ أن يُعلَم ويُخبَر عنه لغة،فبهذه الرحمة إيجاد كل موجود..
ولا يُقال في هذه الرحمة: إنها تَسع الحق تعالى أو لا تَسع،لأنها عين الوجود والوجود عين الذات،والشيء لا يَسع نفسه ولا يَضيق عنها،ومن هذا قوله: (ربنا وَسعت كل شيء رحمة وعلماً).. ولسِعَة هذه الرحمة وشُمولها،وَسعت أسماءه تعالى بظهور آثارها..
وأما الرحمة الذاتية الخاصة: فهي الرحمة الرحيمية المُقيّدة بالمتّقين وبالمحسنين،كما في قوله تعالى: (إن رحمت الله قريب من المحسنين). وهي التي أوجبها نفسه على نفسه في قوله: (كتب على نفسه الرحمة)..
الضمير المُتّصل في قوله: (فسأكتبها) عائد على الرحمة الخاصة الذاتية.. ولولا أن الأمر على ما ذكرناه،لتناقض صدر الآية مع عجزها،إذ السّعة تقتضي الإطلاق،وقوله (فسأكتبها) نصّ في التقييد،والتناقض مُحال..
وأما الرحمة الرحمانية الصفاتية العامة،فهي الرحمة التي أخرجها الحق إلى أهل الدنيا،فيها يتراحمون ويتواصلون،كما ورد في الخبر: (إن لله مائة رحمة أخرج منها إلى الدنيا رحمة واحدة) الحديث. والمائة هي أسماؤه تعالى،وأما الرحمة الرحيمية الخاصة الصفاتية،فهي التي يرحم بها تعالى من يشاء من عباده،وهي التي تتوقف على المشيئة الربانية،كما قال: (والله يختصّ برحمته من يشاء) ونحو ذلك،وهي التي يتخلّق بها المُتخلّقون ويتحقّق بها المُتحقّقون،من رسول ونبيّ ووَليّ كامل،وهي التي وصف الحق بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: (بالمؤمنين رؤوف رحيم)..
== (الموقف السادس والعشرون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (ربنا الذي أعطى كل شيء خَلقه ثم هَدى) [طه: 50].
المطلوب من الواقف على هذا الموقف،أن يُعطيه ما يستحقه من التأمّل والإنصاف،فإنها مسألة تَكسّرت في البحث عنها أظافر كثيرين..
الأشياء المُمكنة معلومة للحق تعالى،حالة عدمها،بعلم مُحيط إجمالي،في تفصيل لا يتناهى. والمشيئة المذكورة في الآية هي المشيئة الوجودية: (أعطى كل شيء) أي موجود. (خَلقه) طبيعته وإستعداده،كما في قوله تعالى: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) أي موجوداً،لا الشيئيّة الثّبوتية كما في قوله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)،وهي الشيئية المعلومة المجرّدة عن الوجود العيني.
ولحقائق الممكنات إستعدادات معلومة له تعالى،ثابتة معدومة. وكما أن عَدم الممكنات،السابق على وجودها،غير مُراد ولا مجعول،فكذلك إستعداداتها وطبائعها الكُليّة غير داخلة تحت الإرادة والجَعْل،لأنها الإقتضاءات الأسمائية الإلهية التي هي حقائق أوّل،وهذه حقائق ثواني.
والممكن،من حيث هو ممكن،بالنظر إلى حقيقة الإمكان،لا يقتضي شيئاً لذاته،فلا بدّ من مُرجّح،إذ وقوع أحد المُتساوين بلا مُرجّح مُحال،لما يلزم من التساوي وعدم التساوي. والمُرجّح لا يُرَجّح إلا بالعلم والإرادة المُتقدّمتين على التّرجيح. وبالنظر إلى كون علمه تعالى قديماً مُحيطاً،لا يقبل التغيير لإستحالته،فالممكن المعلوم،حالة عدمه،لا يقبل التغيير،لما يلزم من إنقلاب العلم جهلاً..
فلَزم من هذا: أنه تعالى لا يُعطي حقيقة وذاتاً من ذوات الممكنات،حالة إيجاده،من الأحوال والصفات،إلا ما عَلمه منه حالة عدمه،لطلبه ذلك بإستعداده وطَبعه،الذي هو مُقتضى حقيقته،إذ إنقلاب الحقائق مُحال. وصَحّ قول حجّة الإسلام الغزالي: [ليس في الإمكان أصلاً أحسن ولا أتمّ ولا أكمل ممّا كان].. فكلام الغزالي إنما هو في بيان أنه تعالى ما ظَلم أحداً من خَلقه،ولا عَدَل به عمّا عَلمه منه حالة عدمه،ولا نَقصه خرذلة ممّا طلبه بإستعداده وخَلقه وطبيعته،إن خيراً فخَير وإن شراً فشرّ.. فالقدرة تتعلّق بالممكن،ووقوع خلاف العلم الإلهي مستحيل..
[ناقش الأمير مقولة الغزالي نقاشاً مُسْهباً ومفيداً..].
== (الموقف الثامن والعشرون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون) [يونس: 55].
أي: وَعد الله حق ثابت وقوعه لمن وَعده. ولكن أكثرهم لا يعلمون،فقالوا: بحَقّية الوَعيد كذلك،وهو خطأ. لأنه تعالى يُحبّ المَدح كما ورد في الصحيح. فحيثما ذكر تعالى (الوفاء بالوعد)،فإنما ذكره للتمدّح والإمتنان. والوفاء بالوعيد ليس هو ممّا يتمدّح به،فإنه دليل الحقد والجفاء والغلظة. وليس في إخلاف الوعيد نقص،كما توهّم،بل هو عين الكمال. ولا يُسمّى خَلفاً عادة،وإنما يُسمّى عفواً وغُفراناً وسَماحة وكرماً وسُؤدداً..
والعقل،إذا نظر إلى أنه تعالى لا ينتفع بطاعة ولا يتضرّر بمعصية،فإنه غنيّ عن العالمين،لا يحكُم بعقوبة ولا مَثوبة،وإنما الشارع جاء بتعيين هذا. وهذا ترجيح لأحد الجائزين في العقل،مع توقّف ذلك على المشيئة الإلهية من غير إيجاب. ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة دليل نَصّ لا يتطرّق إليه إحتمال في عقوبة العاصي،ولا بدّ،بحيث لا يُرجى له عفو ولا سماح،ولو بعد حين،وأنه تعالى لا يُخلف وعيده. فله تعالى أن يُخوّف عباده بما يشاء من قول أو فعل.. وفي الصحيح: (فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة)..
== (الموقف الخامس والثلاثون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) [الرحمن: 19_20].
كل شيئين مُتقابلين،فلا بدّ أن يكون بينهما حاجز معقول يَفصل بينهما،بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر،يُسمى بَرزخاً. لا يكون عينهما ولا غيرهما،وفيه قوتهما معاً.. له وجه إلى هذا ووجه إلى هذا،مع أنه لا يتجزّأ ولا يتبعّض ولا ينقسم..
وبرزخ البرازخ كلّها وأجمعها: الحقيقة المحمدية،ولها أسماء متعدّدة باعتبارات وتنزّلات وظهورات،وهي هي لا غيرها. وهذه الحقيقة البرزخية هي أحد الأشياء الثلاثة التي يتعلّق العلم بها،وما عدا هذه الثلاثة فعَدم محض..
وليس البرزخ غير الخيال،فهو هو عَينه،وله أربع مرايا،وحقيقة البرزخية الخيالية في الجميع واحدة:
الأولى: البرزخ المُسمى ب”الخيال المُنفصل” وب”العَماء” وب”الحق المخلوق به كل شيء”. وهو البرزخ بين المعاني التي لا أعيان لها في الوجود،كالعلم والثبات ونحوها،وبين الأجسام النورية والطبيعية. وفيه تظهر الصور المَرئيّة في الأجسام الصّقيلة،مثل المرايا ونحوها. وشأن هذا البرزخ الخيالي العَمائي تَكثيف اللطيف المطلق،وهو الحق تعالى،فإنه من هذا البرزخ الخيالي ظهر موصوفاً بصفات المُحدثات،مَنعوتاً بنُعوتها،كما ورد في الكتب الإلهية وسُنن الأنبياء،من المتشابهات. ومنه إتّصف الممكن المُحدَث بالصفات الإلهية،كالحياة والعلم والقدرة ونحوها. فالبرزخ العمائي هو الخيال،والصور المرئية فيه هي المُتخيّلات. وفي هذه المتخيّلات ما يُرى بعين الحسّ ومنه ما يُرى بعين الخيال،كرؤية تحوّل الحرباء في الألوان التي تمُرّ عليها،فهذه الرؤية بعين الخيال لا بعين الحسّ. وذلك أن العين الباصرة لها الإدراك بعين الحس وبعين الخيال،فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل في صورة دحية الكلبي بعين الحسّ،فيعرف أنه جبريل،وأنه روح مُتجسّدة،ويراه غيره بعين الحسّ فلا يعرف أنه جبريل.. وأهل الشّهود،أرباب التخيّلات،يَشهدون العالَم مُتحولاً مُتبدّلاً مُتنقّلاً في كل لحظة،لأنهم يَشهدونه بعين الخيال.. وأهل الحجاب يشهدون العالم ثابتاً على حالة واحدة،لأنهم يشهدونه بعين الحسّ. لأن موطن الدنيا موطن النظر بعين الحس،وإنما خصّ الحق بعض الخواصّ بالنظر بعين الخيال في الدنيا أحياناً لأنهم تجاوزوا موطن الدنيا حُكماً،ووصلوا إلى البرزخ.. وصور جميع الجسمانيات هي في هذا البرزخ الخيالي صور روحانية خيالية على وجه لطيف،لا يمتنع فيه التداخُل ولا التزاحُم ولا إيراد الكبير على الصغير،بل ولا الجمع بين الضدّين.. ولا يُقال لشيء إنه مُستحيل وجوده في هذه الحضرة أبداً،ففيه تتجسّد المعاني،كتصوّر الموت في صورة كبش،وفيه توزَن الأعمال،وفيه تُجادل سور القرآن عن صاحبها،وفيه تَتروحن الأجسام الكثيفة..
الثاني: البرزخ المسمى ب”الخيال المتّصل” و”الخيال المقيّد”،ويسمى ب”أرض السّمسمة” و”أرض الحقيقة”. وهذا البرزخ الخيالي تظهر فيه الصور الجسمانية الكثيفة،التي تقبل التجزّؤ والتبعيض والخرق والإلتئام،وهي المركبة من العناصر ــ صوراً مركّبة لطيفة،لا تقبل التجزّؤ ولا الخرق ولا التبعيض،ولا يمتنع فيها إيراد الكبير على الصغير ولا تصوّر المُحال،ومنه ورد: (أعبُد الله كأنك تراه).. ومَنشأ هذه المرتبة الربرزخية الخيالية مُقَدّم الدماغ،وهي التي تُمسك صور المحسوسات عند غيبوبتها،كما يرى الإنسان مثلاً مدينة ثُمّ يغيب عنها،فإذا تذكّرها رآها كما كان يراها،فيظن أنه رآها في موضعها في غير هذه المرتبة الخيالية،وهو ما رآها إلا في هذه المرتبة البرزخية الخيالية الدماغية.
والفرق بين برزخ الخيال المُتّصل وبرزخ الخيال المُنفصل،هو أن المُتّصل يَذهب بذهاب المُتخَيِّل (إسم فاعل)،كما هو في أنواع السحر والسيميا ونحوهما،كما قال تعالى: (يُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى)،وهي لا تسعى في الحقيقة وإنما تسعى في خيال المسحور بسبب السحر لا غير. والخيال المُنفصل لا يذهب بذهاب المُتخيِّل له،فإنه حضرة ذاتية قابلة لتجسّد المعاني والأرواح دائماً.
الثالثة: البرزخ الخيالي النومي،وهو البرزخ بين الموت والحياة،فإن النائم لا حيّ ولا ميّت،بل له وجه إلى الموت ووجه إلى الحياة. وفي هذه المرتبة يرى الإنسان ربّه مُتصوّراً بصور المحدثات،ومنه ما ورد في الخبر: (رأيت ربّي في صورة شاب أمرد) الحديث، فهو من صور برزخ الخيال المُقيّد. ويرى الإنسان نفسه في مكان غير المكان الذي هو فيه.. وأمثال هذا من المُحالات المَنامية،والكل صحيح..
الرابعة: البرزخ الخيالي الذي تنتقل إليه أرواحنا بعد الموت الطبيعي،وهو المُسمى ب”الصّور” في قوله تعالى: (فإذا نُفخ في الصور)،وب”الناقور” في قوله تعالى: (فإذا نُقر في الناقور). فإنه مثل المراتب المُتقدّمة في كون صُوَره خَيالية. وكل ما نُدركه في البرزخ،من نَعيم لأهله وعذاب لأهله،فإنما يُدركونه بإدراكات هذه الصور البرزخية الخيالية،كما قال تعالى: (النار يُعرضون عليها غُدواً وعَشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب).
== (الموقف التاسع والثلاثون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد) [الإخلاص: 1_3].
(الهو): الهو،هنا،مبتدأ لفظاً ومعنى،فإنه يُشار به إلى الذات الغيب المطلق،فهو غيب الغيوب الذي لا شعور به لأحد إلا من حيث أنه لا شعور به.. فليس “الهو” هنا بضمير يُطلق على كل غائب،كما هو عند النحويين،بل هو إشارة إلى كُنْه الذات الذي لا يُعلم ولا يُدرك..
و”الهو” له إعتباران: فباعتبار التجرّد عن المظاهر والتعيّنات،يُسمى هُوية مُرسَلة ومطلقة. وباعتبار سَريانه في المظاهر وقَيّوميته لكل موجود،يُسمى هوية سارية..
ويُسمى “الذات” في مرتبة إطلاقها،بالمَعجوز عنه،فلا يتعلّق به علم من كل مخلوق. وعن هذه المرتبة أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: (وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه) الحديث. وحيث لا يتعلّق به علم في هذه المرتبة،فلا يصحّ عليه حُكم. إذ كل علم وعالِم ومعلوم،وحُكم وحاكِم ومحكوم به،إنما هو مُتقوّم بالذات. فليس هو الذات المُشار إليه ب”الهو”،فلا يُتصوّر ولا يُعلم ولا يُحكم عليه. وكما أنه لا يُعلَم،لا يُجهَل. إذ التصوّر أول مراتب العلم،والجهل لا يُراد إلا على ما يَرد عليه العلم. فلا يُقال فيه معلوم ولا مجهول،ولا موجود ولا معدوم،ولا قديم ولا حادث،ولا واجب ولا ممكن. فهو مادة العدم والوجود المُقيّدين أو المُطلقين،إذ حقيقة العدم المطلق هو الذات المُتجرّد تجرّداً أصلياً،أي غير نسبي،كما أن العدم المقيّد هو الذات المتجرّد تجرّداً نسبيّاً..
والعدم المطلق ــ وإن لم تكن له صورة علمية كالعدم المقيّد ــ فله وجود في بعض مراتب الوجود الأربعة. كما أن حقيقة الوجود المطلق هو الذات المُتعيّن تَعيّناً أصلياً،وحقيقة الوجود المقيّد هو الذات المتعيّن تعيّناً نسبياً. والتعيّن غيب مَحض في الذات المُتجرّدة: فإذا إقتضت ظُهورها بتعيّنها به،صار ما كان هو الذات العدم،هو الذات الوجود. وتُسمى الذات عند هذا الإقتضاء: “الذات الوجود”،وتُسمى القضايا “موجودات” و”مراتب”.. فهو المطلق المقيّد،المتجرّد المُتعيّن..
(الله): هنا إسم الذات الوجود المطلق. كما أن (الرحمن) إسم الذات باعتبار الوجود المنبسط على أعيان الممكنات الثابتة.
فالجلالة هنا عَلم مُرتَجل،وليس بمُشتقّ،ولا رائحة فيه للوَصفية ولا إعتبار نِسبة.. فليس هو الجلالة المُشتقّة المذكورة بعد،فإن تلك إسم للمرتبة،لا إسم للذات.. وما إنتشر الخلاف في الجلالة،إلا لعدم العلم بالفرق بين الجلالتين..
(أحد): هو إسم الذات الوجود باعتبار تعيّن،ولا ظهور لشيء من إسم أو صفة أو كون،فإنها نِسَب. والأحد،من كل وجه،لا يقبل النّسب.. فالأحدية إسم الذات الوجود المطلق عن الإطلاق والتّقييد،لأن الإطلاق تقيّد بالإطلاق.. فليس الأحد بنَعت،وإنما هو عَيْن. ولهذا مَنع أهل الله أن يكون لأحد،من مَلَك أو بشر،تَجلّ بهذا الإسم. لأن الأحدية تنفي بذاتها أن يكون معها ما يُسمى غَيراً وسِوى،وهي أول المراتب والتنزّلات من الغيب إلى المَجالي المعقولة والمحسوسة،كما أن أول التعيّنات “الوحدة”،وهي الذات مع التعيّن الأول،وهي الحقيقة المحمدية،فهي: البرزخ بين غيب الغيوب،الذات المجرّدة،وبين الكثرة النّسبية،وهي مرتبة الأسماء،وبين الكثرة الحقيقية،وهي مرتبة الأكوان..
فالأحدية مَجلى ذاتيّ،ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من الكائنات فيها ظهور..
(الله): الثانية،خبر عن المبتدأ. والجلالة هنا مُشتقّة،فهو إسم للمرتبة.. والمراتب أمور إعتبارية،ومرتبته هي حقيقته من حيث جمعها للأسماء والنّسب والإعتبارات اللاّئقة بها. وهي التي تُضاف إليها الآثار،دون الذات الوجود المطلق.. إذ لو كان التأثير للوجود المجرّد عن النّسب،لكان تأثيره إما بإيجاد مثله أو ضدّه،وكلاهما مُحال. فتعيّن التأثير للمرتبة،وهي الألوهية التي أمرنا بتوحيدها.. وهي مرتبة إعطاء كل ذي حقّ حَقّه،من الحق والخلق.. فهو يتضمّن جميع الأسماء ولا تتضمّنه،ويُنعَت بها ولا تُنعَت به. فلذا كان أحدية جمع جميع الأسماء..
فمرتبة الألوهية،التي للذات العلية،لا مِثْل لها ولا ثاني.. وأما “الضدّ” فله ضدّ من حيث أنه المعبود وضدّه العابد،وأنه الربّ وضدّه المربوب.. هذا شأن الجلالة المُشتقّة.. وأما الجلالة التي ليست بمشتقّة،فلا مثل لها ولا ضدّ،ولا تُنزّه مطلقاً ولا تُشبّه مطلقاً،قإنها عين الضدّين والمثلين..
ورد في الخبر أن سورة الإخلاص تَعدل ثُلث القرآن،ووجه ذلك: أن المعلومات مُنحصرة في ثلاثة: من وجه حقيقة فاعلة،وهي الحق الإله،وما يتعلّق به من ذات وصفات وأفعال وأحكام. وحقيقة مُنفعلة،وهي العالَم،وهو إسم لما سوى الحق تعالى. وحقيقة جامعة بين الفعل والإنفعال،وهي حقيقة الإنسان الكامل،البرزخ بين حقيقة الفعل والإنفعال.
فكل ما دَلّ عليه الكلام القديم،وهو القرآن،لا يخرج عن هذه المعلومات الثلاث. وسورة الإخلاص تضمّنت الكلام على الحقيقة الأولى،فهي ثلث القرآن لهذا.
== (الموقف السادس والأربعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (وقولوا ءامنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) [العنكبوت: 46].
القول في الآية،إشارة لا تفسير،أنه تعالى أمر المحمديين أن يقولوا لكل طائفة من طوائف أهل الكتاب: يهود ونصارى وصابئة وغيرهم،آمنا بالذي (أنْزَل)،أي تجلّى إلينا،وهو الإله المطلق عن كل تقييد،المُنزّه في عين تشبيهه.. و(أنْزِل)،أي تجلى إليكم في صور التقييد والتشبيه والتحديد،وهو هو المُتجلّي إلينا وإليكم.
فليس النزول والإنزال والتنزيل والإتيان،إلا ظهورات وتجليات،سواء نُسب ذلك إلى الذات أو إلى صفة من صفاتها. فإن الحق تعالى ليس في جهة فوق لأحد،فيكون الصعود إليه،ولا جهة لذات الحق وكلامه وأسمائه،فيكون النزول منه إلينا. وإنما النزول ونحوه باعتبار المُتجلّى له ومرتبته،فالمرتبة سَوّغت التعبير بالنزول ونحوه. والمخلوق مرتبته سافلة نازلة،والحق رُتبته عالية،رفيع الدرجات.. فالتجلّي صادر من الحضرة الجامعة لجميع أسماء الألوهية،ولا يتجلّى منها إلا حضرة الإله وحضرة الربّ وحضرة الرحمن.. وغير ممكن أن تتجلّى حضرة من الحضرات بجميع ما إشتملت عليه من الأسماء،فهي دائماً تتجلّى بالبعض وتستُر البعض ممّا إشتملت عليه.. فإلهنا وإله كل طائفة من الطوائف المخالفة لنا،واحد وحدة حقيقية،كما قال تعالى: (وما من إله إلا الله)..
وإن تباينت تحلياته،ما بين إطلاق وتقييد وتنزيه وتشبيه،وتنوّعت ظهوراته: فظهر للمحمديين مطلقاً عن كل صورة في حال ظهوره في كل صورة،من غير حلول ولا إتحاد ولا إمتزاج. وظهر للنصارى مُقيّداً بالمسيح والرهبان،ولليهود في العُزير والأحبار،وللمجوس في النار،وللثنوية في النور والظلمة. وظهر لكل عابد شيء في ذلك الشيء،من حجر وشجر وحيوان ونحو ذلك ــ فما عَبد العابدون الصور المقيّدة لذاتها،ولكن عبدوا ما تجلّى لهم في تلك الصورة من صفات الإله الحق،وهو الوجه الذي لكل صورة من الحق تعالى،فالمقصود بالعبادة واحد من جميع العابدين.
ولكن وقع الخطأ في تَعيينه.. وما ذلك إلا لتنوّع التجلّي،بحسب المُتجلّى له وإستعداده،والمُتجلّي واحد في كل تنوّع وظهور،ما تغيّر من الأزل إلى الأبد. ولكنه تعالى ينزل لكل مُدرك بحسب إدراكه،والله واسع عليم..
فإتّفقت جميع الفرق في المعنى المقصود بالعبادة،حيث كانت العبادة ذاتية للمخلوق من حيث العبادة المطلقة،لا من حيث أنها كذا وكذا. وإختلفت في تعيينه،فنحن للإله الكُلّ مُسلمون وبه مؤمنون،كما أمرنا أن نقول. وما شَقي من شَقي،إلا بكونه عَبده في صورة محسوسة محصورة..
وما عَرف ما قُلنا إلا خواص المحمديين،دون سواهم من الطوائف. فليس في العالَم جاحد للإله مطلقاً،من طبائعي ودَهري وغيرهما.. فالكفر في العالم كلّه نِسبي.. فمن لم يعرف الحق المعبود هذه المعرفة،عَبد ربّاً مُقيّداً في إعتقاده،مُحجّراً عليه أن يتجلّى لأحد بغير صورة إعتقاد هذا المعتقد،وكان المعبود الحق بمعزل عن جميع الأرباب.. وهذا من جملة الأسرار التي يجب كَتمُها عن غير أهل طريقتنا..
== (الموقف التاسع والأربعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المومنين والملائكة بعد ذلك ظهير) [التحريم: 4].
الخطاب لعائشة وحفصة.. أنظر وتأمّل أمر هاتين السيّدتين تجده أمراً إمراً،وتعلم أن لهما المكانة الكبرى،حيث جعل تعالى نفسه مُقابلتهما نُصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،مع جبريل وصالح المؤمنين وجميع الملائكة. فهل هذا إلا شيء يُذهل العقول،ولا يُبقي معه معقول؟ وكم مرّة ذكر سيدنا في الفتوحات هذه الآية مُستعظماً لها،وما كشف سرّها.
وكَشف هذا السرّ وإيضاح هذا الأمر،بطريق النّذر والإشارة،لا بالإسهاب وتفصيل العبارة،هو: أن المرأة،من حيث ما هي امرأة،مَظهر مرتبة الإنفعال،وهي مرتبة الإمكان. ومرتبة الإنفعال لها الشّرف الباذخ والمجد الراسخ،إذ لولا مرتبة الإنفعال ــ [وهي مرتبة الإمكان والقبول لتأثير مرتبة الفعل،وهي مرتبة الألوهة] ــ ما ظهر لأسماء الألوهة أثَر ولا عُرف لها خَبر. إذ عِلّة التأثير والإيجاد مُركّبة من الفاعل،وهي مرتبة الألوهة والوجوب،ومن القابل،وهي مرتبة الإمكان والإنفعال. فلذا كان الفاعل لا يفعل في المُستحيل،فإنه لا يقبل التأثير ولا ينفعل لفعل الفاعل.
ومع ما حَصّلته هاتان السيدتان من الكمال بمَظهريتهما لمرتبة أسماء الألوهة والتحقٌّ بها،فإن الكمال يكون في النساء،وليس خاصاً بالرجال.. والحق تعالى جَلّ وعَزّ أن يوصَف بالإنفعال،إلا عن بُعد،بالنظر إلى قوله: (أجيب دعوة الداع إذا دعان).
وجبريل وجميع الملائكة،ليس لهم الجَمعية التي للإنسان،ولا التحقّق بمرتبة الإنسان،ولا المظهرية لمرتبة الإنفعال.
وصالح المؤمنين،وإن كانوا يَظهرون بجميع ما إشتملت عليه مرتبة الفعل،وهي الألوهة،فيكونون مَظهراً لها،فليس لهم أن يكونوا مَظهراً لمرتبة الإنفعال التي للنساء التحقّق بها.
فلهذا السرّ كانت لهاتين السيّدتين القوة العظمى التي أشارت إليها الآية الكريمة.
== (الموقف الخمسون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (ورحمتي وَسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتّقون ويؤتون الزكاة) [الأعراف: 156].
الرحمة من الرحمان،والرحمان إسم للوجود العام الذي عَمّ كل شيء ووَسعه. والرحمة وَسعت كل شيء: (ربنا وَسعت كل شيء رحمة وعلماً).
فبالرحمة التي وسعت كل شيء،ظهر العالَم من العدم إلى الوجود. وبها إهتدى من إهتدى إلى الأعمال الموجبة لتحصيل رحمة الوُجوب،وهي رحمة خاصة لذَوي صفات خاصة. فالتوفيق لهذه الأعمال من الرحمة المطلقة والجود المطلق.
فالرحمة المطلقة على إطلاقها،وهي رحمة الإمتنان،لا بشرط شيء. ورحمة الوجوب جُزء منها..
التّقييد للممكن صفة ذاتية له،لا ينفكّ عنها أصلاً أبداً. والحق تعالى له الإطلاق الذاتي،وما بالذات لا يزول إلا بزوال الذات. والتقييد إنما عَرض للحق من عروض نسبة العالَم إليه تعالى،فلو فرض إرتفاع العالم ما كانت للحق مرتبة التقييد..
وفي قصة إبليس مع الإمام سهل التستري،لو قال إبليس كلمة واحدة لحَجّ سَهلاً أول وهلة،وذلك أن يقول: لِمَ خافت الأنبياء والرسُل،بعد تأمينه تعالى لهم وعِلمهم بسَعادتهم؟.. فلو عَلموا أن مرتبة التقييد تحكُم على مرتبة الإطلاق،ما كان منهم ذلك. فلا بدّ أن يقول سَهل ذلك،لشُهودهم مرتبة الإطلاق وسِعَة العلم. فيقول إبليس: مُشاهدة ما خَوّفهم بعد التأمين والبشارة بالسعادة،هو الذي جعلني أرجو رحمته بعد طردي وإبلاسي.. فرجاء إبليس في نَيْل الرحمة من عين المِنّة صحيح،وطمعه في مَحلّه. وقد سَلّم له ذلك الإمامان الكبيران: سَهل ومحيي الدين. وما ذكره صاحب الإبريز،عن شيخه القطب عبد العزيز الدباغ،لا يخفى ما فيه من المخالفة لما قدّمناه. ولعل الشيخ الدباغ أجاب بذلك لمُقتضى الوقت والحال..
فمهما رأيت الوجوب،فاعلم أن التقييد يَصحبه. يعني أنه لا وجوب على الحق أصلاً،من حيث حقيقة الوجوب الذي هو إلزام الغير،بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ. وإنما الأمر “رحمة إمتنانية مطلقة” وَسعت كل شيء،و”رحمة مُقيّدة” هي جُزء من الرحمة المطلقة. فما جَلب جوده إلا جوده،وما حَكم عليه سواه،ولا قَيّده غيره،فهو الذي أوْجَب على نفسه ما أوجب..
== (الموقف الثالث والخمسون بعد المائتين) ==
قال صلى الله عليه وسلم: (إنه ليُغان على قلبي) الحديث.
الغَيْن هو التّغطية واللّبْس،حسيّة أو معنوية.. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليه أحياناً شُهود عظمة الربوبية وما تقتضيه الألوهة من لوازم العبودية،باختلاف آثار أسماء الألوهة،وما تطلبه من القيام بحقوق آثارها ومظاهرها،مع تضادّ آثارها ومظاهرها. ثم ينظُر صلى الله عليه وسلم إلى ضعف العبد وعجزه،وعدم إقتداره عن أداء جزء ممّا لا نهاية له ممّا يجب عليه لربّه وإلهه. هذا مع معاناة الأضداد ومعاشرة الأنداد،والأمر بالتأليف بينهم وجَلب قلوبهم،مع تنافُر طبائعهم وتبايُن أغراضهم وإختلاف مَراميهم.. فيرى صلى الله عليه وسلم،عند هذا الشّهود،شيئاً عظيماً لا تُطيقه البشر،من حيث هي،بوجه ولا حال. فيستغفر الله،أي يطلب من الإسم الجامع (الله) الغَفْر.. فإذا سَتره الله عن هذا الشهود الإلهيّ،أشهده “الشهود الذاتي الجمعي” المُريح،وأدخله حضرة الهُوية الجامعة التي تَهْلك فيها الأسماء والآثار،ويتّحد فيها المُرسِل والرسول والمُرسَل إليه.. ثمّ باقتضاء الحكمة،حيث إنه تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعرفوه فيعبدوه. فلو بَقوا في حضرة الجمع الصّرف،ما كان هناك من يعبُده. فمن الحكمة رُجوعه صلى الله عليه وسلم عن شُهود الجمع الصّرف،وهو توبته،أي رجوعه إلى شهود الفرق الثاني،وهو شهود إله ومألوه،وربّ وعبد،وحق وخلق. وشهود هذه الحضرة هو المُميّز بين الربّ والعبد،إذ المراتب هي المُميّزة والمُفرّقة. وحينئذ يقوم بواجبات الربوبية وحقوق الألوهية. فيُعطي المراتب حَقّها،والمظاهر والآثار مُستحقّها،حسب الطاقة البشرية.. فكان صلى الله عليه وسلم،تارة تارة،بين هذين الشهودين،يتردّد بحسب العدد الوارد في الروايات. وهذه الأحوال كانت له في بداية الرسالة..
وقد أوّلنا هذا الحديث في هذه المواقف،بنَقيض هذا التأويل بوارد مُناقض لهذا الوارد،فإننا بحسب ما يَرد لا بما نُريد.. وربما في الغيب مَعانٍ أخر لهذا الحديث،يُلقيها الله على من يشاء من عباده.
== (الموقف الرابع والخمسون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو) [البقرة: 163]،(قل إنما يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد) [الأنبياء: 108]..
نحو هذه الآيات،خاطَب بها تعالى كل من بَلغه القرآن الكريم والكلام القديم،من يهوديّ ونصراني ومجوسي ووَثني وصَنمي ومَنوي وغيرهم من الأجناس والأصناف،المختلفي العقائد والمقالات في الحق تعالى. أخبرهم أن إلهَهُم واحد،وإن إختلفت مذاهبهم وعقائدهم فيه،فإنها كالأسماء له،ولا يلزم من تعدّد الأسماء تعدّد في المُسمّى..
ففي الآيات المتقدمة إشارة إلى ما تقوله الطائفة العَليّة،طائفة الصوفية،من وحدة الوجود،وأنه تعالى عين كل معبود،وأن كل عابد إنما عَبد الحق من وجه،ببُرهان هذه الآيات،وبقوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) فمُحال أن يُعبد غيره،لأن وقوع خلاف قَضائه مُحال.
وإنما هَلك من هَلك،من جهة مُخالفته لما جاءت به رسل الله من أوامره ونَواهيه.. فهو تعالى عين كل معقول ومُتخيّل ومحسوس،بوجوده الواحد الذي لا يتعدّد ولا يتبعّض. فهو عين النّقيضين والضدّين والخلافين والمِثلين،وليس في الوجود إلا هذه. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن،وليس في العالم إلا هذه. فلا تُقيّده المظاهر ولا تحصره المقالات والإعتقادات،من الأوائل والأواخر..
فتصوّره تعالى في تصوّر كل مُتصوّر،عين وجوده. ووجوده في تصوّر من تصوّره لا يزول بزوال تصوّر من تصوّره إلى تصوّر آخر،بل يكون له وجود في ذلك التصوّر الآخر.. فلا تكاد تنحصر الإعتقادات والمَقالات. ولهذا قال بعضهم: [كل ما يخطُر ببالك فالله بخلاف ذلك]. فهذه القولة لها وقع عظيم في باب الحقائق،فإن صَدرت من عارف فهو أهل لها،وإن صدرت من غير عارف فقد يُجري الله بعض الحقائق على ألسنة غير أهلها فيعرفها أهلها.. والمتكلمون القائلون بالتنزيه المطلق العقلي،غير الشرعي،يتداولون هذه المقالة بينهم،لظنّهم أنها دليل لهم على تنزيههم المطلق،وليس الأمر كما توهّموا. بل معناها عدم حَصْر الحق تعالى في قولة قائل وإعتقاد مُعتقد،وأنه تعالى كما إعتقده كل مُعتقد من وجه.. قال الذين هم من أعلم الخلق بالله تعالى: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا).
فهو تعالى المعبود لكل مخلوق من وجه،المعروف لكل مخولوق من وجه،المجهول لكل مخلوق من وجه. فما خلق الخلق إلا ليعرفوه فيعبدوه،فلا بد أن يعرفوه من وجه فيعبدوه من ذلك الوجه. فلا خطأ في العالم إلا بالنّسبة،ومع هذا مَن خالف ما جاءت به الرسل هَلَك ولا بُدّ،ومن وافَقهم نَجا ولا بُدّ..
== (الموقف الخامس والخمسون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى،حكاية عن موسى: (هل أتبعك على أن تعلمن مما عُلمت رشداً) [الكهف: 66].
في الآية إشارة إلى أن الكبير قد لا يعلم بعض العلوم التي تكون عند الصغير. وذلك فيما يتعلّق بالكوائن وحوادث العالم،لا في العلم بالله تعالى. فإن الأنبياء،أصحاب النبوة الخاصة،أعلم من الأولياء،ولو كان الوليّ من أنبياء الأولياء..
ولا خلاف بين أهل طريقتنا أن الخضر ليس نبياً،النبوة الخاصة نُبوّة التشريع،وإنما هو من الأفراد الذين لهم نُبوّة الولاية العامّة،وهم أهل مقام القُربة الذي هو بين النبوة الخاصة والصديقيّة. وأهل هذا المقام يأخذون علومهم من العين التي تأخذ منها الأنبياء أصحاب الشرائع،فلهم أن يُخبروا عن الله تعالى كما أخبرت الأنبياء أصحاب الشرائع.. فإذا رأيت في كلام بعض أهل هذا الطريق أن الخضر نبيّ،فإنما يُريد النبوة العامة التي هي نبوة الولاية،لا النبوة الخاصة التي هي نبوة التشريع..
النبوة الخاصة لها ذوق ومَشرب خاص،فإنها دعوة الخلق من التجلّي الإلهي الذي هم فيه وعليه،إلى تجلّ آخر مُضادّ لهذا التجلّي الذي هم عليه وتحت قبضته،فإن الأنبياء يأتون ليدعوهم إلى خلاف ما هم عليه،والذي هم فيه وعليه تجلّ من تجليات الحق تعالى. فإن عبادة الأوثان،مثلاً،تجلّ منه تعالى عليهم،أي العابدين،فتأتي الأنبياء لردّ الناس عن ذلك التجلّي إلى تجلّي التوحيد. فالأنبياء يُضادّون التجلي الحاضر أبداً. وهذا العلم لا ينبغي للخضر أن يعلمه،وهو قوله لموسى: (أنت على علم علمكه الله لا أعلمه).
وقول الخضر: (وأنا على علم علمنيه الله لا ينبغي لك أن تعلمه) يُريد علم النبوة العامّة،نبوة الولاية،فإنها مُوافقة التجلّي الحاضر إلى أن ينقضي وَقته،من غير مُعارضة له ولا مُنازعة،فإنه عندهم من سوء الأدب. ومعارضة حُكم الوقت عندهم من قوادح العبودية المحضة،وهم غير مأمورين بذلك. فلا ينبغي لموسى أن يعلم هذا العلم،فإنه مأمور بمُضادّة التجلّي الحاضر والسّعي في تبديله بغيره..
ولولا أن أنبياء النبوة الخاصة مأمورون بذلك،لكان الأليق والأوفَق بكمال عبوديتهم وأدبهم مع سيّدهم،مقام أنبياء الأولياء،ولكن إمتثال الأمر هو الأدب اللاّئق بهم..
== (الموقف السادس والخمسون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (قل لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا) [التوبة: 51].
كل ما يُصيب المؤمن ممّا قضاه الله تعالى وقدّره،من البلايا والرّزايا،في النفس والولد والأهل والمال،فهو له لا عليه.. فكل بَليّة تُصيب المؤمن فهي نعمة توجب عليه حَمد المُبلي تعالى،وقد ورد في الصحيح: (عجباً للمؤمن أمرُه كله خير،وليس ذلك إلا للمؤمن،نفسه تنزع من بين جَنبيه وهو يحمد الله تعالى)،وفي خبر آخر: (عجبت للمؤمن أن الله لم يقض له قضاء إلا كان خيراً له)..
وهذا خلاف الكافر،فإن كل ما قضاه وقدّره الله فهو عليه لا له،حتى ما صورته صورة نعمة،فهو نقمة عليه،ولذا قيل: (ليس لله على كل كافر نعمة حقيقية).
وهذا الذي ذكرناه في حق المؤمن عام،حتى في إبتلائه بالمعاصي والمُخالفات التي قدّرها الله وقضاها،فهي له لا عليه. وقد ورد في الخبر: (إن العبد ليُذنب الذّنب فيُدخله الجنة)،وفي صحيح مسلم: (لولا أنكم تُذنبون،لخلق الله خلقاً يُذنبون فيغفر لهم)..
وذلك لأن الذّنب سَبب في إظهار آثار أسمائه: التواب والغفّار والستّار والحليم،ونحوها.
وفي الصحيح: (إن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن). والمراد بالعبد: المؤمن. وبالأصبعين: لَمّة المَلك ولمّة الشيطان. وقد أضافهما إلى الرحمن،فلولا رحمة الله عبده المؤمن بتلك اللّمّة الشيطانية،ما حصل له ثواب مُخالفته بالتبديل والرجوع عنه إلى العمل بلمّة المَلك،وهو النّدم..
قال الله تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب). بَشّر تعالى عباده المؤمنين أنه أوجب على نفسه،تفضّلاً وإمتناناً،فإنه عبّر ب(على) وهي من أدوات الوجوب،قبول توبة المؤمنين الذين يعملون السّوء ويَعصون ربّهم بجهالة وسَفاهة وإغترار وأمان وحماقة وغلبة شهوة.. مع إيمانهم بحُرمة السّوء الذي عَملوه. ثمّ يتوبون من قريب،أي ما داموا لم تنكشف لهم أحوال الآخرة ولم يُشاهدوا ملك الموت..
وفي قوله تعالى: (وليست التوبة) هذه لأهل النفاق وأهل الشرك.. فانظُر ما أعظم حُرمة الإيمان وما أعلى مرتبته؟..
__ و(التوبة): هي الرجوع مطلقاً. وخَصّها الشارع بالرجوع: من الكفر إلى الإيمان،ومن المعصية إلى الطاعة،ومن حالة ناقصة إلى حالة كاملة،ومن حال شريف إلى حال أشرف.
وأمر التوبة عظيم،وشرفُها جسيم،ومقامها مقام كريم.. فهي مُتضمّنة لشَطر المقامات التي يسلُك عليها السالكون إلى الله تعالى،والشطر الآخر “الزّهد”..
والتائبون يرجعون من الإسم (المُضلّ) إلى الإسم (الهادي)،وكلاهما داخل تحت الإسم الجامع (الله). فتابوا من الله بوجه،إلى الله بوجه. فما كانوا خارجين عن الله،ثمّ تابوا ورجعوا إلى الله،فإن الخروج عن الله مُحال،إذ هو القائل: (والله من ورائهم مُحيط). وإنما التوبة منه إليه،فالتوبة ليست إلا إلى الله،وجاءت إلى الرب قليلاً،حيث كان العالم مُحتاجاً إلى الإسم (الربّ) أكثر من إحتياجه إلى غيره،ولأن حضرة الإسم الربّ حضرة تنزّل الشرائع والأحكام،من حلال وحرام وغيرهما،وهو أحد الأسماء الثلاثة الأمهات وهي: (الله والرحمن والربّ)..
والتوبة إلى الله إنما تكون من إسم خاص،ممّا دخل تحت حيطة الإسم الله،إلى إسم خاص كذلك.. فالعبيد في قبضة أسمائه تعالى يتردّدون،وتحت عزّة سُلطانه مقهورون.. فمن خرج عن قبضة أسماء الجلال،دخل في قبضة أسماء الجمال،والعكس،ولا واسطة بينهما ولا برزخ..
وأما عامة المؤمنين المحمديين فهم مأمورون بالتوبة والرجوع من غلبة مُشاهدة بعض الأسماء التي إشتمل عليها الإسم الجامع الله،دون بعض..
فأما المؤمن العاصي فإنه مأمور بالتوبة من غَلَبة مشاهدة أسماء الجمال،فإنه ما جَرّأه على المعصية إلا تأثير أحكام أسماء الجمال فيه،كالعفو والودود وقابل التوبة والغفار والستار،ونحوها. فأمر تعالى العاصي بالتوبة والرجوع إلى مشاهدة أسماء الجلال التي تُؤثّر خوفاً،مثل: شديد العقاب والقهار والمنتقم والضارّ،ونحوها. فإذا تاب إلى مُشاهدتها إعتدل رجاؤه وخوفه،فإستقام حاله،ففي إعتدال الخوف والرجاء النجاة..
وأما المؤمن المُطيع فإنه مأمور بالتوبة والرجوع من غلبة مشاهدة أسماء الجلال،كالحسيب والجليل والعزيز والمهيمن والرقيب والجبار،ونحوها. فإنها إذا غلبت مشاهدتها على المؤمن أثّرت فيه خوفاً شديداً،ربما أدّى إلى القنوط واليأس.. فإذا تاب ورجع إلى مشاهدة أسماء الجمال وإتّساع الرحمة،إعتدل خوفه ورجاؤه..
وأما خاصة المحمديين فإنهم أمروا بالتوبة والرجوع من الوقوف مع إسم إلهي إلى إسم إلهي،فإن الوقوف مع إسم خاص حجاب عن بقية الأسماء. والمطلوب التخلّق بجميع الأسماء التي دلّ عليها الإسم الله. فتكون توبته من الله إلى الله،وهي التوبة من حال ناقص إلى حال كامل..
وأما خاصة الخاصة فهم مأمورون بالتوبة من التوبة،فيشهدون أنه تعالى هو التائب بهم،فإن توبتهم من أفعالهم،وأفعالهم لله ليس لهم منها شيء..
وأما توبة الرسل والأنبياء،فليست من ذنب ولا من نقص،فلهذا نقول: التوبة لا تستلزم الذنب والمُخالفة لأمر الله تعالى،كما أن المغفرة الواردة للأنبياء والرسل لا تستلزمه. فليست التوبة والمغفرة مخصوصتين بما سمّاه الشارع ذنباً،فقد يكونان ممّا يراه التائب غير لائق بجلال مولاه،بحسب مرتبة التائب ومقامه.. وأكمل الخلق علماً بهذا وقياماً بمُقتضاه الأنبياء،ولهذا تراهم يتوبون ويستغفرون من أشياء هي عند الأولياء من أكبر القُربات،فعلوّ مقامهم وكمال علمهم بجلال الله إقتضى لهم ذلك..
== (الموقف الثامن والخمسون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط) [آل عمران: 18].
هذه الشهادة شهادة علم،لا شهادة شُهود ورؤية. فإنها شهادة بالألوهة،والألوهة تُعلَم ولا تُشهد،فإنها مرتبة الذات. والمراتب أمور معقولة،وإنما المشهود آثارها. فالألوهة مشهودة الأثر مفقودة في النظر،تُعلم حُكماً ولا تُرى رَسماً. بخلاف الذات،فإنها تُشهد من بعض وجوهها ولا تُعلم علماً إحاطياً. فإن العلم يقتضي الإحاطة بالشيء من جميع جعاته،والذات مطلق،والمطلق إذا عُلم لا تُعلم حقيقته،وإنما يُعلم بعض وجوهه وإعتباراته. فالذات مَرئية العين،مجهولة الأين. تُرى عياناً،ولا يُدرك لها بيان. ألا ترى أنك إذا رأيت رجلاً،مثلاً،تعلم أنه موصوف بأوصاف متعددة،فتلك الأوصاف إنما تُدركها بالعلم والإعتقاد أنها فيه،ولا ترى لها عيناً. وأما ذاته فإنك تراها بجملتها،ولكن تجهل ما فيها من بقية الأوصاف.. فالذات مرئية،والأوصاف مجهولة. والوصف لا يُرى،وإنما المَرئيّ أثرُه. فلا يرى من الشجاعة إلا الأثر وهو الإقدام،ولا من الكرم إلا البذل..
والملائكة،عباد الله المُكرمون،علمهم بالألوهة ضروري لا مكتسب بدليل بُرهان. وأولوا العلم: الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنون.
وهؤلاء الثلاثة شَهدوا بثلاثة أشياء:
أولها: إثبات الألوهة للذات،المُشار إليها بالهو،إشارة إلى كُنه الذات باعتبار أسمائه كلها.. ومعنى قوله: الهُوية غيب،أنها لا تُدرك،لا أن للحق غيباً وشهادة مثل المخلوقين.. فقوله (هو) عين قوله (أنا)،باعتبار شُمول ظهوره لبطونه وبطونه لظهوره،فإنه القائل: (إنه أنا الله).. وهذا معنى قولهم: ظاهر الحق عين باطنه وباطنه عين ظاهره،من جهة واحدة،لا أنه باطن من جهة وظاهر من جهة أخرى.
ثانيها: الشهادة بوحدة الألوهة التي شهدوا بثُبوتها للذات الإله. والعلم بوحدة الإله هو المأمور به في الكتب الإلهية والأخبار النبوية،وما بُعثت الرسل إلا به ولأجله.. وأما الذات فما ورد فيها كلام عن الله ولا عن رسله،بل ما تكلّم الحق فيها إلا بالنّهي عن الخوض فيها وطلب معرفتها،قال تعالى: (ويُحذّركم الله نفسه)،وجاء في الحديث: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته). وآلاؤه هي آثار أسمائه الفعلية،وهي أحد أقسام أسماء الألوهة..
ثالثها: قيامه بالقسط،أي العدل. بمعنى أنه لا تفاوت في قيّوميته التي هي عين ذاته بين مخلوقاته.. ومع هذا فلا يظهر من آثار قيوميته تعالى على كل مخلوق إلا بقدر إستعداد ذلك المخلوق.. فالألوهة مرتبة إعطاء كل ذي حق حقه،من الوجود والعدم والحق والخلق..
== (الموقف التاسع والخمسون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى،حكاية عن أهل النار: (ياليتنا نُردّ ولا نُكذّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو رُدّوا لعادوا لما نُهوا عنه) [الأنعام: 27_28].
معنى الآية: إشارة لما تداولته الصوفية بينهم من القول بالإستعداد والقابلية. والإستعداد عند الطائفة العليّة،هو الإستعداد للوجود بشرط كذا وكذا،له لوازم وتوابع هي داخلة فيه وتابعة له،كاللّوازم البيّنة عند المناطقة. فيكون كأنه جزء من الماهية والحقيقة،فلا بدّ من حصوله.. وهذا هو الإستعداد الكُلّي الذّاتي،لا الإستعداد العرضي الجُزئي..
والإستعداد والقابلية والتهيّؤ والقبول للشيء المُستعدّ له،تَرد بمعنى واحد. وينفرد الإستعداد بالطلب الإستعدادي،فإنه يطلب المُستعدّ له طلباً حثيثاً.. والعمل في رفع الموانع وحُصول الشّرائط لحُصول ما هو مطلوب بالإستعداد الكُلّي الذاتيّ،هو الإستعداد الجزئي..
مثلاً: كل إنسان ــ من حيث إنسانيته وحقيقته ــ مُستعدّ،بالإستعداد الكُلّي،إلى ظهور الصورة الإلهية فيه. ولكن قد يتوقّف حصول هذا التجلّي على رفع موانع وحُصول شرائط. فخوض السالك لطريق أهل الله،في الرياضات النفسية والمجاهدات البدنية ومعانقة الآداب الشرعية،لرفع الموانع الطبيعية والإقتضاءات الشهوانية النفسية. وتحصيل الشرائط بتصفية محلّ التجلّي وتنويره بالأذكار،ومُواصلة الإعتبار،والتعرّض لنفحات الحق تعالى بالأسحار ــ هو الإستعداد الجُزئي العَرضي..
فعبّر ب”القابلية” عن الإستعداد الكُلّي الذاتي،وب”الإستعداد” عن الإستعداد العرضي الجزئي.
والإستعدادات الكُليّة الذاتية غير مجعولة،فلا توصف بالخَلق،فلهذا هي لا علّة لها،ولا يُقال عليها: “لِمَ”؟ لأنها حَصلت في العلم الذاتي بالتجلّي الذاتي المُعبّر عنه ب”الفيض الأقدس”،من غير تخلّل إسم من الأسماء ولا صفة من الصفات،كالإرادة والقدرة والإختيار. وهي محصورة في كُلّيات أربع،كما ورد في الصحيح: (الرزق والأجل والشقاوة والسعادة). وجميع ما يطرأ على الإنسان،فهو من توابع هذه الأربعة ولوازمها.. والمَجعول والمخلوق،هو الإستعداد الجزئي العَرضي،وهو الذي يُعلّل ويُعتبر وَزنه بالميزان الشرعي. والتعمّل بالإستعداد الجزئي قد يُفيد في حصول المُستعدّ له،إذا وُجدت الشروط وإنتفت الموانع جميعها. وقد لا يُفيد لنقص بعض أو بقاء بعض الموانع خَفيّة عند هذا.. وإن كان هذا أيضاً من مراتب الإستعداد الكلي،فإنه هو الذي إقتضى هذا العمل الذي يحصل به المطلوب..
والإستعدادات الكُليّة غيبية وخَفيّة عن المُستعدّ وغيره،فلا يطّلع عليها إلا من أطلعه الحق تعالى على الأعيان الثابتة في العلم الأزليّ،وذلك خاص بالأبدال السبعة،وهم: (الأفراد الأربعة والقطب والإمامان). وأما العموم،فإنما يُدركون الإستعدادات الجزئية فيقولون: فلان مستعدّ لكذا..
والذي أعطى المرتبة العالية مع عدم الكمالات،أعطاه إستعداده الكُلّي الذي هو غير مُتوقّف على وجود شرط لا مانع له. وهكذا هو الأمر في جميع الناس،من علم وغنى وعِزّ وجاه ومراتب دنيوية وأخروية،فتحصل لمن لا إستعداد عرضيّ له في تحصيلها،ولا تحصل لمن له إستعداد عرضي جزئي في تحصيلها.. فما أعطى تعالى كل أحد إلا ما أعطاه إستعداده الكُلّي الذي هو كجزء من حقيقته،وما منعه إلا ممّا لا يقبله إستعداده لو أعطاه إياه،فإن الحق تعالى جواد لا يبخل..
ولهذا الإستعداد الكُلّي الذاتي الكامن في العباد،أشار صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس،حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر أو ذراع،فيَسبق عليه الكتاب) الحديث.. وهذا من سِرّ القدر الذي منع الله عباده من الإطّلاع عليه،ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال عنه والخوض فيه..
== (الموقف الواحد والستون بعد المائتين) ==
ورد في الحديث القدسي: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري،من نازعني واحداً منهما قَصمته) رواه مسلم.
إعلم أن الكبرياء والعظمة حَضرتان،أو قل مرتبتان للحق صلى الله عليه وسلم،ثابتتان له تعالى شرعاً وكشفاً. فمن نازعه ليَنزع عنه واحدة منهما وينفيها عنه ويَسلبه منها،قصمه تعالى وأهْلِك بالجهل،فإنه لا هَلاك أهْلَك من الجهل به تعالى.
ف”الكبرياء حضرة التشبيه” الواردة في الكتب الإلهية والأخبار النبوية،المسماة عند المتكلمين بالصفات السمعية. ولذا شَبّهها بالرّداء،فإن الرّداء ظاهر محسوس،وهو حجاب على المُرتدي. وقد ورد في الصحيح: (وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)..
و”العظمة حضرة التنزيه”،فإن العظمة إنما تقوم بنفس المُعَظِّم (إسم فاعل) للمُعظَّم (إسم مفعول)،وكذلك التنزيه إنما يقوم بنفس المُنزّه له تعالى. وشَبّهها بالإزار لكونه مَستوراً بالرّداء،وكذا حضرة التنزيه فإنها مستورة بالعدم..
فهاتان الحضرتان (مرتبتي التنزيه والتشبيه) ثابتتان له تعالى،كتاباً وسنة وكشفاً. فمن نازع الحق لينزَع عنه رداءه،وهو حضرة التشبيه،بأن يكون مُنزّهاً فقط،وهو المُقتصر على مَدارك العقول،كالحكيم والمتكلّم الصّرف النافيين حضرة التشبيه.. فإله الرسل مطلق مُشبّه مُنزّه،وإله العقول مُحجّر عليه مُنزّه فقط.. فمن كان مُنزّهاً فقط،أو مُشبّها فقط كالحلولية والإتحادية،والآخذين بظواهر الإخبارات الإلهية والنبوية ــ فذلك هو الذي نازع الحق في كبريائه وعَظمته،وهو الذي توعّده الحق وأخبر أنه يَقصمه..
وهاتان الحضرتان يَظهر بهما الحق في المُسمّى “غَيْر أو سِوى”،فإن التنزيه إنما يظهر أثره في المُنزّه (إسم فاعل)،وكذلك العظمة. فالمَلِك عنده كآحاد الناس،لا عظمة له،فإذا عَرف أنه مَلك قامت له في نفسه عظمة فعظّمه لذلك وبَجّله. فلو كانت العظمة قائمة بالمَلك لعَظّمه كل من رآه بمجرّد الرّؤية،وليس الأمر كذلك،فالعظمة إنما تظهر في العارف بمقام معروفه وبما يستحقّه من الإعظام والإجلال..
قال تعالى: (وله الكبرياء في السموات والأرض) فأخبر تعالى أن مَحلّ كبريائه السماوات والأرض،وما جعل نفسه محلّ الكبرياء. فالمحلّ هو الموصوف بالكبرياء،فهو تعالى مُنزّه عن قيام الكبرياء به والعظمة. وهو تعالى العزيز،أي المنيع،لذاته أن يكون محلاً لما هي السماوات والأرض له محلّ. فاعرفه فإنه نَفيس،ما عرفه حكيم ولا متكلم.
== (الموقف السادس والستون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (فسيرى الله عملكم) [التوبة: 105].. (قل كل من عند الله) [النساء: 78].. (والله خلقكم وما تعملون) [الصافات: 96]..
إلى غير هذا من الآيات الواردة في: نسبة الفعل إلى المخلوقين وَحدهم،أو نسبة الفعل الصادر من المخلوقين إلى الله وحده،أو شَرّك تعالى بين الحق والخلق في الفعل..
وإنما وردت هذه الإخبارات الإلهية والآيات القرآنية،متنوّعة في نسبة الأفعال الصادرة من المخلوقين،لتنوّع المُشاهدات التي تعلّق العلم الأزليّ بها..
فطائفة لم تَشهد الفعل إلا من الله تعالى وحده. وهذه المشاهدة،وإن كانت حقاً من وجه،فهي مُهلكة إذا دامت على صاحبها،لما يؤول إليه من إبطال الشرائع وإنكار التكاليف. فلم يكن ذا عينين،ينظر بالواحدة إلى الشريعة وبالأخرى إلى الحقيقة.. وإلى هذه المشاهدة إستندت وبها إرتبطت “مقالة الجبرية”..
وطائفة لم تشهد الفعل إلا من المخلوق،حيث برقت لها بارقة من الإسم الظاهر تعالى،إذ ليس العالم كلّه إلا تجلّيه تعالى بإسمه الظاهر. ثًمّ إنطفت عنها البارقة فلم تشهد الأمر على ما هو عليه،ففرّقت بين الحق والخلق،وفَصلت وميّزت ليَصحّ لها التكليف.. وبهذه الحقيقة إرتبطت ومنها إنتشأت “مقالة المعتزلة”،القائلين أن العبد يخلُق أفعاله الإختيارية،وبمرتبة التنزيه المطلق فإنهم نَزّهوا الحق أن يُنسب إليه شيء يُذمّ شرعاً أو عادة..
وطائفة شَهدت الفعل لله تعالى،وللعبد فيه دَخل ونسبة: إما ب”الكسب”،وهي مقالة الأشعري. وإما ب”الجزء الإختياري”،وهي مقالة أبي منصور الماتريدي. وفي هاتين المقالتين إنحصرت “مقالة أهل السنة” من المتكلمين،وقاربت الحق،لولا ما أصابها من العَمَش في نَظرها لوقوفها مع العقل الصّرف. والعقل قاصر،من حيث هو عقل،عن إدراك التجليات الإلهية في المظاهر الخَلقية،وهي مرتبة التشبيه التي أنكرها جميع المتكلمين،إلا من رحم ربّي. ففاتَهم نصف المعرفة بالله تعالى،إذ المعرفة بالله نصفها تنزيه ونصفها تشبيه..
قال إمام العلماء بالله وقُدوتهم محيي الدين: [مسألة نسبة الأفعال الصادرة من المخلوقين،لا يتخلّص منها توحيد أصلاً،لا من جهة الكشف ولا من جهة الخَبر]. “الخَبر”: أي الأخبار الإلهية،وهي الأدلة الشرعية،وأحرى الأدلة العقلية. فإن الأدلّة مُتدافعة مُتصادمة متناقضة،فلا يتخلّص لمُنصف من المتكلمين نسبة الفعل إلى الله وحده ولا إلى العبد وحده.. وأما أهل الكشف والوجود،فهم أهل الحيرة العظمى والوقفة الكبرى،من حيث تصادُم التجليات الأسمائية وإختلافها،وعدم ثبوتها على نمط واحد ونوع مخصوص. فهم يتقلّبون مع التجليات تقلّب الحرباء،لا ثبات لهم على نسبة بينها.. وإلا فالصحيح عندهم: أن الأمر مربوط بين حق وخلق،غير مُخلص للحق وحده من جهة الوجود الذات،ولا للعبد وحده من حيث الصورة. فإن العالَم كلّه،من حيث هو،ليس بخَلق من كل وجه ولا بحقّ من كل وجه..
وإيضاح هذا السِرّ: هو أن حقائق الممكنات ما شَمّت رائحة الوجود،ولا تَشُمّه لا دنيا ولا آخرة. والحق تعالى لا يتجلّى في غير مَظهر،لا دنيا ولا آخرة،بإجماع أهل الكشف والوجود. فأعطى الكشف عن هذه الحقائق أن المُسمّى “عالَما وعَبداً”،إنما هو الوجود الحق،ظاهراً بأحكام الممكنات. وهذا التركيب الإلهي أصل كل تركيب في العالَم،ولا يعلم أحد كيفيّته إلا الله تعالى. فلذا كان الإنسان لا يُعْلَم من حيث صورته،إذ لو عُرف من حيث صورته لعُلم الحق من حيث الوجود الذات،والحق لا يُعلم أبداً. فالعلم بالإنسان،من حيث صورته،إجمال لا تفصيل. ومع هذا فالأدب الإلهي أن تُثبت العبد المخلوق حيث أثبته الله تعالى،وتَنسب الفعل له.. وكذا نَنسب الفعل إلى العبد،حيث كان ظاهر الفعل غير محمود شرعاً أو عادة. ونَنسب الفعل إلى الله،حيث نَسبه إلى نفسه أو كان الفعل محموداً شرعاً أو عادة. فإذا لم ينسبه الحق إلى العبد ولا إلى نفسه تعالى،فنَنسبه إلى الحق على الأصل،فإنه لا موجود على الحقيقة إلا هو تعالى،فلا فاعل سواه تعالى تحقيقاً،فافهم.
فإنك إذا فَهمت ما أدركته لك هذه الكلمات من الأسرار،إسترحت من التّعب في تميّزك بين الحق والخلق،والفصل بينهما،ولن تستطيع ذلك أبداً،وبَقيت عليك أتعاب الحيرة اللاّزمة لكل عارف،لا حيرة أصحاب النّظر في الأدلّة: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)..
وبعد كتابة هذا الموقف،ورد الوارد بقوله: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات).
== (الموقف السبعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى،حكاية عن يوسف: (يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً) [يوسف: 100].
إعلم أن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له في الدار الدنيا حالتين: حالة يقظة وحالة نوم. وجعل له في كل حالة إدراكاً مخصوصاً،أعني عموم الإنسان. وأما الخاصة،كالأنبياء والأولياء،فإنهم يُدركون في اليقظة ما لا يُدركه العامة إلا في النوم.
فحالة اليقظة يُسمى إدراكها “إحساساً”،ومُدركاتها “محسوسات”. وحالة النوم يُسمى إدراكها “تخيّلاً”،ومُدركاتها “مُتخيلات”. والمُدرك من الإنسان في الحالتين واحد،وهو “الروح” المُسمى عند الحكماء بالنفس الناطقة،يُدرك في حالة اليقظة الجزئيات بآلاته الجسمانية،ويُدركها في حالة النوم بآلاته الخيالية..
وليس عالم الخيال بمستقلّ بذاته،زائد على عالم المعاني وعالم الأجسام المحسوسات. وإنما هو برزخ بين عالم المعاني التي لا صورة لها من ذاتها ولا لها مادة،وبين عالم الأجسام المادية. فيُجسّد المعاني في الصورة المادية،كالعلم يُجسّده في صورة اللبن،ونحو هذا. ويُلطف الأجسام المادية فتصير لها صورة روحانية في الخيال الإنساني. وحقيقة البرزخ هو الشيء المعقول الفاصل بين الشيئين،لا يكون عَينهما ولا غيرهما،وفيه قوة كل واحد منهما. ولولا البرازخ إختلطت الحقائق وإلتبست الطرائق،مثل الخط الهندسي الفاصل بين الظلّ والشمس،لا هو من الظلّ ولا من الشمس ولا غيرهما،في الحسّ..
ولما كان الإدراك الخيالي يَقبل وجوهاً من التأويل ويحتمل عدّة من الإعتبارات،كان غير مُتعيّن لوجه واحد،ما دام لم يخرج إلى الحسّ. فإذا خرج إلى الحسّ،تَعيّن لأحد مُحتملاته..
== (الموقف الرابع والسبعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (إن تكفروا فإن الله غنيّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم) [الزمر: 7].
معنى الآية،من طريق أهل الإعتبار والإشارة،أن قوله تعالى: (فإن الله غني عنكم) الخطاب لجميع المخلوقات،وذلك من حيث حضرات أحديّته ووحدته وإطلاقه،فإنه لا مناسبة بينه وبين الممكنات،ولا إرتباط بوجه من الوجوه،لا بأمر ولا نهي ولا رضى ولا سخط.. وقوله تعالى: (ولا يرضى لعباده الكفر) من حيث مرتبة ألوهته الجامعة لجميع الأسماء،التي تقتضي العبودية والخضوع،ومنها إنبعث الأمر والنهي،وإقتضت إنقسام العالم إلى شقيّ وسعيد..
ثمّ إعلم أن الرضا ضد السّخط،وهو غير الحُبّ من وجه. إذ الحبّ لا يتعلّق إلا بمعدوم في الحال أو يُخشى عَدمه في المآل. والرّضا يتعلّق بالموجود وبالمعدوم،من وجه أنه خُصوص إرادة. فلا مشاركة بين الرّضا والحبّ إلا من جهة أن كُلاّ منهما خصوص تعلّق للإرادة. ولذا قال: (ولا يرضى)،ولم يقل: “ولا يُحبّ”..
و”أل” في “الكُفر” لإستغراق جميع أنواع الكفر،فإن الأمر كُفر دون كُفر،كما في صحيح البخاري. ولذا قابل تعالى الكفر،هنا،بالشكر،فإن الشكر أنواع. فهو تعالى لا يرضى لعباده ولا يُريد لهم الكفر،لولا أن من عباده من تطلُبه حقائقهم وتقتضيه إساعداداتهم،فيُريده لهم إجابة لطلب حقائقهم له،كارهاً له.. فالحق تعالى يفعل بإرادته التابعة لعلمه،التابع لمعلومه،ومعلومه لا ينقلب ولا يتغيّر.. فالحُكم للعلم،لا للأمر. ولا تناقض بين الأمر والإرادة: فإن الأمر بالإيمان والمَشي على صراط السعادة،من حضرة الرحمة. والإرادة لضدّ ذلك،من حضرة الحكمة والعلم والعدل.. وإنما التناقض بين الأمر وما أعطاه العلم التابع للمعلوم.. فالأشياء،من حيث بواطنها،تُعطي ظواهرها ما هو حاصل لها أو يحصُل إلى أبد الآبدين..
فالحضرة العَليّة لا شرّ فيها،فالكل خير،وإنما الشرّ من جهة القوابل. ومن هذا تَسميته تعالى ب”المانع”،مع أن المانع إنما هو من جهة عدم قبول المُسمى ممنوعاً،وإلا فالحق تعالى مُتجلّ بالعطاء لكل قابل،لا يُتصوّر في حقّه مَنع أصلاً..
فاعرف هذا الموقف،فإنك إن عَرفته حَصّلت على الراحة الأبدية. وقد سَمّى القوم من ذاقَ هذا بالمُستريح. فاشكُر الله على ما علّمك،وادْعُ للواسطة..
== (الموقف الخامس والسبعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) [الصافات: 96].
إعلم أن هذه الآية وأمثالها،حَيّرت العقول والأوهام،فإختبطت فيها الآراء وتخالفت فيها الأفهام. حيث نسب تعالى خَلق العباد وعملهم إليه،وأثبت في ضمن ذلك لهم عملاً،فأفرد وشَرّك.
وذلك أنه تعالى يفعل تارة بلا واسطة حجاب مخلوق،وتارة بواسطة حجاب مخلوق. فظنّ الظانّون أن الفعل للحجاب،وهو الصورة التي شوهد الفعل منها حسّاً. وظنّ آخرون أن الفعل مُشترك بين الحق والصورة.
والفعل في الحقيقة إنما هو لله،فإن العالم كله أفعال الله،وأفعال الله كلها أفعال لازمة قائمة به تعالى.. فليس له تعالى فعل مُتعدّ،فيكون له مفعول مُنفصل عنه يُقال فيه “غَيْر”.. ولهذا أرباب الشهود يَشهدون الحق تعالى في جميع ذرّات العالم،على التقديس والتنزيه اللاّئق به تعالى،ظاهراً بفعله وتَصويره وخَلقه.. فالعالَم أمر إعتباري،لا إستقلال له بذاته،وإنما هو قائم بفاعله المُقوّم له،وهو الحق تعالى.. ومن عَرف مُسمى المخلوق وما هو،عرف الأمر كما هو. وليس هذا إلا إلى الطائفة المرحومة..
قيل لي في الواقعة: إنما أضاف تعالى الفعل إلى المخلوقات أحياناً،من حيث أنهم صُور وأشكال في الوجود الحقّ،لا غير.
== (الموقف السابع والسبعون بعد المائتين) ==
ورد في الصحيح: (كان الله ولم يكن شيء غيره،وكان عرشه على الماء،ثمّ خَلق الخلق وقضى القضية،وكتب في الذكر كل شيء).
ناقش الشيخ الأمير،في هذا الموقف،جواب الشيخ الأكبر لسؤال الحكيم الترمذي: (وأيّ شيء علم البُدْء؟).. وممّا جاء فيه:
القُدرة تعلّقت بالمُمكن فأثّرت فيه الإيجاد،وهو حالة معقولة بين العدم والوجود. والإمتثال وَقع بقوله (فيَكون)،والتخصيص بالإرادة واقع في عين الممكن،والمُراد وجوده دون غيره من الممكنات المُميّزة عنده في علمه تعالى. فالأمر بالكون لا يتوجّه إلا على ما خَصّصته الإرادة بالكون،لا غيره.
قول سيدنا (محيي الدين): [والذي وَصل إليه علمنا من ذلك،ووافقنا الأنبياء عليه،أن البدء عن نسبة أمر فيه رائحة جَبْر]. يُريد أن كشفه أعطاه أن بدء المخلوقات وإظهارها من العدم إلى الوجود،كان عن نسبة أمر،وهي أمره تعالى لمن يُريد إظهاره من المعدومات بالكون والظهور.. وإنما كانت فيه رائحة جَبْر،لأن صيغة الأمر تقتضي ذلك،وأعيان الممكنات حال ثبوتها وعَدمها،لو خُيّرت لإختارت البقاء في الثبوت،فإنها في حالة الثبوت في مُشاهدة ثُبوتية،مُلتذّة بإلتذاذ ثُبوتي لا تعرف ألماً. فإذا وُجدت تَعرّضت للخطر،فإنها لا تدري ما يحصُل لها حالة إتّصافها بالوجود..
ويُعلّل الشيخ الأكبر البُدْء بأنه كان على نسبة أمر بقول مسموع،فالخطاب بالأمر بالكون لا يَرد إلا على سميع،عاقل لما يَسمع،عالم بما به أمر. فالأعيان الثابتة لها جميع الإدراكات،لكن في الثبوت ما هي إدراكات وُجودية،حيث إن الأعيان الموصوفة بهذه الإدراكات ثُبوتية لا وجودية.. فالأعيان الثابتة تَميّزت عن العدم المحض،وكانت لها صورة في العالَم،فسُميت لذلك أعياناً ثابتة ومُمكنات. فحصل لها التمييز من الإسم (النور)،والحياة من الإسم (الحَيّ)،فإلتبست بوجوده حين الأمر،لا بوجود آخر،لا قديم ولا حادث. وهذا الحكم صادر من حضرة إسمه تعالى (الأول)،فإنه به ظهر كل أول من أشخاص كل نوع،ثمّ ينزل الأمر إلى جُزئيات العالم. ومن حضرة إسمه تعالى (الظاهر) فإنها أظهرت أحكام أسمائه تعالى في العالم،وأظهرت أحكام أعيان العالم في الوجود الذات..
والبدء إنما يُعقل بالرتبة والوجود،والمُتقدّم والمُتأخّر من الموجود سَواء في الرتبة. فإن جميع الممكنات،ما وُجد منها وما سيوجد،في الرّتبة الثانية من الوجود،والرتبة الأولى في الوجود هي له تعالى،وهي التي أظهرت الرتبة الثانية وأعطتها الوجود. ومُعطي الوجود تعالى لا يُقيّده ترتيب الممكنات بالنسبة إلى بعضها بعضاً،وهي بالنسبة إليه لا ترتيب لها.. فلا يزال حُكم البدء في كل عين عين من الممكنات،فهو تعالى مَبدأ في حقّ كل عين عين يوجدها،وذلك الموجود مُبْدَأ (إسم مفعول).
والتقدّم والتأخّر الذي توصف به الممكنات،ليس ذلك بنسبتها إلى الحق تعالى،وإنما ذلك بالنسبة إلى بعضها بعضاً.. فوقف علماء النظر،الرسوم،مع ترتيب الممكنات بعضها مع بعض،فجعلوا نسبة المُبدئ إنما هي مع أول مخلوق لا غير.. في حين وقف أهل الله،العلماء به وبحقائق الأشياء على ما هي عليه،مع نسبة المخلوقات إليه تعالى،فقالوا: نسبة المُبدئ إليه تعالى هي مع كل مخلوق مخلوق،لا خصوصية لأول مخلوق عن آخر مخلوق في ذلك،لو كان للمخلوقات آخر،ولا آخر.
العالَم،وهو كل ما يطلق عليه السّوى،ليس له تقييد ببعضه بعضاً،فإنه غير مُفتقر إلى بعضه بعضاً في الإيجاد والظهور حقيقة،وإنما تقييده بالله تعالى.. وحيث كان العالَم لا تقييد له إلا به تعالى،وهو تعالى يتعالى عن الحدّ والتقييد بشيء سوى ذاته،كان المُقيّد به تعالى،وهو العالم كلّه،تابع له في التنزيه عن التقييد. إلا أنه تعالى مُنزّه عن التقييد والحَدّ مطلقاً،والعالم مُنزّه عن التقييد بغير الحق تعالى.. فأوليّته تعالى هي أوليّة كل جزء وشخص من أجزاء العالم وأشخاصه،إذ لا أوليّة له تعالى بغير العالم،فإن الأولية من النّسب. فلو زالَ العالم،وجوداً أو تقديراً،لم يكن أول ولا آخر،وكذا الظاهر والباطن.. فما أعطاه تعالى الأسماء التي بأيدينا إلا العالَم..
(الأعيان الثابتة): هي حقائق الممكنات في العلم،من حيث أن علمه عين ذاته تعالى [أو قُل: الوجود حَصلت له صُور في العلم تُسمّى أعياناً ثابتة]. فهذه الأعيان هي للعالَم نِسَب أزلية قديمة،لا أول لها من إنها معلومة العلم القديم الأزليّ. ومهما ثَبت قِدَم العلم،ثبت قِدَم معلومه،من حيث عَينه،لا من حيث إتّصافه بالوجود. فإن علماً بلا معلوم غير معقول. وإبتداء الظهور لهذه الأعيان الثابتة،من حيث إبتداء ظهور أحكامها في الوجود الحقّ،لا من حيث هي أعيان،فإنها ما شَمّت رائحة الوجود ولن تشُمّه. وبعد هذا الإتّصاف صارت مَظهراً للحق،والحق تعالى ظاهر مُتعيّن بها..
فإن تعدّد الأحكام على المحكوم عليه،مع أحديّة العين المحكوم عليها بالأحكام المتعدّدة،ذلك التعدّد راجع إلى نِسَب وإعتبارات متعدّدة للعين الواحدة. والنسب والإعتبارات لا عين لها في الوجود الخارجي،وإنما هي أمور معقولة. فعَيْن الممكن لم تَزل أزلاً،ولا تزال أبداً،على حالها من الإمكان،سواء وُصفت بالعدم أو الوجود.. فإبقاؤها في العدم وَصف ذاتيّ لها،وإتّصافها بالوجود عارض لها. وما بالذات لا يتغيّر ولا يزول بالعوارض،لما فيه من قلب الحقائق،وهو مُحال. فالحقائق أحديّة العين،لا تتغيّر بسبب إختلاف الحُكم عليها،لأن إختلاف الحُكم عليها إنما كان لإختلاف النّسب والإعتبارات عليها،لا لإختلاف في عَينها.
ألا ترى قوله تعالى: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) أي موجوداً،فنفى عنه الشيئيّة الوجودية. وقوله تعالى: (إنما قولنا لشيء) فأثبت له الشيئية الثّبوتية،وهي التي توجّه عليها الأمر. والعين واحدة،إختلفت عليها الأحكام بإختلاف النسبة والإعتبار.
== (الموقف الثاني والثمانون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (وإن يمسسك الله بضُرّ فلا كاشف له إلا هو وإن يُردك بخير فلا راد لفضله) [يونس: 107].
إعلم أن الضُرّ والشرّ والمَنْع،إنما نُسب إلى الحق تعالى،وتسمّى بالضارّ والمانع من حيث أنه خالق كل شيء،لا موجد سواه. وإلا فهو لا يُريد الشرّ والضرّ والمنع،بخلاف الخير والنفع والعطاء.
ولهذا عبّر بالإمساس في الضرّ،فإن المسّ قد يكون بغير قصد ولا إرادة. وأتى بالإرادة في الخير،وقال تعالى: (بيدك الخير)،وما قال: “والشرّ”.. وفي الصحيح: (والشرّ ليس إليك). إذ ليس للحق تعالى إلا إعطاء الوجود،والوجود من حيث هو وجود كله خير،والشرّ هو المُعدَم.. والتجلّي الإلهي الذاتيّ،واحد غير متعدّد،أزلاً وأبداً،لا يتعدّد ولا يزيد ولا ينقص. والحوادث الطبيعية العنصرية تحدُث حسب إستعداداتها وقابلياتها وثبوتها في العدم. كما أن أرواح الصور كلها،علوية وسفلية،ذات واحدة غير منقسمة ولا متجزئة،وإنما تميّز بعضها من بعض بحسب قبول الصور من تجلّي الروح الكل.. فإن الأمر الإلهي ينزل من الحضرة الجامعة ساذجاً هيولانياً،لا صورة ولا صفة له،قابلاً لكل صورة وصفة. فتتلقّاه الصور الطبيعية العنصرية،بقابلياتها وأمزجتها،فتَقبله كل صورة على ما هي عليه من المزاج والإستعداد،إذ الحكم أبداً للقوابل في مَقبولاتها. تأمّل في المرآة فإنها تقبل كل صورة تَرد عليها،وتحكُم في الصور وتقلبها إلى ما هي المرآة عليه من الصفة والإستعداد،فلا تَظهر الصورة فيها إلا بحسبها،من طول وعرض وصغر وكبر،وغير ذلك من الصفات.. ألا ترى الشمس حقيقة واحدة،يتنعّم بها المَبرود ويتضرّر بها المَحرور،فعين ما تَنعّم به هذا تضرّر به الآخر.
وكشفه تعالى لذلك لا يكون إلا من وراء حُجُب صور مخلوقاته المُسماة أسباباً،من حيث وجوهها الإلهية الخاصة.. والصور لا أثر لها في الفعل جملة واحدة،من حيث أنها صورة قائمة بنفسها،كما هي في نظر المحجوبين وإعتقادهم. فالآثار تظهر عند الأسباب العادية شُهوداً،وبالوجوه الإلهية التي لها كَشفاً. ولهذا يقول المحقّق في الأسباب العادية: [عندها وبها]. “عندها” من حيث الصورة،فإن الوجوه الإلهية لا تقوم بأنفسها،فلا بد لها من صورة تَظهر بها. و”بها” من حيث الوجوه الإلهية التي قامت بها الصور.. فإن للأسماء الإلهية دُولاً وأياماً على بعضها بعضاً،والغلبة لصاحب الوقت. فلهذا قد لا يظهر الأثر والخاصية مع وجود السبب عادة،ثمّ تظهر الخاصية والأثر في زمان آخر..
(وإن يُردك بخير فلا راد لفضله): أتى في “الخير” بالإرادة،لأنه تعالى يُريد الإيجاد وهو خير. فالخير مُراد بالذات،مقصود له تعالى. والضرّ والشرّ والمنع،إنما كان من قِبَل القَوابل وأمزجتها. فالقابل الذي يَقبل الأمر والنّهي الإلهيّ،ولا يُغيّره،يكون كل شيء في حَقّه خيراً وعطاء ونفعاً،كالأنبياء والكُمّل من وَرثتهم،وذلك إتّساع قوابلهم وإستعداداتهم،فلا يضيقون عن شيء وَرد عليهم. فلذا كانوا دائماً،في جميع أحوالهم،راضين عن الله وهو راض عنهم.. وما يحصُل لهم من الآلام،إنما مَحلّه ظواهرهم وأنفسهم الحيوانية. والذي يُغيّر الأمر الإلهي قابليّته ومزاجه،فلا يلزمنّ إلا نفسه،يعني قابليته وإستعداده. وفي الصحيح: (إنما هي أعمالكم تُردّ عليكم). فمن وَجد خيراً فليحمد الله،ومن وجد شرّاً فلا يلومنّ إلا نفسه،عَينه الثابتة،فإنه لا يكون هنا إلا ما كان هنالك.. فكل شيء يحصُل للإنسان إنما مَنشأه من عينه الثابتة،وهي نفسه،وبهذا كانت الحجّة البالغة له تعالى،فإنه أراد ما عَلم،وعلم المعلوم على ما هو عليه،ومعلومه تعالى لا يتغيّر..
== (الموقف الثالث والثمانون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (وإن تُصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) [النساء: 78_79].
ناقش الشيخ الأمير في هذا الموقف جواب الشيخ الأكبر حول سؤال الحكيم الترمذي: [ما الإذن في الطاعة والمعصية من ربّنا؟]..
الطاعة والمعصية غير مُتساويين في الإذن،بمعنى الإرادة والأمر. فكما أنه تعالى لا يأمُر بالفحشاء،لا يأذن فيها ولا يرضاها ولا يُريدها،من حيث أنها معصية محكوم عليها بذلك،لكن قضاها وقدّرها.
الإذن،بمعنى الإرادة،والأمر الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية،هو الإذن الإلهي في كون المأذون فيه فعلاً مطلقاً،لا مقيّداً بكونه طاعة أو معصية أو خيراً أو شراً. وأما “الإذن الإلهي الشرعي الوضعي” فلا مشاركة بينهما فيه،بل الطاعة مأمور بها مأذون فيها،والمعصية منهيّ عنها ممنوع منها شرعاً.
الإذن الإلهي الذي إشتركت فيه الطاعة والمعصية،هو الفعل من حيث كونه فعلاً،من طريق الإطلاق والتجرّد عن الحُكم عليه،لا من طريق الحكم الذي هو إثبات شيء أو نَفيه على الفعل،بأنه كذا،بمعنى طاعة أو معصية.. والحُكم عند الله في كل مسألة،إختلف علماء الشريعة فيها،واحد. والمُصيب واحد،لا بعينه،والمُخطئ مَعذور. ولما كان حُكمه في الأشياء عَين علمه بها،والعلم قديم،فمعلومه الذي هو عينه قديم. والقديم لا يكون مُراداً،والذي يدخل تحت الإرادة هو الحادث. فحكم الله في الأشياء غير مخلوق،فلا يكون مُراداً عقلاً. لكن الإرادة للطاعة ثَبتت سَمعاً،دون المعصية،فنُثبتها إيماناً كما أثبتنا ما ورد سَمعاً،ممّا لا تقبله العقول إيماناً..
(لا يكادون يفقهون حديثاً): أي لا يُفرّقون بين الحادث الذي هو المحكوم به وعليه،وبين القديم وهو حُكم الله تعالى،لعَدم فِقههم وعلمهم بحقائق الأشياء..
== (الموقف الخامس والثمانون بعد المائتين) ==
تحدّث الشيخ الأمير في هذا الموقف على ما أورده الشيخ الأكبر،في (الباب 73)،حول “مقام الأقطاب”،ومما ذكره:
من أولياء الله “الأقطاب”،بل هم أعلا الأولياء،وخاصة الأصفيّاء. وإنما سُمّوا بالأقطاب لأن فلك العالم،أعلاه وأسفله،إنما يدور على قطب زمانه،لأنه مَحلّ نَظر الحق تعالى،وبه ينظُر الحق إلى العالَم. ولولا وجود القطب ما إستقام العالم،ولا قَبل إمداد الحق له،فإن المَدد الإلهي إنما يَصل إلى العالم بواسطة القطب،هو الذي يَستمدّ من الحق ويُمدّ العالم جميعه،أسفله وأعلاه،أرواحه وأجسامه. إذ القطب ذو صورة وروح: فروحه تدور عليه الأرواح،وصورته تدور عليها الصور. يُدبّر الأرواح بروحه،والصور بصورته.
فمنزل القطب ومَقامه الإيجاد الصّرف،يُنفّذ الأمر ويُصرّف الحكمة. له رقايق مُمتدّة إلى جميع قلوب الخلائق،بالخير والشرّ،على حدّ واحد،وهي عنده لا خير ولا شرّ،ولكن وجود يُظهر كَونها خيراً أو شراً،في المحلّ القابل لها.
وحال القطب حالة عامّة،لا يتقيّد بحالة تخُصّه،بيده خزائن الجود. ومع هذا لا يأكُل من الغيب،ولا يطير في الهواء،ولا يمشي في الهواء.
والأقطاب في العلوم التي تختصّ بمقام القطبانية،كلّهم فيها سواء. ويخصّ الله من شاء من الأقطاب بما شاء من العلوم،زيادة على ما يقتضيه مقام القطبانية.
ولا يصير القطب قُطباً إلا إذا جمع الأحوال والمقامات كلها،التي ينزلها السالكون. أولها “التوبة”،وآخرها “البقاء”.
ومُسمى القطب بالأصالة ليس إلا إدريس عليه السلام،فإنه الخليفة الكامل على الحقيقة. ولذا أبقاه الله حيّاً بجسده وروحه،ولا يموت.. وأسكنه الله السماء الرابعة،التي هي قلب العالَم: فوقها سبعة أفلاك وتحتها سبعة أفلاك. وكل من سواه من الأقطاب،الذين يأتون ويذهبون ويتوارثون مقام القطبانية،هم نُوّابه. ولا يعرف هذا،أحد من الأولياء،إلا الأقطاب عند وصولهم إلى مقامها.
وما سُمي قطباً،في إصطلاح أهل الله،مطلقاً،من غير تقييد بإضافة إلى شيء،كالتوكل والزهد،إلا هذا القطب،وهو “الغَوْث”. وأما قولهم: فُلان “قطب التوكل” في زمانه،ونحو ذلك،فمن باب التوسّع والمجاز. ولا يكون القطب في الزمان الواحد إلا واحداً،لأنه خليفة الله،والله واحد: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)..
فمن الأقطاب من يكون على قَدَم أحد الأنبياء.. وليس في الأقطاب من هو على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،بأن يكون وارثاً له،وإنما يكون على قَدمه بعض “الأفراد”،والشيخ الأكبر محيي الدين منهم،وهو خاتمهم،فليس بعده وارث محمدي.
ومن الأقطاب من يكون ظاهر الحكم،بأن يكون خليفة في الظاهر،كما حاز الخلافة في الباطن،كالخلفاء الأربع.. ومنهم من يلي الخلافة الباطنة خاصة،أعني القطبانية،لحصوله على مقامها،ولا حكم له في الظاهر،وهم أكثر الأقطاب. والقطب الذي لا حكم له في الظاهر،هو الذي يُمدّ الخليفة الذي يكون له الحكم في الظاهر.. والإمدادات الإلهية والقطبية،تابعة للقَوابل،غير ذلك لا يكون،حكمة وعدلاً منه تعالى.
== (الموقف السادس والثمانون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (وقل رب زذني علماً) [طه: 114].
فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بطلب الزيادة من العلم في كل وقت،وهذا من حيث إتّصال الروح الشريف بالجسم الكريم. وأما من حيث روحانيته الفاضلة وإنسانيته الكاملة،فهو منبع العلوم،الجامع بين الحقائق الإلهية والكونية.
وكما أن ذات الحق تعالى كتاب كُلّي وأمّ جامع للأشياء قبل تفصيلها،وعلمه بنفسه كتاب مبين. كذلك هو صلى الله عليه وسلم،من حيث إنسانيته الكاملة وحقيقته الجامعة،كتاب جُملي وأمّ جامع للأشياء بعد تفصيلها،وعلمه بنفسه كتاب مبين.. فبين علم الحق وذاته تعالى،وذاته صلى الله عليه وسلم وعلمه،مُضاهاة من حيث الشهود الفَرقيّ،من غير إتّحاد ولا حلول ولا إمتزاج،إذ ليس إلا وجود واحد،ففي مَن يحُلّ وبمَن يتّحد ويمتزج؟..
فهو صلى الله عليه وسلم بكل شيء عليم،بيده مفاتح الخزائن الإلهية.. وخزانة العلوم الإلهية والكونية منه تخرُج،وعلى يديه تُقسّم. فالقلم الأعلى والنفس الكُليّة،وسائر الأرواح العلوية والسفلية،من دواته تكتُب،وبعينه تُبصر،ومن مشكاته تنظُر.. فلا يظهر الإسم الإلهي إلا عن إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم..
فإن قيل: ما الفرق بين علمه صلى الله عليه وسلم وبين علم الحق تعالى في مقام الفرق؟ قُلنا: هو أنه تعالى عَلم الأشياء،وهي في العدم،لا عين لها في الوجود بوجه من الوجوه. وهو صلى الله عليه وسلم إنما عَلم الأشياء بعد أن صار لها ضرب من الوجود،وهو الوجود العلميّ،فإنه ما عَلمها إلا وهي موجودة في علم الحق تعالى..
وعندما إتّصل روحه العليم بجسمه الكريم،الذي هو مركب من الطبيعة التي هي بين النور والظلمة،أمر الحق تعالى أن يطلب من ربّه زيادة العلم،وذلك بإمداد الروح المحمدي الكريم للنفس الأحمدي العظيم. فهو يُمدّ بوجه،ويَستمدّ بوجه..
والمأمور بطلب الزيادة منه هو العلم الحاصل من التجليات الإلهية.. وقد عَلم صلى الله عليه وسلم الأسماء،فأحرى آثارها. فإن آدم عليه السلام،الذي هو قطرة من بحره وجُزء من كُلّه،علّمه الله الأسماء كلها،فكيف به صلى الله عليه وسلم؟..
فقد أعطي صلى الله عليه وسلم علم ما لا يتناهى إجمالاً،كما أعطي علم ما يتناهى تفصيلاً،خُصوصية له صلى الله عليه وسلم. فإنه ما أعطي مخلوق علم جميع العالم: أجناسه وأنواعه وأشخاصه،ما يتناهى وما لا يتناهى،غيره صلى الله عليه وسلم..
فإن قيل: ما الفرق بين علمه صلى الله عليه وسلم وعلم الحق تعالى بما لا يتناهى؟ قُلنا: هو أنه تعالى عَلم التفصيل في الإجمال،وهو صلى الله عليه وسلم عَلم الإجمال في التفصيل..
وكونه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأربعة المذكورة في قوله تعالى: (إن الله عنده علم الساعة ويُنزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير): هو مما أجمع أهل الله،أهل الكشف والوجود،على خلافه،وإن كان عندهم من قبيل إنكار الضروريات. بل الأقطاب،الذين هم قطرة من بحره صلى الله عليه وسلم،لا يصحّ لهم مقام القطبية والتصرّف في كل ما حواه العرش المحيط،إلا بعلم هذه الخمسة،وأعظم منها..
ومع هذا،فإنا نقول: لا يزال صلى الله عليه وسلم يزداد علماً بجزئيات الأسماء الإلهية والكوائن الجُزئية،لأن الكائنات لا تزال تظهر كُلّ آن بالتجلي الإلهي،ولا تكرار في التجلّي للوُسع الإلهي.. وإن كان صلى الله عليه وسلم عالماً بما لا يتناهى،فلا نقول: إنه لا يخفى عن علمه خافيّة من حيث جسمانيته.. كل هذا لينفرد الحق تعالى بالكمال المطلق،والمخلوق ــ وإن بلغ ما بلغ من الكمال ــ فلا بدّ وأن يصحبه التّقييد ولو بوجه ما..
== (الموقف الثامن والثمانون بعد المائتين) ==
ناقش فيه الشيخ الأمير قول الشيخ الأكبر: [ولا تشترط العصمة في حق الرسول إلا فيما يُبلّغه عن الله. فإن عُصمَ من غير هذا فمن مقام آخر،وهو أن يُخاطب العباد المُرسَل إليهم بالتأسّي به..].
العصمة،وإن كانت ثابتة للرسول مطلقاً،فيُبوتها من منزلين مختلفين،لا من منزل الرسالة ومقامها فقط.
فمن حيث أنه رسول مُبلّغ ما أمره ربّه به،لا يَثبُت للرسول العصمة إلا فيما يُبلّغه عن الله فقط. وثبوت العصمة له فيما عدا ذلك،ليس من منزل الرسالة مقامها،ولكن من مقام ومنزل آخر،وهو أمر الحق تعالى المُرسَل إليهم بالتأسّي بالرسول والإقتداء به،فيما لم يختصّ به. والحق تعالى إنما بعث الرسل ليُعلّموا الخلق بأقوالهم وأفعالهم،قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)..
فالعصمة ثابتة لكل رسول مطلقاً،لكن من مقامين.. فاحذر أن تتوهّم أن سيدنا (أي الشيخ الأكبر) لا يقول بعصمة الرّسل مطلقاً. ولكن أهل هذه الطريقة العليّة،لمّا أطلعهم الحق على حقائق الأشياء وعَرّفهم نسبة كل شيء في العالم،فهم يُثبتون كل شيء من مقامه وبابه،لا يخلطون الحقائق كما يفعل من ليس له علمهم ولا ذَوقهم.
== (الموقف الواحد والتسعون بعد المائتين) ==
ناقش الشيخ الأمير في هذا الموقف،ما نقله الشيخ الشعراني عن شيخه سيدي عليّ الخواص،حول شرحه ل”سورة الشمس”. ومما جاء فيه:
(إذا الشمس كُوّرت): أي بُطّنت الشمس،كناية عن الذات. وتكويرها كناية عن بُطونها..
ظهور الذات إنما كان بإسمه (الباطن)،وهو نَفَس الرحمن الذي هو باطن العلم،إذ النفس باطن المُتنفّس،وبه كانت الكلمات،فكان الظهور.. والظهور والبُطون نِسبتان،ولا تكون نسبة إلا باعتبار الغير،ولا غير حقيقي. فظَهرت لمَن؟ وبَطنت عمّن؟ وليس إلا هم؟ (كان الله ولا شيء معه).
الذات الأحدية،بسبب الحُبّ والمَيْل الإرادي،إنقسمت إنقساماً إعتبارياً إلى طالب ومطلوب،ومُحبّ ومحبوب،وشاهد ومَشهود،وحاضر ومَحضور. وبهذا الإعتبار صارت إثنين: حقّاً وخلقاً،رباً وعبداً،بعد الوحدة. وليس في الحقيقة إلا واحد نَظر نفسه في مرآته. فصارت الذات الأحدية،باعتبار الإنقسام،مُتَكثّرة بكثرة تعيّناتها بلا نهاية..
ولما ظهرت المظاهر إنعدمت الأحدية،بمعنى بطنت،كالواحد في المعدود،فإنه لما ظهرت الأعداد بطُن الواحد بسبب تنقّله في مراتب الأعداد،مع أنها ما قامت إلا بالواحد..
والذات العليّة تنزّلت بتجلياتها في مراتب تعيناتها وظُهوراتها،مُتلبّسة بما إنفصلت عنه،والذي إنفصلت عنه هو الأحدية،وهي سارية في التنزّلات والتجليّات كلها،باطنة فيها.. والإتّصال والإنفصال والإتّحاد،كلّها أمور إعتبارية مَجازية..
== (الموقف الثاني والتسعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) [الأعراف: 54].
ناقش الشيخ الأمير في هذا الموقف بعض ما ذكره الشيخ الأكبر حول “الأعيان الثابتة”،ومما جاء فيه:
النّسب لا أعيان لها خارجية محسوسة،فإن لها أعياناً وحقائق موجودة في العلم والعقل. وهكذا هي النّسب،لا موجودة خارجاً ولا معدومة عقلاً.
لما كانت الأعيان الثابتة،منها منعوت ونَعت،وملزوم ولازم،ومعروض وعَرض. كان لهذه الأعيان الثابتة ترتّب ذاتي طبيعي،فإن النّعت تابع لمنعوته،والعرض تابع لمعروضه. وكانت كل عين من أعيان الأعراض والأحوال مُنعزلة ومُتميّزة عن الأخرى،ومُنعزلة أيضاً عن العين التي تكون نعتاً وحالاً لها في مرتبة الوجود الحسّي.. فإن مرتبة الثّبوت لا تركيب فيها،فالأعيان فيها بسيطة،كل عين متميّزة على حدتها،ما فيها حامل ومحمول،ولا شيء قائم بشيء. بخلاف مرتبة الوجود الخارجي،ما فيها إلا مركب،ليس فيها بسيط أصلاً. والبسائط معقولة لا موجودة..
وكل عين من الأعيان المتبوعة،كعين زيد وخالد مثلاً،تَقبل حال ثبوتها بتغييرات الأحوال والأعراض،إذا إتّصفت بالوجود الخارجي.. فإختلاف الأحكام على الصور الوجودية في كل حال،يدلّ على أن تلك الصور الخارجية التي لها هذا الحال الخاص،ليست هي الصورة التي كان لها ذلك الحال الذي شوهِدَ مُضيّه وزواله. وهذا هو “الخلق الجديد” الذي الناس في لُبس منه.. فالذي يوصف بالتناهي وعدم التناهي هو الموصوف بالوجود الخارجي الحسّي. وأما الأعيان الثابتة فلا توصف بالتناهي ولا عدم التناهي،لأنها لم توصف بالوجود الحسّي الخارجي.
ولا يوجد الحق تعالى عيناً من الأعيان في الخارج المحسوس،إلا بصورة علمه بها،وهي معدومة،لا أزيد ولا أنقص،ولا تبديل ولا تغيير،ولا تقديم ولا تأخير. فيوجدها خارجاً كما علمها ثُبوتاً،حالاً بعد حال..
ظهور المُكَوَّن في النفس الرحماني يُسمى كلمة وأمراً،وظهوره في العَماء يُسمى كَوناً وخَلقاً..
فإن قوّة الخيال ما عندها مُحال أصلاً ولا تَعرفه،فلها إطلاق التصرّف في الواجب الوجود والمُحال،وذلك لقبولهما بالذات والحقيقة إمكان التصوّر والتصرّف فيهما عندها.. وقوة الوَهْم الخيال،وإن كان لها هذا الحكم المطلق،والتصرّف في من خَلقها وهو الحق تعالى،حتى إنتهى حُكمها فيه إلى أن تخلُقه وتُصوّره كيف شاءت.. ومع هذا كلّه فهي مخلوقة له تعالى،مع ما تَخلُقه. وهذا التصرّف لهذه القوة وَصف ذاتيّ نفسي،لا عَرضي. والوصف الذاتي هو نفس الحقيقة وعينها،فلا يكون لها وجود عين في من خُلقت فيه،وهو الإنسان،إلا ولها هذا الحكم والتصرّف في كل موجود خارجي وخيالي. وهي أقوى سُلطاناً في الإنسان من العقل،فإن العقل ــ ولو بلغ ما بلغ ــ لم يخلُ عن حكم الوهم عليه،لأن الوهم يستشرف إلى ما وراء مدارك العقول،ويطلب الصورة فيما لا صورة له.
وما حاز هذه القوة الوهمية وفاز بها،فكمُلت له المعرفة بالله في مرتبتي التنزيه العقلي والتشبيه الوهمي،إلا هذا النّشء والخلق الإنساني،الذي جمع الله له في خلقه بين يديه تعالى. خلقها تعالى له وسط الدماغ،تجمع فيها مُدركات الحواس الظاهرة والباطنة،الجسمانية والروحانية. جعلها تعالى مظهر الإقتدار الإلهي،فهي أرض واسعة،توجد فيها المستحيلات العقلية والعادية كلها. ولعلها هي المُكنّى عنها ب”أرض السمسمة” التي خُلقت من بقيّة خميرة طينة آدم عليه السلام. وبهذه القوة يُرتّب الإنسان الأعيان الثبوتية في العلم،حال عدمها،كأنها موجودة مُترتّبة ترتباً زمانياً محسوساً،وكذلك هي في نفس الأمر،لأن لها وجوداً مُتخيّلاً مُتوهّماً في الخيال المطلق. ولذلك الوجود الخيال،أي المُتخيّل،يقول الحق تعالى له (كُن) في الوجود العيني المحسوس (فيكون) المأمور السامع لهذا الأمر الإلهي وُجوداً عينياً محسوساً يُدركه الحسّ،أي يتعلّق به في الوجود المحسوس الحسّ،كما تعلّق به في الوجود الخيالي الخيال.
وهنا حارت الألباب: هل المَوصوف بالوجود،المُدرك بهذه الإدراكات الحسيّة،هي العين الثابتة،إنتقلت من حال العدم إلى حال الوجود؟ وهو قول الحكماء وبعض المُتكلمين،ممّن قال بالأعيان الثابتة،والعالم عندهم موجود وُجوداً حقيقياً،بوجود حادث (وهو مذهب المتكلمين قاطبة)،أو بوجود قديم (وهو مذهب المَشّائين من الحكماء)..
أو حُكمها تَعلّق تعلّقاً ظهورياً،تعلّق صورة المرء في المرآة،وهي في حال عدمها،كما هي ثابتة مَنعوتة بتلك الصفة،فتُدرك أعيان الممكنات بعضها بعضاً في عين مرآة الوجود الحق؟. وهذا القول لأهل الكشف والوجود،وهم مُتّفقون على أن الأعيان الثابتة ما شَمّت رائحة الوجود،ولا تشُمّها أبداً. وإنما إختلفوا في الظاهر المحسوس: هل هو الوجود الحق،وأحوال الممكنات ونُعوتها مَظاهره؟ أو هو حكم الممكنات،والوجود الحق مَظهر لها؟. فقالت طائفة: الظاهر المحسوس هو حُكم العين الثابتة،ونَعتُها تعلّق بالوجود الحق،تعلّق صورة المرئيّ في المرآة،والصورة دائماً حائلة بين الرائي والمرآة.. فالظاهر أحكام الممكنات،والمُقوّم لها الوجود الحق. وأحكام الممكنات،وإن كانت أعداماً،فهي تُدرك كما يُدرك المحسوس أشياء لا وجود لها في نفس الأمر.. فهي أمور تُدرك،ولا وجود لها إلا في الإدراكات. فالممكن موجود شُهوداً لا علماً،ويُدرك العلم ما لا يُدرك البَصر.. وأصحاب القول الثاني،من أهل الكشف،قالوا: أن الأعيان الثابتة،وإن كانت أحكامها ونُعوتها،على ترتيبها الواقع عندنا في الإدراك الحسّي،فهي على ما هي عليه من العدم،أزلاً وأبداً. ويكون الحق الوجود الظاهر في أحكام تلك الأعيان الثابتة،وهي له مظاهر،فيُدرك بعضها بعضاً عند ظهور الحق فيها بالوجود. فإنها حال ثبوتها،ما هي مظاهر للوجود. فيُقال عند ظهور وجود الحق فيها،قد إستفادت الوجود،وليس معنى هذه الإستفادة إلا ظهور الحق فيها،وهو معنى قول الطائفة: [العالم ما إكتسب من الحق إلا الوجود،وليس الوجود إلا الحق]. فما أكسبهم سوى هُويّته،فهو الوجود بصُور الممكنات،والعالم على أصله من العدم،والحُكم له فيما ظهر من وجود الحق. فما ثَمّ إلا الله،مُجملاً ومُفصّلاً.. وأول ما يُرى من كل شيء وُجوده،ثُمّ يتعلّق البصر بالصورة،فهو الظاهر،ولا فائدة لكون الأمر ظاهراً إلا مُشاهدته وإدراكه،فهو مشهود مَرئيّ من هذا الوجه. والآخر وهو كون الظاهر هو أحكام الممكنات الثابتة ونُعوتها،والوجود الحق محلّ ظهورها،فهو كالمرآة لها.. ولا فائدة لكون الأمر باطناً إلا أنه لا تُدركه الأبصار..
وقد يُكْشَف لبعض الكُمّل،من أهل هذه الطريق،الوجهين المُتقدّمين. ومُحصلهما: أن أهل الله شَهدوا العالم على وجهين ثابتين: أحدهما أن “الحق مرآة الخلق”،فالخلق يُظهرون نفوسهم ببَصر الحق في مرآة الحق،فهو الناظر نفسه منهم. والثاني أن “الخلق مرآة الحق”،فهو يظهر لهم بصور إستعداداتهم،ويُبصر نفسه منهم بصورهم. والمُكاشف بهذين الوجهين هو الكامل الجامع بين شهود الحق في الظهور والبطون.. وليس هذا الشّهود لأحد من الحكماء ولا من المتكلمين،فإنهم يظنّون أن الحق تعالى مُباين للعالم،لا إرتباط له مع العالم بوجه من الوجوه..
== (الموقف الرابع والتسعون بعد المائتين) ==
تحدث الشيخ الأمير في هذا الموقف عن (الإرادة والمشيئة)،من خلال شرحه لأبيات للشيخ الأكبر،ومما جاء فيه:
إعلم أن عقيدة العوام هي أنه تعالى له مشيئة وإرادة،هما صفتان له تعالى يُخصّص بهما أحد الأمرين الجائزين على كل ممكن.
وعقيدة الخواص هي أن له تعالى مشيئة،هي تعلّق الذات بالممكن،من حيث سَبق العلم على كون الممكن. وإرادة هي تعلّق الذات بتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه على التّعيين.
وعقيدة خواص الخواص،التي هي من السرّ المكنون الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله،ولا كل العلماء بالله،فإنها مما تنبو عنها العقول وتمُجّه الأفكار. وهي أن المشيئة والإرادة للحق تعالى عبارة عن تصرّف الحق في نفسه بنفسه.. فوصف تعالى نفسه بالتردّد في أشياء،ووصف نفسه بالمُفاضلة في التردّد.. وهذه إرادة مُجرّدة عن تعلّق المشيئة بالمُراد،وذلك لحقيقة إلهية إقتضت منه تعالى هذا التردّد. وإلى هذه الحقيقة يستند التردّد والتوقّف الواقع في العالَم،إذ ما في العالم حقيقة كونية إلا وهي مرتبطة بحقيقة إلهية..
فالكون،أي المُكوّنات،وهي الصور جميعها،كانت ما كانت،غذاء للأسماء الإلهية،فإنه لا ظهور ولا بقاء للأسماء الإلهية إلا بصور الممكنات.. ولهذا كانت الأسماء الإلهية أشدّ طلباً لإيجاد الممكنات من العدم،من الممكنات حال ثبوتها،فإن بذلك حياتها وظهورها،من القوة الصلاحية إلى الفعل. فمن غذا كَوناً من الأكوان،بهذا القصد،شَكرته الأسماء الإلهية حيث كان سبباً في بقائها ودوام حياتها.. وغذاء الأغذية على الإطلاق هو الذات العليّة بالإتّفاق: فتصرّف المشيئة في تعلّق الإرادة بالظهور بالصور إذا شاء،وبُطونه بعد ظهوره بذهاب الصور،إذا شاء البطون،تصرّف فيه.. فهو الظاهر وهو الباطن.. فما ثَمّ إلا الله،فهو المُرجَّح المُخصّص من حيث ظهوره وبُطونه،وهو المُخصِّص المُرجّح (إسم فاعل) من حيث ذاته،لا بزائد على ذاته،سواء سُمّيت ذلك مَشيئة أو إرادة أو غيرهما..
فالحق تعالى ليس يشاء إلا ما شاء.. لأن العلم تابع للمعلوم،والمشيئة مُترتّبة على العلم،فهي سادن العلم. لولا حضرة الإمكان وقبول الممكن من حيث حقيقته،ما ظهر للإرادة والإختيار إسم ولا رَسم. فالممكن،وإن كان قابلاً لأحد الجائزين عليه،فليس يُقابل بالنظر إلى علم الحق تعالى به وأحدية مشيئته فيه،إلا أحد أمرين. ولهذا نفى بعض المتكلمين الإمكان وقال: [إنه ليس إلا واجب بذاته وواجب بغيره].. ولا يُهولنّك ما قدّمناه ويَحجبنّك ما ذكرناه: (لو شاء الله،لو شئنا،لو شاء ربّك..)،فإنه لا يشاء بعد. لأن (لو) حرف إمتناع لإمتناع،والمشروط بشرط لا يكون بدون شرطه،جفّت الأقلام وطُويت الصحف. فليس للمشيئة إلا تعلّق واحد،لا تردّد فيه ولا إختيار. ووجه ثُبوت المشيئة والإختيار والإرادة،إنما هو لدفع ما يتوهّم من الإيجاد الذاتي والعلّية والجبر ونحو ذلك،تعالى الله عن ذلك.
الإرادة لها التقدّم على المشيئة بالذات،لكون المشيئة تعلّق الذات بالممكن من حيث سَبق العلم،فكانت وجهتها إلى العلم والإرادة تعلّق،بالذات،بالممكن من حيث قبول الممكن لأحد أمرين.. والمشيئة والإرادة مُتّحدان من وجه آخر،فعَينهما وحقيقتهما سواء،وهو إتّحادهما في التعلّق بحضرة الإمكان،أي القبول..
وهذا الذي ذكرناه في حَلّ هذه الأبيات هو من أنفاس سيدنا (أي الشيخ الأكبر) وأمداد لهذا الحقير بالإلقاء في الواقعة،وإن كان مرمى سيدنا جلّ أن يصل إليه رامٍ..
== (الموقف السابع والتسعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) [المعارج: 4].
أي من السنين المعروفة عندنا،مما نعُدّ. وفي هذه الآية إشارة إلى ما يقوله بعض أهل الكشف،وهو إنقطاع العذاب عن أهل النار بإنقطاع حُكم ذي المعارج..
سُمي هذا اليوم “يوم ذي المعارج”،لكثرة عروج الملائكة إليه تعالى فيه،وإلى بعضهم بعضاً،ليأخذ كل مَلك ممّن فوقه في المرتبة أمر الله تعالى ومُراده فيما يُجريه،لكثرة الأحكام في هذا اليوم،فإنه يوم الجزاء للمكلفين.. والدنيا وإن كان فيها جزاء على الخير والشرّ،لكن على الغيب والجهل. وهنالك،في هذا اليوم،على المُعاينة ورؤية الأعمال الخيرة والشريّة،ورؤية الجزاء عليها كذلك..
ويوم ذي المعارج أطول أيام الأسماء الإلهية،إلا الإسم الرحمن. وإن الأسماء لها أيام مُتفاضلة في المَدد إلى الآن،وهو الزمان الذي لا ينقسم،وهو “يوم الشأن”..
وينقطع الغضب الإلهي بإنقطاع مدّة حُكم ذي المعارج،وهي خمسون ألف سنة،ولا يبقى حُكم من أحكام أسماء الإنتقام والغضب،مع بقاء جهنم على حالها من وجود أسباب العذاب،ولا يجدون لها ألماً،لأن الحدود المُقامة على الخلائق أخذت حَدّها وبلغت نهايتها.. وبانقضاء حُكم ذي المعارج يَعزل الإسم (الله) الإسم (المُنتقم)،وما يجري مَجراه من الأسماء الإلهية،ويُعطي الولاية والحُكم المطلق للإسم (الرحمن الرحيم). فالإسم الجامع الله،له الولاية والعَزل في الأسماء الإلهية،من حيث أنها لها دُوَل.. وهذا لا يلزم منه تعطيل أسماء الإنتقام والغضب،لأنا نقول: الأسماء الإلهية نِسَب،لا تظهر إلا بين منسوب ومنسوب إليه،ما هي أعيان وجودية عَينية.. أو نقول: يبقى تأثير أسماء الإنتقام والغضب في صورة مُجسّدة،كما قال شيخ الشيوخ أبو مدين لما رُوي له قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كِبر)،فقال: [صَدق رسول الله،يدخل الكبر النار وصاحبه الجنة]. فيبقى تأثير أسماء الإنتقام في صورة مُجسّدة،وتجسّد المعاني واقع شرعاً وكشفاً..
== (الموقف الثامن والتسعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) [النساء: 56]،وقال تعالى: (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) [النور: 24]..
هذه الآيات وأمثالها نصّ صريح قاطع في إثبات عذاب الإنسان يوم القيامة،وشهادة الجوارح عليه. والإنسان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء: جسم مُشتمل على جوارح.. ونفس حيوانية لها الحسّ والشهوة والغضب. ونفس ناطقة حاكمة على الجسم بما فيه،مُدبّرة له.
فهل العذاب واقع على الجميع؟ أو على الجوارح،وهم الشّهود العدول؟ أو على النفس الحيوانية،وهي غير مُكلّفة ولا مُخاطبة بشيء؟ أو على النفس الناطقة المُكلّفة المُخاطبة،وهي روح الله الطاهرة المقدّسة؟..
أورد الشيخ الأمير مجموعة من النصوص للشيخ الأكبر،تتطرّق لهذه المسألة،وقام بمناقشتها وشرحها وفك غوامضها.. وبعد إيراده لنصوص الشيخ الأكبر،الواردة في الفتوحات،قال:
فأقول: إن سيدنا ساق هذه المسألة في كتاب (التدبيرات الإلهية)،في معرض السؤال من غير جواب،وعبّر عن النفس الناطقة بالكاتب،قال: [هنا سِرّ نَسوقه في معرض السؤال لتُرفع الهمّة إلى طلبه،وهو أن نقول: من المُحال أن يوجد هذا الكاتب في سجّين،حتى نقول: إن بعض أبي جهل،وغيره من الفراعنة،في عليّين،أعني كاتبه وحقيقته. وبعضه في سجّين.. فانظروا في كشف هذا السرّ المَستور وفتح هذا الباب المُغلق،من أنفسكم لا من غيركم]..
_ ورد عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قام لجنازة رآها،فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: (ألَيست نَفساً؟).. فقوله صلى الله عليه وسلم: (أليست نفساً)،أرجى وآكد ما يتمسّك به أهل الله،إذا لم يكونوا من أهل الكشف،الذين كشف الله لهم عن شرف النفس الناطقة،المُسماة باللطيفة الإنسانية وبالروح الجزئية وبالورقاء وبكاتب المدينة الإنسانية. وإنما كانوا من أهل الله الذين تَنوّرت بَصائرهم بالإيمان بالإخبارات الإلهية والنبوية،الواردة في شرف النفس الناطقة.. فالجسم،وإن شَقي بدخول النار،فذلك لا يقدح في شرف النفس الناطقة،فإنه لا يُصيبها ما يُصيب النفس الحيوانية ولا ما يُصيب الجوارح،فهي مُنزّهة عن ذلك. وما يلحقها في الآخرة،عند إلتفاتها لجسمها في النار،هو في المِثْل كَمَن يَشقى هنا في الدنيا بأمراض النفس،من هَلاك ماله وخراب منزله،ألماً روحانياً نفسياً،لا تألّماً حسياً. فإن ذلك التألّم الحسّي حَظّ الروح الحيواني،فإنه الذي يتألّم ويلتذّ حِسّاً بالمحسوسات.. ولما كانت النفس الناطقة من العالم الأشرف،عالم الأرواح المقدسة،قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها نفساً،والنفس واحدة وإن تعدّدت ظهوراتها وإتّصفت بصفات مُتباينة.. فهذا القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم،إعلام بتساوي النفوس في الأصل والشّرف.. _ قال الله تعالى: (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم). فهذا كله إعلام من الله لنا: أن كل جزء فينا عَدْل زَكيّ مَرْضيّ،وذلك بُشرى خَير لنا،بأن كل جزء منّا له عناية تخصّه من الله تعالى.. وإذا كان الأمر بهذه المثابة،يُرجى أن يكون المآل إلى خير وسعادة. وإن دخل الجسم بجميع أجزائه النار،فإن الله أجلّ وأعظم وأعدل من أن يُعذّب مُكرهاً مقهوراً على معصيته.. ولا عذاب للنفس الناطقة،العذاب الخيالي،إلا بواسطة تعذيب هذه الجسوم بإظهار أسباب الآلام عليه،فهي التي تُحسّ بالآلام المحسوسة لسَريان الروح الحيواني فيها،لو بَقيت حيّة في النار،ولكنه تعالى يُميتها في النار حتى لا تُحسّ بالإحتراق ولا بغيره من أنواع العذاب،كرامة لها. وأما النفس الناطقة فليس عذابها بعذاب حسّي،وإنما هو عذاب نفساني بالهموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرّديئة،وبما يراه في رعيّتها مما تُحسّ به النفس الحيوانية الحسّاسة من الآلام..
وكما كان العمل بالمجموع: نفس ناطقة ونفس حيوانية وأدوات جسمية،وقع العذاب على المجموع. غير أن عذاب المجموع مختلف: فالنفس الناطقة عذابها معنوي خيالي،لا تحمله ولا تُحسّ به إحساساً. والنفس الحيوانية تُحسّ به،ولا تَحمله. والأعضاء تحمل العذاب صورة،ولا تحسّ به لمَوتها،ثمّ تقضي عدالة الأدوات إلى سعادة المؤمنين والموحدين،من غير إيمان،ممّن لم يكن له رسول،فيرتفع العذاب الحسي عنهم..
(وإن من شيء إلا يُسبح بحمده): كُلّ مُسبّح لله،فذلك التسبيح للثّناء على الله لا للجزاء،لأنه في عبادة ذاتية لا يُتصوّر معها طلب مُجازاة.. وقد إختصّ الإنس والجن بالنفس الناطقة،فإن غيرهما ليست له نفس ناطقة،وبسببها إختصّا بالتكليف دون سائر الموجودات،لما جعل لها في معرفة الله القوة المُفكّرة التي من خاصيّة النفس الناطقة،إبتلاء من الله،ما إبتلى به أحداً من خلقه،فلم تُفطَر على العلم بالله،خلافاً لسائر المخلوقات. ولهذا قبض عليها تعالى في قبض الذريّة من ظهر آدم وبنيه من ظهورهم: (وأشهدهم على أنفسهم) شهادة قَهر،لأنهم مقبوض عليهم،وكل مقبوض عليه محصور.. فسجدت له كرهاً من أجل القبض عليها،لا طوعاً،لما فيها من الربوبية باطناً،فإنها مخلوقة على الصورة الإلهية،فأبَت أن تسجُد لمثلها.. ثمّ بعد القبض والإشهاد عليها: أرْسَلها تعالى مُسرّحة من تلك القبضة الخاصة،قبضة الإشهاد عليها. وإلا فهي مقبوض عليها أبداً.. فتخيّلت النفوس الناطقة أنها ما بَقي عليها قبض ولا قَهر. فلما وُجدت مُدبّرة لهذا الهيكل المُظلم العنصري،من حيث إنها مُدبّرة لنفس حيوانية شهوانية،لا تُحبّ من الأمور إلا ما يُلائم طبعها،خيراً أو شراً،فهي لذلك تُعطيها ما قَسم الله لها،حسب الإرادة الإلهية أو الأمر الشرعي.. وغفلت النفس الناطقة عن مشهد الإقرار لموجدها بالربوبية،حين وَصلت إلى موطن الدنيا،موطن التكليف بالأمر والنهي،وبتدبير النفس الحيوانية إلى الأجل الذي قدّره الله له.. فإنه تعالى قضى على النفوس الناطقة أنها لا تكون في موطن إلا وتنسى ما كان لها قبله،حكمة وعدلاً،إلا نفوس الأنبياء وبعض الأولياء. ومع هذا العُلوم مَركوزة فيها،يُظهرها الله له منها متى شاء.
_ النّفخ الإلهي يتوجّه على الطبيعة العنصرية،فتَظهر النفس الناطقة بينهما،فيدخُل الخَلل عليها،وهو نسبتها إلى الرذائل،من نَشأتها الطبيعية،لا من حيث عَينها وحقيقتها. فالإنسان،جسده كلّه،من حيث طبيعته،طائع لله تعالى مُشفق شَفقة إجلال،لا شَفقة خوف.. وكلّ قوة وجارحة فيه بهذه المَثابة،ولا تعرف الفصل المُحرّم بعينه.. فإن الشأن إذا أراد الروح الكُلّ إظهار أمر بإرادة الله،تَجلّى للقلب فإنشرح الصدر لذلك الأمر. والقلب مرآة العقل،فيرى العقل ذلك الأمر،فيصرف أنه مُراد الروح الكُلّ،فيكتب ذلك في ذات النفس الناطقة،فيظهر على الجوارح،فيُقال بلسان الشرع: أطاع أو عصى.. فعالم الشهادة،لا تظهر عنه حركة ولا سُكون،إلا عن عالم الغيب،وهو عالم الروح. ولهذا هُم الجوارح والقوى مَجبورون تحت قهر النفس الناطقة المُدبّرة لهم.. فيُنجيهم الله،دونه،من عذاب يوم أليم،إذا أخذه الله يوم القيامة وجعله في النار.. فالنفس الناطقة،لمّا عَلّقها الله بتدبير الجسم،تَعشّقت به. فالتأثّر الذي عبّر عنه بعذابها يوم القيامة،هو لهذا التعشّق. فأما المؤمنون والموحدون،الذين يخرجون من النار إلى الجنة،فيُميتهم الله فيها إماتة حقيقية،كرامة للجوارح الإنسانية،حيث كانت مجبورة للنفس المُدبّرة لهم.. فلا تُحسّ الجوارح بالألم لمَوتها،وتُعذّب النفس الناطقة وحدها في تلك الموتة الحاصلة للجوارح،وعذابها تخييل،كما يُعذّب النائم فيما يراه في نومه من الأشياء المُفزعة،فيتألّم تألّماً خيالياً،وجسده في سريره.. والحقّ أن العذاب المنسوب للنفس الناطقة مجهول الكيفية.. وأما أهل النار،الذين قيل فيهم كما في الآية (إنهم لا يموتون ولا يحيون)،وهم المشركون المتكبرون على الله،وهم الذين لا يخرجون من النار أبداً: فإن جوارحهم أيضاً بهذه المثابة من الإماتة في النار،كشفاً وقياساً،ألا تراها تَشهد عليهم يوم القيامة؟.. فأنفسهم الناطقة لا تموت في النار،لأن حياتها ذاتية،لتذوق العذاب النفسي الخيالي. وجوارحهم لا تحيا في النار حتى لا تذوق العذاب. فأهل النار،من مؤمن وكافر،عذابهم نفسي بالنسبة إلى نفوسهم الناطقة،في صورة حسيّة بالنسبة إلى الجوارح،من تبديل الجلود وما وصف الله من عذابهم.. فكلما إلتفتت النفس الناطقة إلى جسمها في النار،تأثّرت،فإذا أعرضت عنه رجعت إلى تجرّدها النسبي،فلا ألم فيها ولا لذّة. وأما أجسامهم فإنها قد زالت الحياة من جوارحهم،فلا تُحسّ ولا تتألّم.. _ الجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا المعصية على التعيين،لأن عبادتها وطاعتها ذاتية لها.. فإذا قامت الحجّة البالغة،وعُذّبت النفس الناطقة في دار الشقاء كما فصّلناه،بسبب ما يمسّ الجوارح من النار وأنواع العذاب في الحسّ،والجوارح مملكتها ورعيّتها في الدنيا. وأما الجوارح فتَستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب وتَستلذّه،حيث فارقها الإحساس وبَقيت عليها حياتها الذاتية بها. ولذا سُمي عذاباً،لأنها تَستعذبه كما يستعذب ذلك العذاب خَزنة النار،حيث تنتقم لله،كما أن ملائكة النّعيم تَنعم لله. وكذلك الجوارح تتنعّم بما يطرأ عليها في النار،حيث جعلها الله محلاً للإنتقام من تلك النفس الناطقة التي كانت تحكُم عليها. فالعذاب في الصورة للجوارح،والإنتقام بذلك من النفس..
ألا ترى المريض مثلاً،إذا نام؟ لا شك أن النائم حيّ،والحسّ عنده موجود،والجرح الذي يتألّم له في يقظته موجود. ومع هذا لا يجد العضو ألماً حالة النوم،والعلّة لهذا أن الواجد للألَم،وهو الروح الحيواني،قد صَرف وجهه عن عالم الشهادة،عالم الحسّ،إلى البرزخ عالم الخيال. فما عنده خبر من عالم الشهادة والحسّ،فإرتفعت عنه الآلام الحسية،وبَقي الروح الحيواني في البرزخ،على ما يكون عليه،إما في رؤيا مُفزعة فيتألّم أو في رؤيا حسنة فيتنعّم،تألّماً وتنعّماً خياليين..
فقد علمت يا أخي من يتعذّب منك،إذا كنت شقياً،وهو النفس الحيواني،عذاباً محسوساً،والنفس الناطقة عذاباً نفسياً. ومن يتنعّم منك،وهي الجوارح،وما أنت سواك. فإنك إنسان بالمجموع،فلا تجعل رعيّتك تشهد عليك بالجور فيعود بالخسران..
_ النفس الناطقة سعيدة في الذنيا والآخرة،لا حظّ لها من الشقاء.. إلا أن الله ركّبها هذا المركب البدني المُعبّر عنه بالنفس الحيوانية،فهي لها كالذابّة،وهي كالراكب عليها.. والنفس الناطقة من عالَم الطاعة. فإن أجابت النفس الحيوانية لذلك الذي دعتها إليه،وكانت مُنقادة مُطيعة،فهي المركب الذلول المُرتاض الذي يكون عند إشارة راكبه فيما يُريد منه. وإن أبَت الحيوانية وما أجابت لما دعتها الناطقة،لفساد مزاجها وإستعدادها،فهي الدابّة الجموح الحرون.. فالنفس الحيوانية ما تقصد المخالفة لأمر الشارع ولا تأتي المعصية إنتهاكاً لحرية الشريعة،وإنما تجري بحسب طَبعها ومزاجها،كسائر الحيوانات العجم،لأنها غير عالمة بالشرع. وإتّفق مع جهلها بالشرع أنها على مزاج سيّء لا يُوافق راكبها على ما يُريد منها. والنفس الناطقة لا يتمكّن لها المخالفة لأمر الله،لأنها من عالم العصمة.. فإذا وقع العذاب يوم القيامة،فإنما يقع على النفس الحيوانية،لأنها محلّ الشهوة والإلتذاذ.. ألا ترى الحدود الدنياوية،في الزنا والسرقة والمُحاربة والإفتراء؟ إنما كلها على النفس الحيوانية البدنيّة،وهي التي تُحسّ بألم القتل وقطع اليد وضرب الظهر. فقامت الحدود الشرعية في الظاهر على الجسم،وقام الألم بالنفس الحسّاسة الحيوانية التي يجتمع فيها جميع الحيوان المُحسّ للآلام. فلا فرق بين محلّ العذاب من الإنسان وجميع الحيوان،في الدنيا والآخرة.. فالذي يَلتذّ هو الذي يتألّم،وليس إلا النفس الحيوانية الحسّاسة.. عندما قام صلى الله عليه وسلم في جنازة اليهودي،قال: (أليست نفساً؟). فما عَلّل بغير ذاتها،من الصفات العرضيّة. فقام تعظيماً لها وإجلالاً لشرفها الذاتي ومكانتها الزّلفى من الله. وكيف لا يكون لها الشرف الذاتيّ،وهي منفوخة من روح الله؟ فهي من العالم الأشرف المَلكي الروحاني. فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانية،وبين الراكب على الدابة في الصورة،فإما جَموح وإما ذلول.. فقد جعل الله النفس الناطقة،الروح الجزئية،والياً تحت الروح الكلّ على المملكة الإنسانية. وأعطاها التصرّف فيها على كل حال: تارة بأمره الشرعيّ،وتارة بإرادته العامّة.. فالنفوس الناطقة مُنفّذة لقضاء الله بالأجسام وما فيها من الجوارح،إن خيراً وإن شرّاً. ومع هذا هي المُكلّفة المَنهيّة المأمورة. وفي هذا حِكَم عجيبة وأسرار غريبة،والجوارح لا علم لها ولا خبر عندها.. _ فالسعادة والشقاوة تُنسب إلى النفس الناطقة،إذ مَن شَقيت رعيّته فكأنه شَقي هو. وكذلك السعادة واللذّة والألم للنفس الحيوانية،كما قال تعالى: (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مُقرّنين دعوا هنالك ثُبوراً).
هذه أحوال النفوس الحيوانية،وأما النفوس الناطقة فهي مُلتذّة بما تعلمه من إختلاف أحوال مراكبها. فإن إختلاف الأحوال لإختلاف التجليات الأسمائية،فكل حال له إسم يخُصّه. فتلتذّ النفس الناطقة لأنها في مزيد علم إلهي..
وقولنا: [النفوس الناطقة مُلتذّة]،لا نُريد اللذّة مطلقاً،كما يقوله الحكماء والمتكلمون،وإنما يكون لها ذلك عند إلتفاتها للجسم،الإلتفات التامّ. فإذا أعرضت عنه،وإلتفتت إلى عالمها الروحاني،فلا لذّة ولا ألم،لا حساً ولا تخيّلاً ولا علماً..
فمن حيث النفخ الإلهي،لا تفاضل بين النفوس الناطقة. وإنما التفاضل في القوابل المزاجية،فتبقى الناطقة منه معطلة الآلة الفكرية النظرية.. فإن الإنسان حيوان،بنور النفس الناطقة يستضيء. فإذا صَرفت النفس الناطقة نَظرها إلى جانب الحق،تَبعها نورها. إذ النفس الحيوانية نَفْخ النفس الناطقة في الجسم. فإذا كان الجسم معتدل النشأة،ظهرت فيه الحيوانية على شكل الناطقة،فإنها شُعاعها. فتلتذّ النفس الحيوانية بما يحصُل لها من الشّهود،لما لم تَره قبل ذلك،وتغيب عن الإحساس بالألم..
فلا ألم ولا لذّة،حسية أو علمية،لازمين،إلا للنفوس الحيوانية. فإن كانت اللذّة عن مشاهدة إلهية،فلذّة علمية. وإن كانت اللذة عن مُلاءمة طبع ومزاج ونَيل غرض،فلذّة جسمية حسيّة.
وأما النفس الناطقة فعلم مجرّد،من حيث هو،لا صورة له في نفسه،وإن ظهر بالصورة فما ظهر إلا أثَره. فهو أمر الله ظهر بالنّفخ،وكان ظهوره عن وجود لا عن عدم..
_ الإنسان سعيد من حيث نشأته الطبيعية العنصرية،وهو جميع جسمه،وسعيد من حيث نشأة نفسه الناطقة الروحانية العلوية. هذا إذا أعتُبر بانفراد كل نشأة عن صاحبتها. وباعتبار المجموع من النّشأتين ظهر التكليف،فظهرت المخالفة.. فإذا إرتفع التكليف،ظاهراً وباطناً،إرتفع الحُكم بالمخالفة في كل قول وفعل وحركة وسكون. ولم يبق إلا مُوافقة دائمة،وطاعة ممكن لواجب مُستمرّة.. مُطيع للمشيئة،مُخالف لأمر الواسطة الرسول البشري.. _ يقول تعالى،إخباراً عن النفوس الناطقة حالة شهادة الجلود عليها: (وقالوا لجلودهم لم شَهدتم علينا) بما جحدناه من المخالفات،ونحن إنما نُدافع عنكم لأنكم الذين تَحُلّون في النار وتنضُجون فيها. (قالوا أنطقنا الله ــ أي بالشهادة عليكم ــ الذي أنظق كل شيء). وشهادة الجلود،وجميع الجوارح،مقبولة،لأنهم شُهداء عدل مَقبولو القول مطلقاً عند الله تعالى،فإنهم معصومون من المخالفة،من حيث هُم. وكانوا في الدنيا دار التكليف والمحنة،من حيث عبادتهم الذاتية،غير راضين بما كانت النفس الناطقة ــ التي غلبت أحكام النفس الحيوانية عليها ــ تُصرّفهم فيها من المخالفات،لفساد طبيعة المزاج وسوء تركيب الطبيعة. فإن النفس الناطقة لا تُدبّر الجسم وحَيوانيته،إلا بحسب مزاجه،نقصاً وكمالاً،إنحرافاً وإعتدلاً..
وإنما سُميت الجلود بهذا الإسم لما هي عليه من الجلادة،إذ كل مُسمّى له قسط من إسمه. فإنها تتلقّى بذاتها جميع المكاره التي تعرض للجسم،من جراحة وضرب وحرق وبرد،وفيها الإحساس المُبثّ في جميع الجسم من القوة الحسّاسة المعقولة. والجُلود هي مِجنّ النفوس الحيوانية وترسها،لتلقّي هذه المَشاقّ. فما في الإنسان أشدّ جلادة من جلده،ولهذا غشّاه الله به. فنُضجه في النار سَبب في عذاب النفس الناطقة،عذاباً نفسياً لا حسياً..
__ خلاصة هذه الأبواب: أن العذاب حقّ،أي ثابت للإنسان،من باب الكُلّ لا الكُليّة. وأن المُعذّب حسّاً هو النفس الحيوانية الحسّاسة. وأن الجوارح تحترق وتَسودّ،والجلود تنضُج في جهنم،ولا إحساس لها بذلك ولا ألَم عليها. وأن النفس الناطقة عذابها هو إدراكها ومشاهدتها لما يحصل في الجسم الذي كانت تُدبّره في الدنيا..
ولقد أعظم الفَريّة من زعم أن سيدنا الشيخ محيي الدين،عقيدته ومذهبه في الأمور الأخروية،مذهب الحكماء. كلاّ وحاشا..
وكنت توقّفت في الجمع بين جملتين من هذه الأبواب،فورد الوارد بأمر مُشدّد بالإشتغال بالذكر،فجعلت أذكر الله،والمسألة في فكري،ففتح الله في فهمها،فورد الوارد بقوله تعالى: (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً). وقلت في نفسي: ما أدري،هل وافقت مُراد سيدنا الشيخ فيما كتبته في هذه المسألة،وزِدتُه من التوضيح،أم لا؟ فورد الوارد بقوله تعالى: (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون).
وما ذكره سيدنا في هذه الأبواب،هو لسان له. وله لسان أعلى من هذا،من تتبّع كلامه في كتابه (الفتوحات) وَجده..
== (الموقف التاسع والتسعون بعد المائتين) ==
قال الله تعالى: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) [الإسراء: 13_14].
أخبر تعالى أنه ألزَم كل إنسان طائره،أي حَظّه ونَصيبه. بمعنى جعله لزيماً له مُلازمة العُنق..
وهذا الكتاب الذي يخرج،ما هو الكتاب الذي تكتبه الحفظة من أعمال العبد في الدنيا.. وإنما هو الكشف له عن عينه الثابتة في العدم،وما هي عليه من الإستعداد،وهو طائره الذي ألزمه إياه في الوجود الخارجي. ويُقال له: إقرأ كتاب نفسك وإستعدادك لما حكمنا به عليك وظهر منك في دار التكليف،فيجد نفسه كتاباً منشوراً لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
فحينئذ يقول الحق للإنسان: (كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) أي مُحاسباً لكَ،وإنك ما ظلمك الحق بشيء حكم به عليك.. وبه قامت الحُجّة لله على من يقول: يا ربّ علمُك سَبق في أن أكون على ما أنا عليه،فلمَ تُؤاخذني؟ فيقول له الحق: هَل عَلمتُك إلا بما أنت عليه؟ فإني ما حكمت عليك إلا بك.. ولهذا الإشارة في الحديث: (من وَجد خيراً فليحمد الله،ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). فكتاب كل إنسان نَفسه،وهو عينه الثابتة..
== (الموقف الثاني بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (وهذا كتاب أنزلناه مُبارك فاتّبعوه) [الأنعام: 155].
إعلم أن الكتب الكُلية الجامعة خَمسة: كتابان إلهيان،وكتابان كونيان،وكتاب جامع للكتب كلّها.
_ (الكتابان الإلهيان): أحدهما تَفصيل في إجمال،فإجماله هو المشار إليه بقوله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى). وتفصيله هو المشار إليه بقوله تعالى: (تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً).
والكتاب الإلهي الثاني سَمّاه تعالى “كتاباً”،وسمّاه “ذكراً”. قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل إليهم) أي من الكتاب الإلهي الأول. وقال تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) أي شيء أجْمِل وأبْهِم في الكتاب الأول. والمُراد بذلك سُنّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا كانت السنّة قاضية على القرآن..
وإنما خَصّ الكتاب الأول بإسم إلهي دون الثاني،لأن الأول مخصوص بما يأتي به المَلك مَشهوداً،فيُلقيه على قلب الرسول أو سَمعه. وهذا الثاني أعمّ من أن يكون بواسطة مَلك مَشهود أو بواسطة مَلك غير مشهود،أو بلا واسطة أصلاً،وهو ما يكون للرسول من الوجه الخاص.
_ (الكتابان الكونيّان): أحدهما مُفصّل،والآخر مُجمل.
فأما الكتاب المُفصّل فهو المُشار إليه بقوله: (وكتاب مسطور في رَقّ منشور). فهذا الكتاب هو العالَم كُلّه،فهو كلمات الله المسطورة في الرقّ المنشور،وهو الوجود المُقيّد.
وأما الكتاب المُجمل فهو “الإنسان الكامل”،المشار إليه بقوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) أي كل ما يُطلق عليه شيء،وهو كل ما يصحّ أن يُعلم ويُخبر عنه،إلا جمعه في الكتاب المُختصر،وهو الإنسان الكامل. بعدما أخبر تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم).. فالإنسان الكامل هو الكلمة الكُليّة والحضرة الجامعة.
_ (الكتاب الخامس): الجامع للكتب المفصلة والمجملة والمطولة والمختصرة،فهو المشار إليه بقوله تعالى: (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه). فالألف إشارة إلى حضرة الذات الوجود المطلق الجامع لجميع الحضرات. فقوله (ذلك) إشارة إلى الألف. فإن اللاّم،الذي هو كناية عن حضرة الأسماء،والميم الذي هو كناية عن حضرة الأفعال،كُلّها داخلة تحت الألف. فهو الكتاب الجامع للكُتب كلّها.
== (الموقف الرابع بعد الثلاثمائة) ==
(الدين) لغة: الطاعة والإنقياد،وهو المُراد بقوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون). فإنه تعالى قال للناس،وهم أرواح مُتعلّقة بأجساد برزخية: (ألست بربكم) فإنقادوا وأطاعوه،وقالوا: (بَلى) إقراراً بربوبيته لهم ومُلكه عليهم.
والدين إصطلاحاً: وَضع إلهي سائق لذَوي العقول،بإختيارهم المحمود،إلى ما هو خير بالذات. وهذا المعنى هو المُراد بقوله تعالى: (إن الله اصطفى لكم الدين)..
وأما (الفطرة): فهي فطرتان: فطرة مطلقة وفطرة مُقيّدة.
فأما “الفطرة المطلقة”: فهي المذكورة في قوله تعالى: (فطرت الله التي فطر الناس عليها) أي خَلقهم عليها،وجعلها في جبلّتهم وفطرتهم. فإذا خرجوا إلى الوجود العيني،يخرجون عليها. وهي قوله تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى). وهذا العهد أخذ على الأرواح قبل وجود الأشباح،فكُلّ من خرج من الناس إلى عالم الأشباح،يخرج مفطوراً على هذه الفطرة من الطاعة والإنقياد.. وليس أحد يعرف الحق تعالى إلا في حضرة الربوبية،حتى العقل الأول. وتَفرّد القديم تعالى بمعرفته نفسه في حضرة الألوهية.. وهذه الفطرة المطلقة لا تبديل لها ولا تغيير فيها.. والفطرة أيضاً بمعنى ما يظهر به الإنسان عند وجوده من التجلّي الإلهي الخاص الذي يكون له عند إيجاده،وهو الذي فَسّر به بعضهم الفطرة فقال: [إنها الصفة التي يكون عليها كل موجود في أول زمان خِلقَته]. بمعنى الإسم الذي يتجلّى به الحق على المخلوق عند إيجاده،وهذا الإسم هو حقيقة ذلك الموجود..
وأما “الفطرة المُقيّدة”: فهي مذكورة في حديث: (كل مولود يولَد على الفطرة) الحديث. بمعنى أنه تعالى فَطر الناس وخَلقهم مُستعدّين مُتهيّئين قابلين للدين الحق.. وهذه الفطرة تَقبل التبديل والتغيير والتعيين والتقييد،بعد الإطلاق والسّذاجة. ولهذا كان الأبوان يَنقُلان وَلدهما من الإطلاق والسذاجة إلى التقييد باليهودية أو النصرانية أو أي نحلة كان عليها الأبوان.. ومن فَسّر الفطرة في الحديث بالإسلام،من شُرّاح الحديث،فقد أبْعَد..
== (الموقف الثامن بعد الثلاثمائة) ==
ناقش الشيخ الأمير،في هذا الموقف،قول الشيخ الأكبر،في [الباب 523: في معرفة حال قطب كان منزله: (وأما من خاف مقام ربه)]،وقام بحلّ مستغلقاته وشرح مضامينه،وممّا جاء فيه:
(ومن خاف مقام ربّه): لما عَلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (مقام ربه) هو الحضرة الربيّة الجامعة،لما وصف به الحق نفسه من صفة جلال وجمال ورحمة وغضب،إستعاذ وتحصّن بالله تعالى منه تعالى: (وأعوذ بك منك). فإستعاذ بصفات الرحمة من صفات الغضب،وكلها يجمعها مقام الربّ..
ولما كان الشأن أن كل عبد له ربّ يخُصّه من الحضرة الجامعة،قال تعالى: (مقام ربّه)،فأضافه إلى العبد المربوب وما أطلقه فقال: “مقام الربّ” مثلاً.. فكما دلّت الآية على أن المُراد ب(مقام ربّه) الحضرة الجامعة،دلّت كذلك على أن (مقام ربّه) الأرباب الخاصة بكل مربوب ذي إعتقاد.. وما تجد قط هذا الإسم (الربّ) إلا مُضافاً مُقيّداً،لا يكون مطلقاً في كتاب الله،فإنه ربّ بالوَضع،والوضع تخصيص شيء بشيء،فلا يُتصوّر رب إلا بتصوّر مربوب،وجوداً أو تقديراً،في العلم،فلا ينفكّ أحدهما عن الآخر..
وإسم (الربّ)،من حيث دلالته،هو الذي يُعطي في أصل وَضعه أن يَسع كل إعتقاد يُعتَقد فيه ويظهر بصورته في نفس المُعتقد.. وهو تعالى ربّ واحد من حيث الذات،كثير من حيث تجلّيه بصور المعتقدات التي هي صور أسمائه،التي لا نهاية لظهوراتها بالصور.
فكل مخلوق له ربّ بحسب إستعداده ومزاجه،والإستعدادات والأمزجة مُتخالفة مُتباينة،لا يجتمع إثنان في مزاج واحد من كل وجه أبداً.. فإذا كان العارف،عارفاً حقيقة،لم يتقيّد بمعتقد دون معتقد،ولا إنتقد إعتقاد أحد في ربه دون أحد،لوقوفه مع العين الجامعة للإعتقادات،وهي العين الواحدة حضرة الأسماء الربيّة الإلهية التي تفرّعت منها جميع الفروع الأسمائية،التي هي سبب إختلاف الإعتقادات.. ومع هذا فإن العارف يخاف أن يكون هذا الإعتقاد منه واحداً من الإعتقادات،فيكون مثل كل ذي إعتقاد جُزئي مُقيّد،وأن كونه مع الرب المطلق خيال ودَعوى..
قال تعالى: (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني). يقول: لا إله إلا أنا الظاهر في كل ما يعبده أهل كل ملّة ونحلة،فما تلك الآلهة إلا أنا. ولهذا أثبت لهم لفظة الآلهة،تسمية حقيقية لا مجازية،كما يقول من ليس له هذا المشرب ولا حصل له هذا العلم: إنه إنما أراد تعالى من حيث إنهم سَمّوهم آلهة،لا من حيث أنهم لهم في أنفسهم هذه التسمية. وهذا غلط وتحريف للكَلم،إذ الحق تعالى عين الأشياء،وليست الأشياء عينه.. فما في العالم من عَبد غيري،وأنا خلقتهم ليعبدوني،ولا يكون إلا ما خلقتهم له..
(في أي صورة ما شاء ركّبك): فإن نفس العارف الناطقة تتصوّر له بصورة كل خاطر،وتتحوّل من صورة إلى صورة.. فعلمنا أن الحق تعالى له التجلّي في صور المعتقدات،والعارف لا ينكره في أي صورة تجلّى،فيُقرّ به في كل صورة..
وكل من يدّعي معرفة الله تعالى،ولم يعرفه هذه المعرفة،وهو أن لا يتقيّد بمعتقد دون معتقد،فربّه مُنعزل عن أرباب كثيرة..
واعلم أن الحق تعالى لم يزل ولا يزال،في نفسه،كما تجلّى لعبده. فهو على ما هو عليه،أزلاً وأبداً،لا يخلع صورة ويلبس أخرى،ولا يلحقه التغيير في ذاته. وإنما التغيير في إدراكات العبد ومُدركاته. فمشيئته تعالى إنما تعلّقت بعبده،أن يراه عبده في تلك الصورة التي شاء الحق أن يراه عبده فيها.. فكل صورة يخلقها الله تعالى،فهي بالنسبة للحق تجلّ من التجليات ومظهر من المظاهر،وبالنسبة للممكن هي أحكام عين الممكن الثابتة،وتُسمى الصورة بأسماء الممكنات..
فخَف مقام الربّ إن أضفته،ولا تخف منه إذا عرفته.. فالخوف من مقام الربّ إذا لم تعرفه إلا مُضافاً مُقيّداً،بأن إعتقدت أن ربك غير رب سواك من سائر الملل والنحل،من حيث الذات والحقيقة. وهو الجهل بالرب الحقيقي،رب السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما. ولا تخف مقام الربّ،الحضرة الربيّة الإلهية،إذا عرفته حقيقة المعرفة..
والرب المطلق الذي تعلمه مطلقاً،هو عين الرب المقيّد الذي تشهده مقيّداً.. فالمقيّد وجه من وجوه الإطلاق وإعتبار من إعتباراته. إذ لو عُلم المطلق من حيث هو أو شوهد من حيث هو،لإنقلبت حقيقته،وإنقلاب الحقائق مُحال.. وحيث كان الربّ المطلق هو عين الرب المقيّد بالصور،وصورتك من جملة ما تَشهده ومُقيّداً بها،فالربّ عَينك. فكُن وإعتقد أنك أنت الموصوف بكل ما وصفته به تعالى،إذ الصور أحكام الممكنات في الوجود الظاهر في الصور. فهي للحق تعالى أسماء،وللممكن نُعوت وصفات،من حيث أن الممكن مُتّصف بها..
وحيث كانت “المُشاهدة” مُتعلّقها الذّوات،وما من أمر تَشهده إلا وله حُكم زائد على ما وقع عليه الشّهود،لا يُدرك إلا بالكشف. فلا تقتصر على المشاهدة،إذ الشهود لا يُعطي العلم بالمشهود من حيث حقيقته تفصيلاً. فحظ المشاهدة المحسوسات،ولا تزد في الكشف إن كَشفته. حيث كانت “المُكاشفة” مُتعلّقها المعاني،فهي إدراك معنوي مُختصّ بالمعاني. فلذا كانت “المكاشفة أتَمّ من المشاهدة”،كما إذا شاهدت مُتحركاً،مثلاً،فإنك تطلب بالكشف مُحرّكه.. وليست هناك مرتبة بعد المكاشفة تزيد إيضاحاً في الشهود..
قيل لي في واقعة من الوقائع: ليس بين الأقطاب وبين الحق تعالى إلا مرتبة واحدة،وهي “الوجوب بالذات”. فأنت الصورة الظاهرة في المرآة،ما هي عين المُتوجّه على المرآة من كل وجه،ولا غيره من كل وجه،ولا هي عين المرآة من كل وجه،ولا هي غير المرآة من كل وجه. فأنت لا عين ولا غير،ورفع النقيضين يُؤذن بإجتماعهما. والأصل ما عُرف إلا بجمعه بين الضدّين،وكذلك الفرع وهو أنت..
وهذا الذي ذكرناه في حَلّ ألفاظ هذا المنزل هو وراء وراء مشرب سيدنا (الشيخ الأكير)،فقد جَلّ سيدنا أن يرمي رامٍ مَرماه أو يحوم أحد حول حِماه..
== (الموقف التاسع بعد الثلاثمائة) ==
قال سيدنا (أي الشيخ الأكبر):
الربّ حقّ والعبد حقّ /// يا ليت شعري من المُكلّف؟.
إن قُلت عبد،فذاك ميّت /// أو قُلت ربّ،أنّى يُكلّف؟.
إعلم أن الربّ حق واجب لذاته،إذ هو عين الوجود. والعبد حق واجب بغيره،إذ هو صورة الوجود. فإرتبط الأمر إرتباط المادّة بالصورة،وإسم العبد واقع على المجموع. وقد أخبر تعالى أن هُويته سمع العبد وبصره وجميع قواه الباطنة وحواسه الظاهرة،كما في الأخبار الصحيحة. والعبد ما هو عبد إلا بقواه،فما هو إلا بالحق. فظاهره صورة خَلقيّة محدودة،وباطنه هُوية الحق غير محدودة. فالخلق بلا وجود الحق ما كان،والحق لو تجرّد عن الخلق ما ظهر..
فإذا عرفت هذا،عرفت أن المُسمى عَبداً وإنساناً: مُركّب،تركيباً معنوياً،من وجود ربّ حَقّ،وصورة هي أحكام الأعيان الثابتة في وجود الحق. ووجوده عين ذاته،فهي أعراض مُجتمعة قائمة بالوجود الحق،فهي حقّ لهذا.
فيا ليت فطنتي تَشعُر بالمُكلّف المأمور المَنهي من هذه “الهَيئة الاجتماعية”،من هو؟ فإن قلت: المكلّف منها “الشقّ الخَلقي”،وهو الأعراض المجتمعة القائمة بالوجود الذات،فهو مُحال،إذ التكليف لا يكون إلا لمن له الإقتدار على ما كُلّف به من الأفعال أو مَسك النفس في المنهيات. والشقّ المخلوق من المُسمّى عَبداً،لا إقتدار له على شيء من ذلك. وإن قلت: المكلّف هو “الشقّ الربّي” منها،فذلك أيضاً مُحال. فإن الشيء لا يُكلّف نفسه بالأمر والنهي.
والتخلّص من هذا،كَشفاً لا عقلاً،هو أن المجموع أعطي معنى لم يُعطه كل واحد على إنفراده. وقد علمت أن مُسمّى العبد هو المجموع من الصورة والهُوية. فالحق هو المسمى ربّاً وعبداً،فهو من حيث الصورة من جملة من يعبد الله،ومن حيث باطنه كما ذكرنا..
ومن أراد أن يُفرّق بين الربّ والعبد من حيث النشأة الإنسانية،ويجعل الربّ مُبايناً للعبد،مُنفصلاً عنه،كما هو مذهب جميع المتكلمين من سُنّي ومعتزلي وحكيم،ويَنسب الفعل المُكلّف به إلى الربّ أو العبد،فلا يَسلم له دليل من طَعن أبداً.
وقد أكثر إمام العلماء بالله محيي الدين،في (الفتوحات المكية) وغيرها،الكلام على نسبة الفعل لمَن هي؟ تارة بالأدلة العقلية والشرعية،وتارة بالأدلة الكشفية. فتارة يُخلصه للربّ،وتارة يجعل للعبد نسبة ما..
== (الموقف الرابع عشر بعد الثلاثمائة) ==
قال سيدنا (الشيخ الأكبر) في [باب الوصايا]،وهو الباب الأخير من الفتوحات المكية:
__ إذا قرأت فاتحة الكتاب،فصِل بَسملتها معها في نفس واحد،من غير قَطع. فإني أقول بالله العظيم: ذكر الشيخ الأكبر سَنده،إلى أن قال: قال الله تعالى لي: (يا إسرافيل،بعزّتي وجَلالي وجودي وكَرمي،من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مُتّصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة،إشهدوا عليّ أني قد غفرت له،وقَبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيّئات،ولا أحرق لسانه بالنار،وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القيامة والفزع الأكبر،ويَلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين)..
البسملة تضمّنت “الرحمة الذاتية”،وهي خاصة وعامة. والفاتحة تضمّنت “الرحمة الصفاتية”،وهي خاصة وعامة..
فأما “الرحمة الذاتية العامة” فهي المشار إليها بقوله تعالى: (ورحمتي وَسعت كل شيء). فهي التي وَسعت الأسماء والصفات والمخلوقات وكل ما يُطلق عليه شيء،حتى الرحمة الصفاتية فقد وَسعتها الرحمة الذاتية،والغضب من جُملة من وَسعته الرحمة الذاتية.. فعَمّت هذه الرحمة الوجود الحَقّي والخَلقي. ولهذا لم يَتسمّ بهذا الإسم أحد من المخلوقين،لأنه عين الوجود العام،والوجود عين الذات خارجاً،وإن كان صفتها عقلاً.
وأما “الرحمة الداتية الخاصة”،وهي من إسمه “الرحيم” المُعبّر عنها بقَدم الصدق،فهي المُشار إليها بقوله تعالى: (وبشّر الذين ءامنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم). فهي قدم الصدق المخصوص بالسّعداء،ومنها إعطاء الرسل والأنبياء الذين عطاؤهم من عين المنّة.. ومن هذه الرحمة الذاتية الخاصة،قلب المؤمن الذي وَسع الحق تعالى. فإن الرحمة الصفاتيّة لا تَسع الحق تعالى فيكون مَرحوماً..
وأما “الرحمة الصفاتية العامة” فهي التي أنزلها الله تعالى إلى الدنيا،وهي المُشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله مائة رحمة،أنزل منها واحدة في الدنيا،فيها تتراحم الخلائق) الحديث. ومن هذه الرحمة عمّت نِعَمه وعَطاياه في الدنيا،المؤمن والكافر والبَرّ والفاجر.. وهذه الرحمة لا يمتنع أن يشوبها كَدر ويُمازحها ضَرر. فلذا كانت نِعَم الدنيا لا تخلو من مُنغّص،لأن هذه الرحمة تجمع الأضداد..
وأما “الرحمة الصفاتية الخاصة” فهي الرحمة التي تخُصّ المؤمنين في الدار الآخرة،وهي رحمة محضة لا يشوبها كَدر ولا مُنغّص أصلاً بوجه من الوجوه. وبهذا كان نعيم الجنة خالصاً من الأكدار. وهذه الرحمة هي رحمة الرحيم،لا الرحمن. وهي التي سَبقت الغضب. فإذا كان يوم القيامة جمع تعالى أفراد الرحمة التي وردت في الحديث (إن لله مائة رحمة)،وجعل الحُكم لها في عباده..
== (الموقف السابع عشر بعد الثلاثمائة) ==
روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،في حديثه حول الدجال،قال: (إني أنذركموه،ما من نبيّ إلا أنذر قومه) الحديث.
إستشكل بعض الناس هذا،وقال: كيف يُنذر كل نبيّ قومه الدجال،وهو لا يخرج إلا قُرب القيامة؟ ويَبعُد أن يجهل الأنبياء كلهم هذا.
والجواب: أن كل نبي إنسان كامل،لا بد أن يتحقّق بمرتبة الواحدية،مرتبة الألوهة الجامعة. ومع ذلك لا بد أن يتميّز بغلبة تجلّي إسم مخصوص،فيتجلّى له الحق تعالى وَحياً،ويُعلّمه أنه لم يخلُق خلقاً أعزّ عليه منه،وأنه أوجده تعالى له،وأوجد الأشياء كلها من أجل ذلك النبيّ. وأنه سيُخرج في أمته مَهدي يحكُم بشريعته وينفي تحريف المائلين وزيغ الزائغين. وسيُخرج الدجّال في زمانه،أو في زمان أمّته،فيُعلم النبي قومه بذلك..
وقد ظهرت الأمور التي أخبر الله بها كل نبيّ،وأخبر كل نبي أمّته،لكنها ظهرت معاني لا صُوراً قائمة،كما ظهرت الآن في زماننا،بما ظهر من دَجل الدجّالين وزيغ الزائغين. وستظهر صور قائمة،كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم،لظهوره بالإسم الجامع المُهيمن على جميع الأسماء.. فمن حيث إندراج نبوة جميع الأنبياء في نُبوّته صلى الله عليه وسلم،ظهرت الأشياء التي أخبر بها معاني،وستظهر أشخاصاً مُعاينة تماماً في آخر الأمر.
== (الموقف العشرون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (فإذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر يقول الإنسان أين المفر كلا لا وزر) [القيامة: 7_11].
فيها إشارات وإعتبار: فإذا بَرق البَصر دُهشَ وتَحيّر،وذلك عند أوائل التجليّات،فإنه شاهد ما لم تتقدّم به معرفته ولا له به إيناس.
و(القمر) كناية عن العبد المُحدَث،وخُسوفه هو إضمحلاله وظُهور كَون وجوده مُعاراً ليس من ذاته،فهو وجود مجازي. وذلك كناية عن الحُصول في مقام الجمع،وهو رؤيته حَقّ بلا خَلق. وهو مقام خطر،مَزلّة الأقدام،ومَحلّ وَرطات الأنام. إلا من كان له المقام ذوقاً،فإن لله به عناية،فينقله إلى محلّ الأمن ويُنجيه من الإحَن. وأما من كان حصول هذا المقام له من الكتب أو تلقّفه من أفواه المشايخ القاصرين،فإن هَلاكه أقرب،ونجاته أغرب. إذ للشيطان فيه مدخل واسع وشُبهة قوية،فلا يزال إبليس معه يَستدرجه شيئاً فشيئاً يقول له: الحق تعالى حقيقتك وما أنت غيره،فلا تُتعب نفسك بهذه العبادات فإنها ما وُضعت إلا للعوام الذين لم يصلوا إلى هذا المقام.. ثمّ يُبيح له المحرمات.. فيُصبح زنديقاً إباحياً حُلولياً،يمرُق من الدين كما يمرُق السّهم من الرميّة..
(وجُمع الشمس والقمر): الشمس إشارة إلى الرب تعالى،كما أن القمر إشارة إلى العبد. وجمعهما إشارة إلى مرتبة جمع الجمع،التي هي المرتبة العليا والمنجاة الكبرى والسعادة العظمى. وهي رؤية خلق قائم بحقّ،وحق ظاهر بخلق. إذ ما ثَمّ ظهور للحق إلا بالخلق،ولا ظهور للخلق إلا بالحق. فلا وجود إلا لصورة الجمعية بينهما،من غير حلول ولا إتحاد ولا إمتزاج..
يقول الإنسان العارف: (أين المفرّ؟) لشدّة حَيرته،فإنه يحار لكثرة التجليات وإختلافها،وعدم إنضباطها،وسُرعة تَفلّتها وكثرة التنزلات الإلهية المُدهشة للعقول،المُحيّرة لها،مع وحدة العين المُتجلية..
(كلا لا وزر): لا ملجأ ولا مَنجا،رَدْع للعارف،حيث يُريد الخروج من الحين ليَستريح،وراحته ومعارفه فيها. فإن الحيرة تزيد بزيادة التنزلات،وهي عين المعارف..
== (الموقف الثاني والعشرون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (ومن يقل منهم إنّي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم) [الأنبياء: 29].
قيّد تعالى الوعيد في الآخرة.. ولا وعيد في الآخرة على من يقول من المخلوقين: “إنّي إله”،إذا أشهده الحق سَريان الألوهية في العالم،كسريان الوجود الحق في العالم. ولكنه حقّ لا يُقال،إذ ما كل حقّ يُقال،كما أنه ما كل حق يُحمد في جميع المواطن،ولا كل باطل يُذمّ في كل المواطن.
فالقائل: إنه الله،في الدنيا،مذموم،وإن كان حقاً.. فالحصر الموجود في هذا الموطن الدنياوي،يرُدّ قوله إنه الله،لأنه يجوع ويعطش وينام..
فإذا قال هذا،وعقله معه،تناولته سُيوف الشريعة والحقيقة،وأهرقت دمه،كما وقع لحسين بن منصور الحلاج،فإنه قال ما قال،وظاهر الأحوال تدلّ على أن عقله معه. فقُتل بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة..
وأما إذا قال: “أنا الله”،في حال غلبة سُكر وحال،فهو غير مكلّف،فإن شرط التكليف العقل،وقد زال..
وإذا قالها بإذن إلهي،كأبي يزيد وأضرابه،فهذا الصنف يَحميه حاله من أن تناله أيدي الأغيار..
== (الموقف الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حيّ) [الأنبياء: 30].
أخبر تعالى أنه جعل،بإرادته وقُدرته،كل شيء حي من الماء. والجَعْل هنا بمعنى التّصيير،أي صَيّر الماء على صورة لم يكن عليها. والمُراد: صورة كل شيء،لا روحه. فإن روح كل شيء من نفس الرحمن. والمُراد بالشيء هنا الموجود،لا الشيء المعدوم،فإنه لم يتعلّق به جَعْل..
(وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده): فالحياة لازمة للوجود،اللّزوم البَيّن. فكل موجود حَيّ بحياة،حسب إستعداد صورته ومرتبته. فالأعراض حيّة بحياة حسب إستعدادها،إذ الأعراض موجودة،فإن حقيقة العرض هو ما لو وُجد لكان في موضوع. فالأعراض حية بحياة مستقلة غير حياة موضوعاتها. وكذلك الأشكال والهيئات والأقوال والأعمال. وقد ورد في الأخبار الصحيحة: أن الأعمال تكون صوراً تُخاطب صاحبها،وأنها تُؤنس صاحبها في القبر إن كانت أعمالاً صالحة،وتوحشه إن كانت سيّئة..
والحياة وإن كانت حقيقة واحدة،وهي حياة الله لا غيرها،فظهورها في الصور مُتنوّع. فتختلف لإختلاف قبول الصور للحياة: فحياة المُسمى عرضاً غير حياة المسمى جوهراً،غير حياة المسمى جماداً أو نباتاً أو حيواناً أو إنساناً..
ثمّ إعلم أن هذا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ،ما هو الماء المحسوس الذي هو أحد أركان الطبيعة،وإنما هو “ماء نهر الحياة الطبيعية الذي هو فوق الأركان”،وهو الذي ينغمس فيه جبريل كل يوم غمسة،وينتفض فيخلق الله في كل قطرة مَلكاً،كما ورد في الخبر النبوي. وهو النهر الذي يُلقى فيه من يخرج من النار بالشفاعة فينبُتون،كما ورد في صحيح البخاري. ونهر الحياة عبارة عما ورد في الخبر: (أول ما خلق الله جوهرة فنَظرها بعين الجلال،فذابَت حَياء عندما تحقّقت نَظرهُ،فسالَت ماء أكَنّ فيه جواهر علمه ودُرَره) الحديث،وورد بروايات أخَر،وكلها كناية عن “الحقيقة المحمدية” التي هي هَيولى العالم وحقيقة حقائقه ومادة كل ما سوى الله تعالى.. والماء المحسوس،وباقي الأركان الطبيعية،صور من صُوره..
ومجموع الأركان،من حيث معاني صُورها،هو الطبيعة العُليا،وهو الماء الذي جعل منه كل شيء حيّ،وهو موجود في كل رُكن من الأركان الأربعة المحسوسة.. وليس عندنا إلا صورة طبيعية أو عنصرية،والعناصر صور طبيعية،والصور الطبيعية صورة العرش والكرسي وفلك البروج وفلك الثوابت،فهي لا تَقبل الفناء والإضمحلال،وكذا صور أهل الجنة في الجنة.. فالطبيعة عبارة عن الأركان الأربعة إذا تآلفت تألّفاً خاصاً،حسب ما يُناسب ذلك الإئتلاف بتقدير العزيز العليم. فلذلك إختلفت صور العالم لإختلاف ذلك المزاج،فأعطى كل صورة في العالم بحسب ما إقتضاه مزاجه..
وصور سائر العالم عنصرية،فلذا قَبل الإنحلال والفناء. وصور أهل النار عنصرية،فلذا قَبلت النّضج والإحتراق وتبديل الجلود. وكذا صور الملائكة كلهم عنصرية،فجبريل وميكائيل وغيرهما من ملائكة السماوات والأرض،ما عدا المُهيّيمن والعقل الأول والنفس،كلها طبيعية عنصرية..
== (الموقف الواحد والثلاثون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (ولا نُكلّف نفساً إلا وُسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون) [المؤمنون: 62_63].
أخبر تعالى أنه ما كلّف نفساً،حسب وُسعها وإطاقتها،إلا لكونه تعالى عنده كتاب ينطق بالحق،وهو “كتاب علمي ثُبوتي”. إذ كل عين عين،من الأعيان الثابتة،وهي الحقائق الممكنة المعدومة أزلاً وأبداً،لها كتاب فيه جميع ما تكون عليه إذا وُجدت إلى ما لا نهاية له في دار السعادة والشقاوة..
فإن كتابهم منهم صَدر،بل هو كناية عنهم لا غير. ونُطقه بالحق طَلبه إعطاء الوجود الخارجي الحسّي للأحوال التي هم عليها في الثبوت العلمي،من غير زيادة في الكتاب ولا نقص منه..
فما كَلّفهم،تكليف أمر وإرادة،إلا أنفسهم،فمنهم وإليهم. وليس للحق تعالى إلا إعطاء الوجود لما في وُسْع النفوس وإطاقتها وطلبها لذلك بلسان إستعدادها..
وليس هذا الكتاب هو الكتاب المُشار إليه بقوله تعالى: (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون). فإن هذا الكتاب “مكتوب عن وُجود”،والكتاب الذي كلامنا فيه “عدم مكتوب عن عدم”..
(بل هم في غمرة من هذا): لأنهم في غَمرة وحجاب وجَهل،من هذا،في موطن الدنيا،دار التكليف والإمتحان. وقد كان للأرواح،المُعبّر عنها بالقلوب،علم بهذا الكتاب.. فلما تعلّقت بهذه الأجسام الطبيعية العنصرية،نَسيته وصارت في غمرة،وهي جهلهم بكتابهم.. وهذه حالة الأرواح،كلما إنتقلت من موطن نَسيت ما كانت فيه..
ولما كانت كل عين عين،إمكانية ثُبوتية،لها أحوال وأفعال في مرتبة الثّبوت،لا تظهر أي عين في مرتبة الوجود الحسّي إلا بها. أخبر تعالى أن لهم أعمالاً ثُبوتية في مرتبة الثّبوت،هم عاملون عليها،من دون ذلك من مرتبة الوجود الحسّي،لا بد أن يعملوها. وفي هذا إشارة إلى إثبات مرتبة بين الوجود الحسّي والعدم المحض. وهي المرتبة التي نفاها أهل السنة،وأثبتها الحكماء والمعتزلة والصوفية،أهل الكشف والوجود والتحقيق. الذي لا أحقّ منه ثُبوت هذه المرتبة. وجميع الأعمال الممكنة مُتحيّزة فيها بأحوالها ونُعوتها. وأحوالها هي التي توجد في مرتبة الحسّ،فهي مُفتقرة إلى الفاعل الموجد تعالى. وأما الأعيان ذاتها فهي ثابتة لا بجعل جاعل وفاعل،فإنها حقائق معلومة لا مفعولة.
== (الموقف الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى،في وصف رُسله: (الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله) [الأحزاب: 39].
ما خافَ رسول من المُرسَل إليهم،من حيث تبليغ الرسالة،قط. كيف وهو تعالى يقول: (إني لا يخاف لديّ المُرسلون)..
وقول موسى: (ولهم عليّ ذنب فأخاف أن يقتلون) فما خاف إلا من الله تعالى أن يُسلّطهم عليه بذنبه..
ويقول تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه). والرسل لا ولاية للشيطان عليهم ولا سبيل له إليهم..
ومنشأ الخوف من النفس الحيوانية،وغَلبة الطبيعة على العقل والإيمان. وهم عليهم السلام حَيوانيتهم الطبيعية مقهورة تحت العقل والإيمان،فإنهم مؤيّدون بروح القدس،وهو الروح الأمري الذي يكون به التأييد،وهو غير الروح المنفوخ في الأجسام الطبيعية. وهو الذي إمْتَنّ به تعالى على عيسى في قوله تعالى: (إذ أيّدتك بروح القدس)..
فإن قلت: قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحرَس حتى نزل قوله تعالى: (والله يعصمك من الناس)..
فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم،كسائر الرسل،كان مُشرّعاً بقوله وفعله. فأخبر الله تعالى بعصمته بعد حصول التشريع،فكان كمالاً في كمال. فإن الله تعالى ببديع حكمته قد أثبت في قلوب عباده وجود الأسباب،وما كلّف عباده الخروج عن الأسباب،فإن حقيقة العبد تقتضي السّبب.. وكان يَغلب على ظاهره شُهود الإسم الحكيم،وهو الذي إقتضى وجود الأسباب.. فيلزم ضُعفه وإمكانه وإفتقاره،فلا يرى أضعف منه في العالم،مع قوله تعالى له: (ليس لك من الأمر شيء).
فلا يأمُر بكُن،ولا يُكوّن بأمر،ولا يفعل بهمّة،إلا لضرورة نادرة بأمر الله تعالى له. فلا يلزم من أمره صلى الله عليه وسلم بحراسته خَوفه من الأعداء. وكما عَصَمَ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من القتل،فقد عَصم جميع رُسله من القتل. فما قُتل رسول من الرسل (المُشرّعين) قط،لا في الحرب ولا في غير الحرب،ولا إنهزم ولا خاف غير الله تعالى..
فإن قيل: قد قال تعالى: (قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلِمَ قتلتموهم).. فاعلم أن المُراد بالرسل المقتولين في الآيات،المعنى الأعمّ،وهو إطلاق لفظة الرسول على مطلق النبيّ الذي يوحى إليه،سواء جاء بشَرع ناسخ لشرع من قبله من الرسل أم لا،جاء بكتاب أم لا.. وقد ذكر تعالى فيما نَعاه على بني إسرائيل من قتلهم أنبياءهم،وصرّح بلفظ النبي،فقال: (ويقتلون النبيين بغير الحق).. والمُحكى عنهم في الآيات هم بنو إسرائيل،وما جاء نبي من أنبياء بني إسرائيل،الذين بين موسى وعيسى،بكتاب يتضمّن أحكاماً تُخالف أحكام التوراة،ولا بشريعة ناسخة لشريعة موسى،حتى عيسى إنما نَسخ بعض أحكام جُزئية من أحكام شرع موسى،ولذا قال: (ولأحلّ لكم بعض الذي حُرّم عليكم)..
وقول بعض العلماء من المفسرين: الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم كلهم رُسل،ليس بشيء. فإن إدريس ذكره تعالى في القرآن بالنبوة،وهو قبل نوح بإجماع أهل الملل. ونوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض. وزكرياء ويحيى،ليسا برسولين،وإنما هما من جملة أنبياء بني إسرائيل. وعيسى ويحيى كانا في عصر واحد في أمة واحدة. وما بعث الله تعالى رسولين لأمّة واحدة في زمان واحد،غير موسى وهارون. وأما الزبور الذي أنزل على داود،إنما هو مواعظ وحِكَم،لا أحكام فيه أصلاً. وكان داود يحكُم بشريعة التوراة،شَرع موسى.. والقرآن الكريم إذا عبّر بالزّبر،فالمُراد الكُتب المقصورة على الحكم والمواعظ. وإذا عبّر بالكُتب،فالمراد ما يتضمّن الشرائع والأحكام. قال تعالى: (فإن كذبوك فقد كُذّب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبُر والكتاب المنير). فلفظة الرسل كُلّ من يوحى إليه،جاء بشرع مُستقلّ أم لا. فغير المُستقل هم الذين جاءوا بالزّبر،كداود. والمُستقلّون بشرع هم الذين يأتون بالكتاب المنير.. فلما كان لفظ الرسول هنا أعمّ،يعُمّ الرسول المُشرع والنبي غير المُشرع،قال “كُذّب” وما قال “قُتل”..
فجميع أنبياء بني إسرائيل،الذين بين موسى وعيسى،كانوا أنبياء داعين إلى التوراة،ما كانوا رُسلاً مُشرّعين إستقلالاً،كالكُمّل من علماء هذه الأمة المحمدية،أهل الدوائر الكبرى من أولياء هذه الأمّة. فهؤلاء الأنبياء هم الذين كانت تقتُل منهم بنو إسرائيل،تارة تَقتُلهم المُلوك لمُخالفتهم إياهم وإنكارهم عليهم،إذا جاروا في أحكامهم وخالفوا التوراة.. وتارة تقتلهم الغوغاء من العامة،لإنكارهم عليهم المُنكرات. كان الحسن البصري إذا رأى الغوغاء مُجتمعة يقول: [هؤلاء قَتلة الأنبياء]..
== (الموقف السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (ليس كمثله شيء) [الشورى: 11].
قد تكلمنا على هذه الآية في هذه المواقف بلسان غير اللسان الذي سنورده..
فاعلم أن هذه الآية وردت رَدّاً على المٌنزّهة تَنزيههم المطلق الذي إقتضته العقول،وعلى المُشبّهة تَشبيههم المطلق،حتى أدّى ذلك بعضهم إلى الحلول والإتّحاد..
المُشبّهة لما رأت التشبيه الشرعي،وهو ليس بتشبيه في الحقيقة ــ لأن التشبيه إنما هو ب”الكاف” ولفظة “مثل”،وما عداه فهو إشتراك في الألفاظ ــ تَخيّلت أنه تشبيه مطلقاً في جميع المراتب،فإعتقدت تشبيه الإله بمخلوقاته،فضَلّت وأضلّت.
وكذلك المُنزّهة لما رأت التنزيه الشرعي الوارد في الكتب وعلى ألسنة الرسل،توهّمت أن ذلك التنزيه المطلق في جميع المراتب،فجهلت وخسرت،وفاتها علم كبير عظيم،وهي علوم التجليات.. إذ التنزيه العقلي غير التنزيه الشرعي: فالتنزيه الشرعي عبارة عن إنفراد الحق تعالى بأسمائه وأوصافه كما يستحقه لنفسه بطريق الأصالة،لا بتنزيه مُنزّه ولا باعتبار المُحدث،ماثَله أو شابهه،فليس بإزاء التنزيه الشرعي تشبيه،بخلاف التنزيه العقلي فإنه في مقابلة تشبيه،والحق تعالى لا يقبل الضدّ..
والتشبيه الشرعي عبارة عن الجمال الإلهي،لأن الجمال الإلهي له معانٍ،وهي الأسماء والصفات الإلهية،وهي تجليات تلك المعاني،فيما يقع عليه المحسوس كقوله صلى الله عليه وسلم: (رأيت ربّي في صورة شاب أمرد) الحديث،والمعقول كقوله تعالى: (أنا عند ظنّ عبدي بي،فليظنّ بي ما شاء) الحديث القدسي. فهذه الصورة هي المرادة بالتشبيه في الشرع.
والتنزيه العقلي عبارة عن تَعرّي الشيء عن حُكم كان يُمكن نسبته إليه،فتتنزّه عنه. ولم يكن للحق تعالى تشبيه ذاتي يستحق التنزيه عنه،إذ ذاته هي المُنزّهة نفسها عما لا يستحقه ولا يقتضيه كبرياؤه.. ولهذا قال المحققون من العلماء بالله: [كمالات الحق تعالى لا ضدّ لها ولا نقيض].. ورُوي عن الإمام القطب أبو يزيد البسطامي أنه قال: قُلت: “سبحان الله”،فقيل لي: “هل رأيت أنّي أقْبَل نَقصاً فنزّهتني عنه،إرجع إلى نفسك فنَزّهها”،فرجعت على نفسي فإشتغلت بتنزيهها،فلما تنزّهت صرت أقول: “سُبحاني ما أعظم شأني”..
وقد أجمع أهل الكشف والوجود أنه لا مجاز أصلاً في كلام العرب،وأن كل ما ورد مما يُقال فيه تشبيه هو موضوع لذلك المعنى حقيقة. ومن إدّعى غير هذا فعليه إثباته،ولا سبيل إلى ذلك.. فلا تشبيه إلا بكاف الصفة أو لفظة مثل..
قال الله تعالى: (سبحان الله عما يصفون) بعني بعقولهم. ثمّ إستثنى فقال: (إلا عباد الله المُخلَصين) وهم الأنبياء والرسل ووَرثتهم من الأولياء،فإنهم ما وَصفوه تنزيهاً وتشبيهاً إلا بما علّمهم به لا بعقولهم..
فالمُنزّه على الإطلاق،كما قال مَظهر الصفة العلمية محيي الدين الحاتمي: إما جاهل،يعني بما ورد في الكتب الإلهية والأخبار النبوية،من التشبيه والجمع بين التشبيه والتنزيه. وإما صاحب سوء أدب،يعني بنَفيه ما أثبته تعالى لنفسه وأثبتته له رسله،ورَدّ ما وَرد من التشبيه إلى التنزيه العقلي بالتأويل الذي يستحسنه عقله. ويستمر عليه سوء الأدب مع الله،دنيا وآخرة،فيتعوّذ بالله حين يتجلّى له في صورة لا تُعطي تنزيهه العقلي،كما ورد في الصحيح.. والذين يتعوّذون من الله هم غير العارفين به تعالى،من مُنزّه ومُشبّه،وهم الذين حَصروه وقيّدوه..
ونسبة هذه الأشياء والنّعوت والصفات إليه تعالى،ليست كنسبتها إلى المُحدثات،فإن ذاته مجهولة.. كما قال الإمام مالك: [الإستواء معلوم والكيف مجهول،والسؤال عنه بدعة]. فهذه عقيدة سَلفنا الصالح،وهذا معنى تفويضهم،لا أنهم يقولون إن الحق تعالى خاطبهم بما لا يفهمون معناه..
== (الموقف السابع والثلاثون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (وربك يخلُق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخِيَرة) [القصص: 68].
إعلم أن الحق تعالى ما تَمَدّح بشيء من نِسَب الأفعال،أو من الصفات،كتَمدّحه بنسبة الخلق،من حيث الخلق خصيص بالإله. والمُراد خَلق الموادّ والأجناس،وقد خلقها تعالى وتناهَت،وهذا هو الخلق الحقيقي. وما بَقي الخلق إلا في الأحوال والأكوان،وهذا الخلق هو الذي شارك فيه المخلوق الحق تعالى،كتحريك الساكن وتسكين المتحرك مثلاً،وهو المُشار إليه بقوله تعالى: (أحسن الخالقين)،لا الخلق الحقيقي فإنه لا شركة فيه أصلاً،وهو الذي تَمدّح به تعالى.
ولهذا ترى الكُمّل من أهل الله،إذا أعطاهم الله الخلق والتكوين ب”كُنْ”،لا يرونه غاية الأمر ونهاية الكمال،لعلمهم أنه خلق مجازي لا حقيقي..
والإختيار المنسوب إلى الرب تعالى معناه أنه لا مُكره له،يفعل إذا شاء ولا يفعل إذا لم يشأ.. ولهذا قال بعض أهل الله: [المشيئة عرش الألوهة] يعني: بالمشيئة ثَبتت للحق تعالى الألوهية.. فالإختيار المنسوب إليه تعالى هو لدَفع ما يتوهّم أن فعله تعالى لمفعولاته هو كفعل العلّة،وهو التردّد بين الشيئين،ثمّ يقع الإختيار والإعتماد على أحدهما،فإن الإختيار بهذا المعنى مُحال على الربّ تعالى.. قال تعالى: (وما يُبدّل القول لديّ)،(وتمّت كلمت ربّك)..
(ما كان لهم الخِيَرة): و”ما” يصحّ أن تكون نافية بوجه،ويصحّ أن تكون موصولة بمعنى الذي بوجه آخر.
فأما أن تكون “نافية”،وهو المعروف عند العامة،فإنه تعالى نَفى الإختيار عن مخلوقاته فيما هم فيه مُختارون له،فهم مجبورون على الإختيار فيما يختارون ويشاؤون: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله). وذلك في مرتبة الحسّ والوجود العَيني،لا في الباطن والثّبوت..
وأما وجه كون “ما” موصولة،بمعنى “الذي”،والواو للإستئناف. فهو من حيث ثُبوت الأعيان وإستعدادها وطلبها لما هي مُستعدة له،قابلة من الربّ تعالى بلسان الإستعداد.. فيُعطيها،حالة الإيجاد الحسّي العيني،طلبها الثبوتي ومُختارها.. (ما كان لهم الخيرة) أي الذي كان مُختارهم في الأزل ومطلوبهم بالإستعداد القديم الثبوتي..
== (الموقف الثامن والثلاثون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (قد أفلح من تزكّى وذكر إسم ربه فصلّى) [الأعلى: 14_15]،وقال تعالى: (قد أفلح من زكاها) [الشمس: 9].
إعلم أن الإنسان مجموع لطيف وكثيف،وعال وسافل،ونور وظلمة. فإنه من أب وأمّ: فأبوه الروح،وأمّه العناصر والطبيعة. فصفات الأب،الروح،كلها خَير محمودة ممدوحة. وصفات الأمّ،الطبيعة،مذمومة. ولما نزل الروح الجزئي إلى تدبير الجسم العنصري الطبيعي،وإشتغل بتدبيره،شغل بحُبّه وتَعشّق به.. لأنه أدرك بالتعلّق به،أشياء ما أدركها في عالمه الروحاني،فإنه أدرك الجزئيات ولم يُدرك في عالمه إلا الكلّيات. فإنغمس لذلك في مُقتضيات الطبيعة،وسَعت في مطالبها الشهوانية والأمور الجسمانية. ثمّ إذا أدركتها العناية الإلهية والسابقة الربانية،تَنبّهت وتفطّنت وتفكّرت فيما هي فيه،فوجدت نفسها في مَهواة التّلف والغلط. فحينئذ أخذت في الإلتفات عن الجسم ومقتضيات الطبيعة الشهوانية،بحسب الطاقة،وصارت تنسلخ من الصفات الحيوانية بالرياضات النفسانية والمجاهدات الجسمانية،وهذا هو التزكية والطهارة..
الإنسان مجموع من خير وشرّ،صفات بهيمية حيوانية وصفات مَلكية قُدسية. فإذا غلبت صفات الجسم الطبيعي،لَحق بالبهائم،بل وبالشياطين. وإذا غلبت صفات الروح،لحق بالملأ الأعلى،عالم القُدس والطهارة. بل الإنسان الكامل له اللحاق بخالقه تعالى،فإنه مخلوق على الصورة الإلهية،وهي باطنة فيه،فله التخلّق والتحقّق بالأسماء الإلهية كلها..
وليس المُراد من التزكية إعدام الصفات الطبيعية ومَحوها رأساً،كما يتوهّم،فإنه مُحال،إذ طينة الإنسان معجونة بها مُركبة معها. وإنما المراد عَزْل الطبيعة عن الإستبداد،ومَنعها عن الإسترسال في الأمور السفلية الشهوانية. فإن الله تعالى ما أنْعَم على الإنسان بالعقل إلا ليُقابل به القوة الشهوانية،ويرُدّها إلى حُكم الشرع والعقل. ولهذا لما كانت الملائكة الكرام لا شهوة لهم،لم يجعل الله لهم عقولاً. فكل من لا شهوة له،لا عقل له..
فحاصل تزكية النفس هو جعلها تحت الميزان الإلهي،وهو ما جاء به الشارع ونزل به القرآن الكريم. فإنه تعالى قائم بالقسط وبيده الميزان،وهو إعطاء كل ذي حق حقّه،من غير زيادة ولا نُقصان..
== (الموقف الواحد والأربعون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (ونحن نُسبّح بحمدك ونُقدّس لك) [البقرة: 30]،(وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) [البقرة: 32]..
ليس للملائكة شُهود الحق تعالى إلا في الهُوية،وهي مرتبة التنزيه المطلق. فإن للحق تعالى مرتبتين: مرتبة الذات الهُوية،ومرتبة الألوهية. فما ورد في الكتب الإلهية والسنة المحمدية من التنزيه،فهو مَصروف إلى مرتبة الذات الهُوية. وما ورد من التشبيه،فهو مصروف إلى مرتبة الألوهية.
والملائكة الكرام أرواح مجردة عن المادة،فإنها عالم الأمر الموجود عن الحق تعالى بلا واسطة مادة ولا سَبب،غير قوله تعالى”كُنْ”. فإنها أرواح منفوخة في أنوار،فليست لها القوة المتخيّلة حتى تتخيّل الحق تعالى وتَشهده في الصورة الخيالية والحسية والمعنوية،كما يَشهده الإنسان في الصور كلها،ويَشهده في الهُوية مجرداً عن الصور كلها لما خَصّه الله به من الكمال..
واعلم أن المَلك هو عين الخيال،وحقيقة الخيال التحول وعدم الثبات.. فلهذا فالمَلك دائم التحوّل في الصور،لا يثبُت على صورة واحدة،هذا من صفاته الذاتية.
ولما كانت الروح الإنسانية من جنس المَلك،كان لها التحول في الخواطر دائماً،ولا تثبت على صورة واحدة،وهذا ضروري لمن راقب حاله،وقد قال بعض المُراقبين: [إن الإنسان يخطُر له في كل يوم سبعون ألف خاطر]،وهي الصور التي يتحول فيها..
والتطور في الصور إنما هو في مدرك الرّائي،وإلا فالمَلك على صورته التي خلقه الله عليها،وهكذا كل روح تشكّل من ملك وجن وإنسان مُتروحن..
وحيث كان المَلك لا مُتخيّلة له ولا عاقلة،كانت علوم المَلك وإدراكاته كلها كُليّة،ولا فرق عندها بين حَسن وقبيح،كما هو عندنا،فلا تُدرك من جميع المُدركات إلا جمال الكمال،لا الجمال المقيّد. فلا تُدرك من كل شيء إلا الجمال المعنوي،فلا تلتذّ برؤية الصور الجميلة عندنا ولا تتأذّى برؤية الصور القبيحة. وما ورد أن الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه الإنسان،فإنما ذلك عند تشكلها بالصور..
== (الموقف الثاني والأربعون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) [التين: 4].
إعلم أن الله تعالى خلق الإنسان على صورة ما خَلق عليها أحداً من المخلوقات،وهي الصورة الإلهية التي هي خاصة بالإنسان. وأبدعه على شكل وهيئة ما جعلها لشيء من المُبدَعات،وجعلها بين لطيف وكثيف. فهو من اللطائف بلطيفه،ومع الكثائف بكثيفه. فالصورة الإنسانية أكمل صورة وأفضلها،فهي أفضل وأكمل من صورة الملائكة الكرام. وخصّه تعالى ب”القوة الخياليّة” التي يتصرّف بها في الواجب والمستحيل،فضلاً عن الممكن،ويحفظ بها المحسوسات بعد غيبتها عنه. وجعل تعالى هذه القوة الخيالية محلاً تجتمع فيه جميع المدركات،ولذا سُميت ب”الحسّ المشترك”. إذ كل قوة من قوى الإنسان لها إدراك يخُصّها لا تتعداه في العموم،فلولا إجتماعها عند حاكم واحد أدرك الجميع ما صحّ الحُكم عليها. كقولنا: “هذا الأبيض حُلو”،فإن الذائقة ما أدركت إلا الحلاوة،والبصر ما أدرك إلا اللون،والذي إجتمع عن إدراك الذوق وإدراك البصر حُكم بأن هذا الأبيض حُلو وهو السكر مثلاً. ولو تجرّدت الروح الجزئية عن صورتها العنصرية الطبيعية،التي هي مركبها،ما تخيّلت ولا أدركت الأشياء إلا إدراكاً كُلياً كإدراك الملائكة،ولهذا أحبّت الأرواح أجسامها وصورها الطبيعية ولم تُفارقها عند الموت إلا بكُره..
الأرواح إذا تجرّدت عن المواد العنصرية والأجسام الطبيعية،التجرد التام،لا تلتذّ ولا تتألّم،ولا يَحكم عليها سُرور ولا حُزن،وكانت الأشياء عندها علماً فقط. لأن التلذّذ والتألّم الروحاني إنما سببه إحساس الحس المشترك بما يتأثر له المزاج من المُلائم والمُنافر..
ولما خصّ الحق تعالى الإنسان بالقوة المُتخيّلة،دون المَلك،أمره الشارع أن يتخيّل معبوده في عبادته: (أن تعبُد الله كأنك تراه). فهو المأمور أن يجعل لمعبوده صورة يخلقها كيف يشاء،حسب إستعداده،وهو تعالى ينفخ في تلك الصورة روحاً.. والإذن الحاصل في تخييل الحق تعالى في العبادة هو مع الإطلاق عن كل صورة.. غير أن الصور التي يخلقها الإنسان تبقى باطنة في خياله،إلا إذا كان من الكُمّل،فإنه يخلُق ما شاء من الصور خارج خياله يُشاهدها ببصره ويُكلّمها وتُكلّمه وتبقى ما دام مُلاحظاً لها،فإذا غفل عنها إنعدمت..
== (الموقف الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة) ==
قام الشيخ الأمير،في هذا الموقف،بشرح أبيات للشيخ الأكبر شرحاً عرفانياً،وقام بحَلّ مستغلقاتها،والأبيات هي:
لا تَعجبوا من حَديثي جلّ عن عجب /// حقيق قَولي بلا لغو ولا كذب.
وَلدت جَدّي وجدّتي وبعدهما /// أبي تَولّد عن أمّي وأيّ أب.
وبعد ذا وَلدوني بعد كَوني أنا /// ووالدي البرّ توأمان في صُلب.
وكنت من قبل في الحُجور تُرضعني /// بطيب ألبانها الأمات لا ترب.
وليس يَدري الذي أقول غير فتى /// قد جاوَز الكون من عين ومن رُتب.
== (الموقف السادس والأربعون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (وفوق كل ذي علم عليم) [يوسف: 76].
إعلم أن الإمام الكبير العارف بالله الكامل،عبد الكريم الجيلي،إنتقد في كتابه (الإنسان الكامل) على الشيخ الأكبر محيي الدين الحاتمي ثلاث مسائل: إحداهنّ في (باب العلم)،وثانيهما في (باب الإرادة والإختيار)،وثالثها في (باب القدرة). ولا أدري كيف إحتجب وجه هذه المسائل الثلاث عن الإمام الجيلي،ومن أين جاءته هذه الغفلة وسَرى إليه هذا السّهو،فإن مرماه غير مرمى سيدنا الشيخ الأكبر. وما ذاك إلا لينفرد الحق تعالى بالكمال المطلق..
ذكر الشيخ مصطفى البكري،في شرحه لورد السّحر،أنه كان بصالحية دمشق رجل من الصالحين هَمّ بشرح عَينيّة الإمام الجيلي،فرأى الشيخ محيي الدين في المنام فنَهاه عمّا هَمّ به وقال له: (لا تفعل فإنه رماني بثلاث حَصيات)،فأوّلها بإنتقاده الثلاث مسائل..
قام الشيخ الأمير بمناقشة هذه المسائل الثلاث،فقال: فأراد هذا العاجز أن يُبيّن مقصود شيخنا وسيدنا محيي الدين بما قال،كما نقله الإمام الجيلي،ولا أناقش كلام الإمام الجيلي كلمة كلمة أو جملة جملة،إلا ما لا بد منه. وإني أعلم أنّي لا أكون قطرة من بحر الإمام الجيلي،ولكن من عرف الحق عرف أهله،ومن عرف الحق بالرجال تاهَ في مَهامه الضّلال..
يقول العبد العاجز،والقائل شيخنا الروحاني محيي الدين،والعبد مُترجم عنه.. فإن جميع ما حَصل لنا من الخير،بعد الإيمان بالله ورسوله،هو بواسطته..
_ (المسألة الأولى: مسألة العلم): قال الشيخ الجيلي في (باب العلم): [ولا يجوز أن يُقال إن معلوماته أعطته العلم من نفسها،لئلا يَلزم من ذلك كونه إستفاد شيئاً من غيره. ولقد سَهى الإمام محيي الدين بن العربي فقال: إن معلومات الحق أعطته العلم في نفسها. فلنعذُره ولا نقول ذلك مبلغ علمه..]. يقول العبد: مُحصّل الإنتقاد في مسألة العلم،هو مَنع كون علم الحق بالمعلومات مُستفاداً منها،لما يلزم من ذلك كونه مُفتقراً إلى الغير،وإثبات أنه تعالى عَلم المعلومات أولاً بمُقتضياتها،وما إقتضت شيئاً من نفسها في تلك الحضرة الأولى والعلم الأول،ثُمّ إقتضت ما علمها عليه أولاً فحَكم بها ثانياً بما إقتضته. وهذا الكلام من الإمام الجيلي راجع إلى الفرق بين إسمه تعالى (العليم) وإسمه (الخبير)،فإنه تعالى (العليم الخبير). وهو إنه إذا كان الإدراك للمعلوم والإنكشاف من حيث المُدرِك،لا باعتبار شيء آخر،كان ذلك الإدراك علماً والمُدرِك عالِماً. وإذا كان ذلك الإدراك للمعلوم والإنكشاف من حيث المعلوم،كان ذلك الإدراك والإنكشاف خبرة،والمُدرِك خبيراً. وهو المُستفاد من المعلوم،وهو علم مع ذوق،المُشار إليه بقوله تعالى: (ولنبلونكم حتى نعلم)،(وليعلم الله الذين ءامنوا).. وهذا الذي أشار إليه الإمام الجيلي إنما هو في العلم بالغَير والسّوى في مرتبة الفرق والتمييز الحقيقي،حيث كان العلم نسبة من النّسب الإلهية تَعيّن في العلم الذاتي كما تعيّنت جميع النّسب الإلهية والكونية. وكلام سيدنا الإمام محيي الدين في العلم الذاتي،الذي هو إدراك الذات بالذات،لا بأمر زائد،لا علم ولا غيره. وقد أجمع أهل هذا الشأن،الراقون إلى ذروة التحقيق بالشهود والعيان،على أن أول تعيّن للذات من الغيب المطلق هو المرتبة المسماة عندهم ب”الوحدة المطلقة”،وهو عبارة عن علمه تعالى ذاته بذاته من ذاته،وعلمه بجميع أسمائه وبجميع المعلومات الحسية والعقلية والخيالية على وجه الإجمال من غير تمييز بعضها عن بعض.. فهو العالَم والعلم والمعلوم،والتغايُر إعتباري.. فعَلم العالَم من علمه بذاته،إذ العالَم في هذا الطور والمرتبة عين الذات.. فلا يتوهّم أحد أن الممكنات بأنواعها لها وجود في هذه المرتبة في ذات الله تعالى،ولو وجود إجمال،فإنه لا يصحّ عقلاً ولا شرعاً. فإن الشيء،في حدّ القوة،لا يُقال إنه شيء،لأنه مُخْتَف وكامن بالنسبة إلى نفسه وإلى غيره. ففي حضرة العلم الذاتي ليس إلا عين الذات،والأشياء معدومة في أنفسها،وحُكمها حُكم العدم.. والتفصيل مُستحيل في حضرة الوحدة المطلقة الذاتية،لمُنافاتها المُغايرة المُؤذنة بالكثرة،وهما مُتقابلان. فالحقائق التي في العلم كانت كامنة في الذات قبل تعلّق الذات بنفسها،قبليّة إعتبارية،فظهرت الحقائق في الذات بالذات على نحو ما ظهرت في الحسّ. وفي التحقيق الأحقّ أن الحقائق الذاتية ما ظهر في العلم الإلهي إلا ظلالاتها،كما أنه ما ظهر من تلك الظلالات إلى الحسّ إلا ظلالاتها أيضاً. فالأشياء من حيث معلوميتها له تعالى أزلاً أزليّة،ومن حيث ظهورها بالوجود أبديّة. فالذات من حيث أنها علم مُتأخّرة عن نفسها،ومن حيث أنها عالِمة مَعلومة. والترتيب عقلي،إذ لا زمان.. ثمّ إعلم أن العلم مطلقاً،في القديم والحادث،عند المحققين من أهل الكشف والوجود،لا يتعلّق إلا بموجود،وإذا تعلّق بمعدوم فلتعلّقه بمثله الموجود.. فالعالَم كله مع الإنسان،خُلق على الصورة الموجودة القديمة. فالعلم المُتعلّق بالحادثات أزلاً،إنما حصل،ولم يزل حاصلاً،لكونه على الصورة الإلهية.. فإذا فهمت ما أوردناه،علمت أن الحق تعالى أخذ معلوماته من ذاته بذاته. فالذات المطلقة أعطت العلم بها وبما يكون عنها،إلى غير نهاية،ذاته المُقيّدة بأول تقييد وتعيّن عندما تجلّى وظهر بذاته على ذاته. فهو عالِم وعلم ومعلوم،باعتبارات ثلاث،من غير إعتبار شيء زائد على الذات من إسم أو وَصف أو كَون. وبهذا التجلّي حصلت أعيان المعلومات في العلم الذاتي،ثُبوتاً لا وجوداً،فسُميت أعياناً ثابتة وشُؤوناً،حصلت في العلم الذاتي بإستعداداتها الكُلية والجزئية وأحكامه وإقتضاءاتها،إلى غير نهاية. وهذا التجلّي الذاتي هو المُسمى في إصطلاح الطائفة العلية ب”الفيض الأقدس”.. فما إستفاد تعالى شيئاً من غيره،ولا أخذ علمه بمعلوماته الكُلية والجزئية إلا منه.. ثمّ لما تفصّلت المعلومات وصارت أغياراً،إنسحب عليها هذا العلم من غير زيادة ولا نقصان. فيجوز،والحالة هذه،أن يُقال إن معلوماته أعطت العلم من نفسها،وأن العلم تابع للمعلوم في هذه حضرة الذات. عَلم ذاته وما يكون عن ذاته،بإقتضاءاتها ولوازمها وإستعداداتها.. إذ ما من حاكم على أمر إلا والمحكوم عليه سابق على الحُكم عليه،تقدّم مربتة لا تقدّم وجود. فكما عُلمت الذات بالذات،حكمت الذات للذات بما إقتضته الذات. فإن إقتضاء الذات طلب الذات من نفسها،فلا وجه لتأخّر الحُكم بعد العلم بالإقتضاء والطلب. فمهما تصوّر العالِم،تصوّر الحُكم،فإن الحُكم أخو العالِم،إذ هو الحاكم على كل معلوم بما هو عليه ذلك المعلوم.. ومن عَرف هذا الأمر ذَوقاً عرف سرّ القدر،وهو أنه ما حَكم على الأشياء إلا بالأشياء.. وقول الإمام الجيلي: (وفاتَه أنها إنما إقتضت ما علمها عليه..)،بل ما فاته شيء،فإن ما إقتضته ذوات المعلومات من نفسها هو إستعداداتها الذاتية ولوازمها البيّنة،فلا تنفكّ عنها،بل هي عينها. ولهذا سمّى بعضهم المعلومات بالإستعدادات. فلما تعيّنت في العلم،تعيّنت بإقتضاءاتها،وإقتضاءاتها في تلك الحضرة إقتضاء إستعداد وطلب بلسان إستعداد لا بلسان حال ولا بلسان مقال. فحكم لها بما إقتضته إستعداداتها،فيما لا يزال حُكما علمياً لا فعلياً،فإنه لا فعل في ذلك الطور.. فإن للإسم (الحكيم) حُكمين: أحدهما العلم بمواضيع الأمور،فهو علم خاص. وثانيهما وَضعها في مواضعها،فيُعطي كل شيء خَلقه وكل ذي حقّ حقّه.. فالإسم الحكيم يحكُم في الأمر أن يكون هكذا،فيتعلّق به العلم على ما حكم به الحكيم.. فالترتيب الواقع بين الممكنات مع بعضها بعضاً،هو أثر الإسم الحكيم،وهو قريب من الإسم المُريد في هذا التخصيص والترتيب. إلا أن الإسم (الحكيم) عام الترتيب،حتى في الحقائق الإلهية والأسماء الربانية،فيُرتّبها في حضراتها ويُنزلها مَنازلها ومراتبها. والإسم (المُريد) خاص بترتيب الممكنات وتخصيص بعضها ببعض. _ (المسألة الثانية: مسألة الإرادة): قال الشيخ الإمام الجيلي في (باب الإرادة)،ما نصّه: [فاعلم أن الإرادة الإلهية المخصّصة للمخلوقات،كل على حالته وهَيئته،صادر من غير علّة ولا سَبب،بل محض إختيار إلهي.. وهذا بخلاف رأي الإمام محيي الدين بن العربي،فإنه قال: لا يجوز أن يُسمى الله مُختاراً فإنه لا يفعل شيئاً بالإختيار،بل فعله على حسب ما إقتضاه العالَم من نفسه،وما إقتضى العالَم من نفسه إلا هذا الوجه الذي هو عليه..].
فاعلم أن الحقيقة تُثبت الإرادة وتَنفي الإختيار،وإن ورد في الكتاب العزيز: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) فلمعنى آخر غير المعنى المُتعارف للإختيار عند العموم. وقد أجمع المسلمون على أنه تعالى مُريد،وإختلفوا في معنى كونه مُريداً.. والحق أن “إرادته” تعالى هي تعلّق الذات بتخصيص أحد الجائزين للممكن على التّعيين،كما أن “مَشيئته” تعلّق الذات بالممكن من حيث تقدّم العلم قبل كون الممكن،كما أن “الإختيار” تعلّق الذات بالممكنات من حيث ما هي الممكنات عليه.
فالإرادة في حق الحق تعالى كونه مُريداً ومُخصّصاً لوجود ممكن ما،ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجود،لكن من حيث نسبته لممكن ما تجوز نسبة ذلك الممكن لمُمكن آخر.. وإذا كان بممكن ما،فليس بمُراد من حيث هو،لكن من حيث نسبته لممكن ما: ونسبة الإختيار إليه تعالى إذا وصف به،إنما ذلك من حيث الممكن مُعرّى من علّته وسَببه،لا من حيث ما هو الحق تعالى..
فما تَرك العلم وأحديّة المَشيئة ل(لَو شئنا،لو أردنا) مَحلاً،فكان قوله تعالى: (ما يُبدّل القول لديّ) نَفى به عن نفسه تعالى لو شاء ولو أراد،وأثبت ما شاء من غير تخيير.. والممكن وإن كان قابلاً لأحد الجائزين عليه،فليس بقابل بالنظر إلى سَبق علم الله تعالى أحدية مشيئته فيه إلا أحد أمرين..
فكانت فائدة الإخبار من الله تعالى بقوله (لو شاء)،نَفي تعلّق الإرادة بالمُحال الوقوع لنفسه..
فإن قيل: إنا نرى الممكنات تنتقل من حال إلى حال،وتتنوّع في أنواع مُتخالفة متباينة،فما مُتعلّق هذا التنقّل والتحوّل،أليس ذلك مُتعلّق الإرادة ومُقتضاها؟ قُلنا: لا،إنما متعلّق هذا التبدّل هو المَشيئة لا الإرادة،فإنه ليس للإرادة إختيار ولا جاء ذلك في كتاب ولا سنة. وفي الصحيح: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن).. فالإرادة إنما هي تعلّق المشيئة بالمُراد،وهو قوله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه) هذا تعلّق المشيئة بالمُراد،والمشيئة مُتقدّمة على الإرادة بالذات،إذ المشيئة سادن العلم: إلا أنه تظهر رائحة الإختيار مع المشيئة،وبها كان الحق تعالى مَلكاً. وتظهر رائحة الجبر مع العلم..
فالتردّد من الإرادة،ما هو من المشيئة. وحكمته ظهور العناية بالأمر المُتردّد فيه. والمشيئة لا تردّد لها،فلا يشاء إلا ما شاء،وما شاء إلا ما عَلم. فالمشيئة لها الحُكم في التردّد الإلهي،كما لها الحكم في الأمر الإلهي المُتوجّه على المأمور،إما بالوقوع أو عدم الوقوع. فإن توجّهت بالوقوع سُمي ذلك العبد طائعاً،وسُمي ذلك الوقوع طاعة. فإن أطاعت الإرادة الأمر الإلهي،وإن لم تتوجّه المشيئة بوقوع ذلك الأمر،عَصت الإرادة الأمر،فظهر حُكم المشيئة في العبد المأمور،فعصى أمر ربه ونَهيه،وليس ذلك إلا للمشيئة الإلهية.
فهذه هي العظمة الذاتية التي تُحيّر العقول،ولا تهتدي إليها بنظر فكر ولا منقول. إذ عظمته تعالى لذاته لا لأمر آخر،والإرادة والإختيار إنما جاء من إعتبار الممكنات صَلاحية وفعلاً. فالممكنات أعطت الحق تعالى ما يُنسَب إليه من الأسماء والصفات،فإنها كلها نِسَب بين الحق والممكنات.. فعظمته تعالى لذاته لا بأمر زائد،إذ لو كانت عظمته لأمر زائد على ذاته،كصفة الإرادة مثلاً،كما هو مذهب الصفاتيين،لكانت الذات ناقصة في نفسها،ولا يُغني قوله إنها ليست عيناً ولا غَيراً. وأما الطائفة الناجية فإنهم يقولون حُكمها حُكم النّسب والأحوال،لا معدومة عقلاً ولا موجودة خارجاً..
فسيدنا الشيخ محيي الدين ما نَفى الإرادة عن الحق،بل أثبتها على وجه مخصوص لا يهتدي إليه إلا هو وأمثاله وبين مُتعلّقها ومَحلها. وما نفى الإختيار عن الحق تعالى بأن يكون مُكرهاً مَجبوراً،فإن العالِم إذا حَكم بما عَلم لا يُقال إنه مضطر مجبور مُكره فيما حكم به على عِلم.. بل إذا فعل خلاف ما عَلم كان ظُلماً وجَهلاً.. فالحق تعالى مُختار فيما عَلم وحَكم،لا مُكره له.. وقد إختار تعالى ما عليه المعلومات،من غير إجبار ولا إكراه من المعلومات ولا إضطرار،فإنها ما تعيّنت في العلم الذاتي ــ أعني الذات المُقيّد ــ إلا من ذاته المطلقة التي هي مادة الوجود المحض والعدم المحض. وما بَقي إختيار فيما لا يزال،إلا ما أثبته من التردّد.. وهنا مَهامه تحار فيها العقول. فافهم أو سَلّم تَسلم.
__ (المسألة الثالثة: مسألة القدر): قال الإمام الجيلي في (باب القدرة)،ما نصّه: [والقدرة عندنا إيجاد المعدوم،خلافاً لمحيي الدين بن العربي فإنه قال: إن الله لم يخلُق الأشياء من العدم،وإنما أبرزها من وجود علمي إلى وجود عيني. وهذا الكلام،وإن كان له وجه في العقل يَستند إليه على ضُعف،فإنّي أنَزّه ربّي أن أعجزه في قدرته عن إختراع المعدوم وإبرازه من العدم المحض إلى الوجود المحض..].
أقول: حصول المعلومات في العلم الذاتي من العدم المحض،لا دخل للقدرة الإلهية ــ التي هي صفة من الصفات الإلهية ــ فيه. فإن القدرة الإلهية وغيرها من الصفات والأسماء الإلهية،إنما تعيّنت وتميّزت في العلم الذاتي عندما عَلمت الذات الذات بالذات،وتميّزت المعلومات تَمييزاً نسبياً لا حقيقياً.. فلا أثَر للقدرة إلا في الإيجاد الحسّي العيني،فحصول المعلومات المُمكنة في العلم لم يكن بواسطة القدرة الإلهية،وإنما هو تَجلّ ذاتي. فتأثير القدرة الإلهية في الحقائق الممكنة إنما هو في إتّصافها بالوجود،وأما من حيث معلوميتها وعدميتها فيستحيل أن تكون مجعولة،فإن الجَعْل تأثير،ولا تأثير في الأزل فإن ذلك قادح في صَرافة وحدة الذات العليّة..
الأشياء الموجودة لا عين لها في تلك الحضرة،ولا وجود إلا لذاته العالِمة. فهي معدومة العين،لا تُسمى أشياء،لا مخلوقات ولا مُحدَثات ولا أغيار للذات،وهي مسبوقة بالعدم.. فالحق تعالى عَلم نفسه،فعَلم العالَم من علمه بنفسه،لأنه عين العالَم في هذه الحضرة الذاتية بلا مُغايرة. فالممكنات المعلومة ليست بشيء زائد خارج عن الذات المطلقة،وإنما هي وحدة وشُؤون للذات المقيّدة.
والموجودات في هذا الطور والحضرة عين الذات،العلم والعالِم والمعلوم عين واحدة،لا غيرية ولا سَوائية،ما ثَمّ إلا ذات واحدة ومعلوم واحد،فمن يُسايره،والمُسايرة مُفاعلة تطلُب إثنينية،ولا إثنينية هناك..
أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود،لا يقولون بالزائد. وجميع ما يُنسب إليه تعالى من الأسماء والصفات،من علم وإرادة وقدرة،إنما هي نسب وإضافات بين الحق والممكنات،وليس إلا الذات: إذا نَسبتها إلى المعلومات كانت علماً،وإلى المُرادات كانت إرادة،وإلى المقدورات كانت قُدرة،وقس على هذا. حتى إنهم يتحاشون من التعبير بالصفات إلا في مقام التعليم..
المخلوقات غير متميّزة في حضرة العلم الذاتي عن الذات،كما هي في مرتبة الحسّ والتمييز،بل عين العالَم عيم العلم عين المعلوم. فبنفس علمه بذاته يَعلم مخلوقاته،لأنها عين ذاته،فيعلم مخلوقاته بما يعلم به ذاته من الأحكام في تلك الحضرة وذلك الطور. فيعلم أن لذاته وجوهاً وإعتبارات وتعّينات وظُهورات ونِسَباً،وهذه كلها من الذات،إذ ليست بشيء زائد على ذاته في تلك الحضرة الذاتية.. وكان للممكنات الفرق والتمييز والغيرية وغير ذلك،مما حدث لها في مرتبة الحسّ والفرق،فكان لها الحدوث والخلقيّة لمّا تَميّزت الحقائق. فقيل: هذه حقائق وجوبية،وهذه حقائق إمكانية. وقبل ذلك ليس إلا الذات والوحدة وأحكام الوحدة..
وقد تقرّر عند أهل الكشف الإعتصامي: أن الذات من حيث هو هو،مادة العدم والوجود. فأحد طرفيها العدم،وطرفها الآخر الوجود. إذ العدم المطلق هو الذات المتجرّدة تجرّداً أصلياً،وهو في مُقابلة الوجود المطلق الذي هو وجود لنفسه واجب. وما من نقيضين مُتقابلين إلا وبينهما برزخ معقول فاصل،به يتميّز كل واحد من الآخر. ولولا ذلك البرزخ لم يتميّز أحدهما من الآخر،ولأشْكَل الأمر وأدّى إلى قلب الحقائق.
فبين الوجود المطلق والعدم المطلق برزخ،وهو حضرة الإمكان،وهو البرزخ الأعلى المُسمى ببَرزخ البرازخ.. وفي هذا البرزخ،المُسمى بالحقيقة الكُلية،جميع الممكنات أعيان ثابتة لا موجودة..
العدم المطلق قامَ للوجود المطلق كالمرآة،فرأى الوجود المطلق فيه صورته،فكانت تلك الصورة عين حضرة الإمكان،فلهذا كان للممكنات أعيان ثابتة وشَيئية في حال عدمها،وخرج الممكن على صورة الوجود المطلق. وكان أيضاً الوجود المطلق كالمرآة للعدم المطلق،فرأى العدم المطلق في مرآة الحق نفسه،فكانت صورته التي رأى في هذه المرآة عين العدم الذي إتّصف به هذا الممكن،فإتّصف الممكن بأنه معدوم. فهو كالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة،لا هي عين الرائي ولا غيره..
فمن هذه الحضرة البرزخية والحقيقة الكُلية وُجد العالَم بواسطة الحق تعالى وأسمائه،وليست هذه الحقيقة الكُلية والبرزخية بموجودة،فيكون الحق أوجدنا من وجود قديم فيثبُت لنا القِدَم..
فعدم العالَم لم يكن في زمان،ولكن الوهم يتخيّل أن بين وجود الحق ووجود الخلق إمتداد زماني. وهذه الحقيقة الكُلية والبرزخ المعقول تُقارن الحق الأزلي أزلاً،وليس لها وجود مع الحق تعالى..
فتبين مما أوردناه: ان الممكنات حَصلت في الحضرة العلمية الذاتية من العدم المحض الذي هو أحد طرفي الذات.. ثمّ لما حصلت المُقابلة بين الوجود المطلق والعدم المطلق،ولا نهاية لكل واحد منهما،وكانت البرزخية الكبرى في الحقيقة الكُلية،حَصلت فيها جميع الممكنات من جهة مُقابلتها للوجود المطلق،فهو مادتها. فكانت الممكنات في الحقيقة الكُلية ثُبوت،ولا وجود،فهي ثابتة غير موجودة،وهي معلومات الحق تعالى مخزونة في هذه الخزانة الكبرى التي هي صورة علم الحق تعالى،عَلمها بها،فحصلت المعلومات في الحضرة العلمية بالأصالة من العدم المحض،بتجلّ ذاتي لا بتوسّط إسم من الأسماء. ثمّ لما وجدت في مرتبة الوجود العيني،كان ذلك بالقدرة عقلاً،وبواسطة القول شَرعاً..
قال تعالى: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نُنزّلأه إلا بقَدَر معلوم) من إسمه الحكيم،فالحكمة سلطانة هذا الإنزال الإلهي،وهو أخرج هذه الأشياء من هذه الخزائن إلى وجود أعيانها..
== (الموقف السابع والأربعون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (ويُطعمون الطعام عل حُبّه) [الإنسان: 7].
المُطعمون الطعام،من حيث أنهم مُطعمون،طوائف: طائفة تُطعم الطعام لوجه الله،أي لأجل بقاء الوجه الإلهي الذي قامت به الصورة،ظاهراً بها،نافذ الحُكم فيها. فإن لكل صورة وَجهاً إلهياً،أي إسماً إلهياً تَوجّه به الحق تعالى على إيجاد تلك الصورة،وهو الوجه الخاص بتلك الصورة دون سائر الصور. وهو سرّ الله بينه وبين كل مخلوق،وهو الذي طلب من إلإسم الجامع إيجاد تلك العين والصورة. وإلى هذا الإشارة بما ورد في الصحيح قوله تعالى: (مرضت فلم تعدني،وظمئت فلم تسقني) الحديث.. فافهم،واحذر أن تتوهّم حلولاً أو إتحاداً أو نحو هذا..
وهذا الوجه الخاص هو لكل صورة،كانت ما كانت،من صورة مَلكية أو إنسانية أو حيوانية أو نباتية أو جمادية أو عقلية أو خيالية. إذ لكل موصوف بالوجود وجه خاص ينفرد الحق تعالى بعلمه،لا يعلمه العقل الأول ولا النفس الكُلية. وهو واسطة المَدد بين الله تعالى وبين كل مخلوق،وهو روح الروح وسرّ السرّ. ولا يدخل تحت عبارة،ولا يقدر مخلوق على إنكاره،فهو المعلوم المجهول. وهو “التجلّي في الأشياء”،المُبقي لأعيانها. وأما “التجلّي للأشياء” فهو تجلّ يُفني أحوالاً ويُعطي أحوالاً في المُتجلّى له. وإذا تحلّل السائر إلى الله تعالى وإضمحلّ تركيبه،في معراج التحليل،لا يبقى منه إلا هذا الوجه الخاص. ولا يَرى الحق،ممّن يراه،إلا هذا الوجه،ولا يسمع كلام الحق إلا بهذا. ولا يعبُد،كل عابد،من الحضرة الجامعة،إلا هذا الوجه الخاص به. ولا يعرف إلا هو،وهو العلامة التي بين العباد وربّهم التي يتحول فيها إذا أنكروه يوم القيامة فيعرفوه على الكشف،وفي الدنيا على الغيب. يعلمه كل إنسان من نفسه،ولا يعلم أنه يعلم. وهذا الوجه أعلى ما يصل الكُمّل إلى الأخذ منه في مرتبة الولاية،إذا تَرقّوا عن الأخذ من الأرواح والوسائط. فما دامت الصورة موصوفة بالوجود،كان ذلك الوجه الخاص ظاهر الحُكم،وإذا أخفيت خَفي حُكم ذلك الوجه الخاص..
ولا تَغترّ نفوس الثقلين بأن لها وجهاً من الله تعالى،فتترُك الأوامر المشروعة وتقتحم المحرمات..
== (الموقف الثامن والأربعون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) [محمد: 19].
إعلم أن العلم المأمور به هو العلم بألوهية الإله وإختصاصه بمرتبة الألوهية،لا العلم بذات الإله،فإن ذلك مُحال.. وللعلم بألوهية الإله وتوحيده طريقان:
الطريقة الأولى: ب”النظر العقلي”،وقرّره الحق على حدّ محدود ووجه مخصوص،لا مطلقاً.. وغاية ما أدرك العقل من ذلك أنه رأى أشياء هي كما عنده،فوصف الحق بها. وأدرك أشياء هي نقائص غيره،فنفاها عن الإله ونَزّهه عنها.. والتحقيق: ما أدرك العقل إلا نفسه،فإنه ما علم من الإله تعالى إلا ما عَلم من نفسه وعليه ذاته،من نقص وكمال،فقاس الإله الحق على ذاته.
الطريقة الثانية: هي ما جاءت به الكتب المُنزّلة وأخبرت به الرسل المُرسلة،من نُعوت الإله الحق..
(لا إله إلا الله،لا معبود إلا الله): أي لا معبود في كل صورة عُبدت،من مَلك وإنس وجن وشمس وقمر وكوكب وحيوان وشجر وحجر وطبيعة،إلا الله. فإن تعالى الظاهر،وتلك الصورة هي مظاهر وتعيّنات للإله الحق،والمظاهر والتعينات معدومة في الحقيقة،فليس الوجود إلا للحق الظاهر،وليس هناك حلول ولا إتحاد ولا إمتزاج،فافهم.
وكل عابد إنما قَصد بعبادته وتذلّله،في نفس الأمر،الحقيقة التي بيدها الضُرّ والنّفع والعطاء والمنع،وليس ذلك إلا للواحد الأحد تعالى..
فكما أن كثرة الأسماء لا تَقدح في وحدة المُسمى،كذلك كثرة الصور التي هي مظاهر وتعينات لا تقدح في وحدة المعبود المقصود بالعبادة من كل عابد..
== (الموقف الخمسون بعد الثلاثمائة) ==
قال الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: 70].
كرّم تعالى بني آدم بكرامات كثيرة،أجلّها خَلق أبيهم آدم بيديه وأولاده منه،وجعل أباهُم مُعلم الملائكة وأستاذهم،وهيّأ لهم أسباب نَيل المراتب العلية والتنقّل في المقامات. بخلاف الملائكة فإنهم ليس لهم هذا،إذ ما من مَلك إلا له مقام معلوم لا يتعدّاه.
وفضّل تعالى آدم وبنيه على كثير ممّن خَلق،والمُستثنى هم الأرواح الذين فوق الطبيعة الصغرى،العقل الأول والنفس الكُلية. والمُهيّمون هم العالون الذين ما أمروا بالسجود لآدم،المُشار إليهم بقوله تعالى: (أستكبرت أم كنت من العالين).. والمأمورون بالسجود لآدم هم الملائكة الطبيعيون،وجميع الملائكة طبيعيون،إلا العالون.
فالمأمورون بالسجود هم من جملة المَفضولين،والمُفضلون هم خواص بني آدم،المؤمنون والأولياء،لا مطلق بني آدم الحيوانيين..
[ذكر الشيخ الأمير بعض ما يتعلّق بمراتب الأولياء وصفاتهم،خصوصاً مقام الأفراد،وذكر رقائق حول الخضر والنبوة العامة..].
== (الموقف الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة) ==
قام الشيخ الأمير في هذا الموقف بحلّ ألفاظ “فصّ إسماعيل” من (فصوص الحكم) للشيخ الأكبر،ومما جاء فيه:
_ (مُسمى الله أحديّ بالذات،كُلّ بالأسماء): يعني أن الذات المُسماة بالله،من حيث هي في مرتبتها الذاتية وتجرّدها وغناها عن العالمين،أحدية،لا إسم ولا صفة لها،ولا تركيب فيها ولا نسبة لها من النّسب،ولا إعتبار من الإعتبارات. بخلافها في مرتبتها الإلهية فإنها كُلّية،أي لها إعتبارات وأسماء ونسَب،إقتضتها المرتبة الإلهية من حيث يطلُبها العالَم وتطلُبه.. فهي كثيرة الأحكام،إذ له الأسماء الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء،وكل إسم علامة على حقيقة معقولة ليست عين الأخرى.. فمُسمى الله من حيث ذاته له “أحدية الأحد”،ومن حيث أسماؤه له “أحدية الكثرة”. كما أن الإنسان واحد في ذاته،وهو يَشهد الكثرة من نفسه: (من عرف نفسه عرف ربه). وما عرف الإنسان نفسه إلا واحداً في كثير،وكثيراً في واحد. فعرف ربه بصورة عِلمه بنفسه.. _ (كُلّ موجود فما له من الله إلا ربّه خاصة،يستحيل أن يكون له الكُلّ): يعني أن كُل موجود،في أيّ مرتبة من مراتب الوجود كان،ليس له إلا إسم واحد من الحضرة الربيّة الإلهية الجامعة،هو ربّه،وهو المُعبّر عنه عند الطائفة العليّة ب”الوجه الخاص”.. فلكل مخلوق ربّ،وهو الذي حَصل تدبيره فيه،وهو الذي يعبده ولا يعرف من الله إلا هو،وهو العلامة التي يُعرف الحق بها في الآخرة حين تحوّل في الصور.. هذا لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،فإن ربه الحضرة الجامعة،وكذلك الأنبياء والرسل والورثة من الأولياء،كل على حسب مقامه.
_ (وأما الأحدية الإلهية فما لواحد فيها قَدم،لأنه لا يُقال لواحد منها شيء ولآخر منها شيء،لأنها لا تقبل التّبعيض. فأحديّته مجموع كُلّه بالقوّة): يعني أن الأحدية،التي هي إسم لصرافة الذات المجردة عن الإعتبارات الحقيّة والخلقية،فهي مَجلى ذاتي ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من مؤثراتها فيها ظهور. ولا قدم لأحد فيها،أي لا سَبق لمخلوق.. فالأحدية عين واحدة،والكثرة المتنوعة،الحَقية والخَلقية،الجميع موجود فيها بحُكم البُطون لا بحُكم الظهور.. _ (والسعيد من كان عند ربّه مَرضيّاً): وما ثَمّ إلا من هو مَرضيّ عند ربّه،لأنه الذي يُبقي عليه ربوبيته.. لهذا قال سهل: [إن للربوبية سِرّاً ــ وهو أنت،يُخاطب كل عَين ــ لو ظَهر لبطُلت الربوبية]. وهو لا يظهر،فلا تبطُل الربوبية،لأنه لا وجود لعين إلا بربّه،فالعين موجودة دائماً،فالربوبية لا تبطُل دائماً..
فالربّ والمربوب مُتضايفان،لا ظهور لأحدهما بدون الآخر،كسائر الأمور النّسبية والإضافية. وإنما كان كل مربوب مَرضياً عند ربه الخاص به،لأن المربوب هو الذي يُبقي على الرب ربوبيته. فلو إنعدم المربوب وجوداً أو تقديراً،إنعدم الإسم الذي يرُبّه. ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري،إمام هذه الطائفة وعالمها: (إن للربوبية سرّاً) والسرّ هو ما يُكتَم ويُطلق على لُبّ كل شيء،والسرّ هو أنت،يُخاطب كل عين من الأعيان والذّوات المربوبة. (لو ظهر) وزالَ هذا السرّ،الذي هو العين المربوبة. (لبطلت الربوبية) فإنه بزوال أحد المُتضايفين أو المُنتَسبين،يَزول الآخر ضرورة. فأدخل سهل على هذه القضية الشرطية “لو” وهو حرف إمتناع لإمتناع..
وفعل العين المربوبة هو فعل ربّها فيها،وكل فاعل يُحبّ فعله،وقد أعطى تعالى كل شيء خَلقه..
فعبد المُضلّ،مثلاً،لا يكون مَرضياً عند الإسم الهادي،وعبد الإسم المانع لا يكون مَرضياً عند الإسم المُعطي.. وإنما كان الأمر هكذا،لأن كل موجود ما أخذ ربّه المُتعيّن لتربيته وتدبيره إلا من كُلّ،وهي الحضرة الكُلية الكثيرة الأسماء المُتضادّة،لا أنه أخذ الربوبية التي هو بها مربوب من واحد وحدة حقيقية. فما تعيّن لكل عبد من الحضرة الكلية الربيّة إلا ما يُناسبه من الأسماء،إذ الأعيان هي صور الأسماء الربيّة في العلم الذاتي. فكل عين لَبست حُلّة الوجود،تَعيّن لها إسمها الذي هو صورته.. والمَدد لا يأتي صورة العبد من الحضرة الجامعة إلا بواسطة ربّه الخاص،فلا يُمدّ شيء شيئاً غيره،وإنما المَدد يأتي من باطن الشيء إلى ظاهره..
ولكَون كل موجود إنما أخذ ربه الخاص به من الكُلّ،فتعيّن له واحد من كثير،ما أخذه من واحد: مَنع أهل الله التجلّي في الأحدية لأحد من المخلوقات،إذ الأحدية ذات محض.. ولما كانت الأحدية ذاتاً محضاً،والذات لا تقييد لها،منع أهل الله التجلّي الذاتي في غير مَظهر،وجميع التجليات الواقعة للعباد في الدنيا والآخرة لا تخرُج عن التقييد. فإنه تعالى،من حيث خَلق الخلق،ما تجلّى إلا في رتبة التقييد. فلهذا لا يكون التجلّي للإسم الله ولا للأحد،وإنما يكون للإله الرب والرحمن..
__ إن أهل هذا اللسان،الواقفين في ميادين البيان،قسموا “التجليات” إلى: تجلّ فعليّ،وتجلّ أسمائي،وتجلّ صفاتي،وتجلّ ذاتي.
فأما التجلي الفعلي فمعلوم،وكذا التجلي الأسمائي والتجلي الصفاتي. وأما التجلي الذاتي فإنما يعنون به تجلّي الحق تعالى للعبد من حيث أنه لا يظهر لذلك التجلي نسبة إلى إسم ولا صفة ولا نَعت ولا إضافة،وإنما يعرف أنه تجلي له فقط.. فالتجلّي الذاتي عند الطائفة العلية هو تجلي الذات من حيث الذات الإلهية،لا من حيث الذات الأحدية.. إذ الذات الأحدية هي الوجود المطلق عن الإطلاق والتقييد،لا ظهور لشيء معها ممّا يُنافي أحديّتها..
== (الموقف الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة) ==
قام الشيخ الأمير في هذا الموقف بإيضاح ألفاظ (الفصّ الإسماعيلي والفص الشُعَيْبي).. ومما جاء فيه:
_ قلب العارف بالله هو من رحمة الله،وهو أوسع منها. فإنه وَسع الحق تعالى،ورحمته لا تَسعه. هذا لسان عموم من باب الإشارة،فإن الله راحم وليس بمرحوم،فلا حُكم للرحمة فيه. وإن كانت الرحمة منه،فلا تعود عليه.. قلب العارف بالله وإن كان مخلوقاً بالرحمة التي وَسعت كل شيء،والقلب شيء من الأشياء،فالشيء أعمّ العام،وهو كل ما يَصحّ أن يُعلَم ويُخبر عنه. فإنه تعالى خَلق قلب العارف به،وجعله أوسع من رحمته. جاء في الحديث القدسي: (ما وسعني أرضي ولا سمائي،ووسعني قلب عبدي المؤمن الهَيّن الوَرع). فقيّد هذا الوُسْع بالقلب المؤمن،فهو وُسْع الخصوص لا وسع العموم. فإن قلب غير المؤمن لا يكون محلاً للمعرفة بالله تعالى،فلا يسع الحق الوُسع المخصوص بالعارفين،إذ لا تكون المعرفة به تعالى إلا بتعريفه،لا بحُكم النظر العقلي.. والقلب المذكور في الحديث،المُراد به اللطيفية الربانية الروحانية،ولها بالقلب الجسماني تعلّق. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان والمُخاطَب المُعاقَب.. ووُسع القلب أنواع: الأول: “وُسع العلم والمعرفة بالله”،إذ لا شيء في الوجود يَعقل آثار الحق ويَعرف ما يستحقه كما ينبغي،مثل الإنسان،فغير الإنسان إنما يعرف ربّه من وجه دون وجه. الثاني: “وُسع الكَشف عن محاسن جماله تعالى”،فيذوق لذّة الأسماء الإلهية.. الثالث: “وُسع الخلافة”،وهو التحقّق بالأسماء الإلهية حتى يرى ذاته ذاتَ الحق،فتكون هُوية العبد عين هوية الحق،فيتصرّف في الوجود تصرّف الخليفة.. حيث كان القلب هو النور الإلهي والسرّ العَليّ المُنزل في عين الإنسان لينظُر به إليه،وهو روح الله المنفوخ. وهذا لسان خصوصي. وأما لسان خصوص الخصوصي فهو أن قلب العبد العارف عين هُوية الحق،فما وَسعه غيره. فإن روحه المنفوخ في آدم هو عين ذاته،ما هو غيره،فما وسع الحق إلا الحق. فهو تعالى دار الموجودات كلها لأنه الوجود،وعين قلب عبده المؤمن العارف دار له لأنه وَسعه. يقول سيدنا (الشيخ الأكبر): [وأما الإشارة من لسان الخصوص،فإن الله وَصف نفسه بالنّفَس،وهو من التّنفيس. وأن الأسماء الإلهية عين المُسمى وليس إلا هو،وأنها طالبة ما تُعطيه من الحقائق،وليست الحقائق التي تطلبها الأسماء إلا العالَم. فالألوهية تطلب المألوه،والربوبية تطلب المربوب. وإلا فلا عين لها إلا به،وجوداً أو تقديراً. والحق من حيث ذاته غني عن العالمين،والربوبية ما لها هذا الحُكم. فبَقي الأمر بين ما تطلبه الربوبية وبين ما تستحقه الذات من الغنى عن العالم. وليست الربوبية،على الحقيقة والإنصاف،إلا عين هذه الذات. فلما تعارض الأمر بحُكم النسب،ورد في الخبر ما وَصف الحق به نفسه من الشفقة على عباده. فأول ما نَفّس عن الربوبية بنَفسه المنسوب إلى الرحمن بإيجاد العالم الذي تطلبه الربوبية بحقيقتها وبجميع الأسماء الإلهية. فيثبُت من هذا الوجه أن رحمته وَسعت كل شيء،فوسعت الحق،فهي أوسع من القلب أو مُساوية له في السّعة].. تَنفيس الحق عن الأسماء هو بالإذن لكل إسم أن يظهر بحقيقته،فيثبُت من هذا الوجه تنفيسه عن الحضرة الربيّة أن رحمته وسعت كل شيء،فوسعت الحق تعالى،لا من حيث عموم أنها وسعت كل شيء،لأن الحق ليس بشيء،فوسعت رحمته أسماءه.. فالرحمة إذا أعتُبرت صفة فهي أوسع من القلب،لأنها وَسعت الحق ونَفّست عنه،والقلب ما نفّس عن الحق شيئاً. أو مُساوية له في السّعة،حيث إنها وَسعت كل شيء،والقلب وسع الحق تعالى فوَسع كل شيء.. فمن عَلم الحق،من حقيقته،فقد علم كل شيء،وليس من عَلم شيئاً علم الحق.. وكما ثَبت سِعَة قلب المؤمن للحق تعالى،كذلك ثبت أنه تعالى يتحوّل في الصُور يوم القيامة شرعاً،وفي الدنيا عند العارفين به كَشفاً.. وللحق تعالى تجليّين: ذاتي له إستأثر الله به،فليس للخلق فيه نصيب.. وله تعالى تجليات فعلية وأسمائية وذاتية،وهو ما يتجلّى به على قلوب عباده ويَظهر لهم في أعين الناظرين،وليس ثَمّ غيره. والتجلّي لا يكون إلا للإسم (الإله والرحمن والربّ)،وما إشتملت عليه هذه الأصول من الأسماء،لا يكون التجلي للإسم الله من حيث أنه عين الذات،وكذلك لا يكون التجلي للإسم الأحد.. والقلب لا يسع الحق والخلق معاً،فإنه إذا نظر الحق عند تجليه له لا يُمكن أن ينظُر معه إلى غيره،بأن ينظر الصورة التي حصل التجلي فيها،سواء كان التجلي في صورة المحسوسات أو المتخيلات أو المعقولات،كصورة المرآة في الشاهد.. ودائرة الرؤية في المرآة تتّسع بإتّساع العلم بالله،ويضيق قلب العارف بالله المُتجلّى له إذا كانت الصورة غير واسعة كذلك. وبسعة الصور وضَيقها يتفاضل العارفون بالله وبتجلياته. أنظُر قصة المريد الذي قيل له: هلاّ رأيت أبا يزيد؟ فقال: لا حاجة لي في رؤية أبي يزيد،رأيت الله فأغناني عن رؤية أبي يزيد. فقيل له: لو رأيت أبا يزيد مرّة كان خيراً لك من أن ترى الله ألف مرة. فمَرّ أبو يزيد وفروته على رأسه،فقيل هذا أبو يزيد. فلما وقع بصره على أبي يزيد مات المريد من حينه. فأخبر أبو يزيد بذلك فقال: المريد صادق،كان يرى الحق بحسب مرآته فلا يتأثّر،فلما رأى الحق في غير صورة مرآته لم يتحمّل ومات،فإنه تجلّى له على قَدرنا. ولهذا تقول الطائفة: أكمل المَرايا مرآة رسول الله صلى الله عليه وسلم،وأكمل الرؤية ما كان في مرآة رسول الله صلى الله عليه وسلم،فإنها حاوية لجميع مرايا الأنبياء،فهي أكمل رؤية وأتمّها وأصدقها.. هذا التجلي المذكور الذي القلب تابع له،هو “التجلي الذاتي” الأزلي الذي هو أول التجليات والتعينات،وبه منه حصلت الأعيان الثابتة،أعيان الممكنات وإستعداداتها الذاتية الكُلية في العلم. وهذا هو الخَلق التقديري الذي تكون عليه الممكنات إلى غير نهاية،وعلى طبقته يكون التجلي الأسمائي حَذو النعل بالنعل،لا أزيد ولا أنقص في الخلق الإيجادي.. والطائفة إنما إعتنت بذكر التجلي الأسمائي،دون التجلي الذاتي،مع أنهم لا يُحلونه،لكون التجلي الأسمائي تفصيل للتجلي الذاتي،والتجلي الذاتي مَضى بما فيه،والتجلي الأسمائي مُتجدّد في كل آن. وتحرير مسألة كون التجلي تابعاً في مرتبة حضرة الأسماء،ومتبوعاً في مرتبة حضرة الذات: هو أن تعلم أن لله تَجليّين أو إنكشافين أو تنزّلين: تجلّي غيب في حضرة الذات،وتجلي شَهادة في حضرة الواحدية (حضرة الأسماء الإلهية). فمن “تجلي الغيب الذاتي” يُعطي الإستعداد الكلي الذاتي الذي يكون عليه القلب إلى ما لا يتناهى. وهذا التجلي الذاتي الغيب مَصدره وحقيقته ومبدؤه الذات من غير واسطة إسم من الأسماء ولا صفة من الصفات،وهو المعروف عند الطائفة ب”الفيض الأقدس”،وبه حَصلت الأعيان الثابتة وإستعداداتها الكلية في العلم الذي هو عين الذات،وهذا الإستعداد هو المؤثّر.. وهذا الغيب الذي صَدر منه هذا التجلي،الذي أعطى الإستعداد للقلب،هو الهُوية المُرسَلة لا الهوية السارية،فإنها سمع العبد وبصره وجميع قواه،وهي القائمة بأحكام الأسماء الحسنى.. فإذا حصل للقلب هذا الإستعداد الكُلي الذاتي في حضرة الثبوت،تجلّى له تعالى “التجلّي الشّهادي” في عالَم الشهادة عندما لبس حُلّة الوجود،وهو المعروف عند الطائفة ب”الفيض المُقدّس” الذي تحصُل به الإستعدادات الجُزئية في الخارج،حضرة الأسماء الإلهية.. ثمّ رفع الحق الحجاب بينه وبين عبده فرآه في صورة معتقده،فهو عين معتقده. فلا يَشهد القلب ولا العين،أبداً،إلا صورة مُعتقده في الحق. فالحق الذي في المُعتقد هو الذي وسع القلب صورته،وهو الذي يتجلى له فيعرفه. فلا ترى العين إلا “الحق الإعتقادي”.. وهو “الحق المخلوق”،فإنه ما عبد عابد إلا ما إعتقده،وما إعتقد إلا ما أوجده في نفسه.. فالقلب سِتْر،فإنه محلّ الصور الإلهية التي أنشأتها الإعتقادات.. فيتجلى تعالى لكل قلب بحسب وُسعه وإعتقاده. وإن كل قلب،بالصلاحية،من كل إنسان،قابل للتجلي الكمالي. وإنما كان كل مخلوق له إعتقاد يختص به في الحق تعالى،لأن الأرواح المُدبّرة تابعة للأمزجة المُدبّرة،ولا يجتمع إثنان في مزاج واحد. فما إعتقده الشخص هو الذي يتجلى له فيعرفه،لأنه عرف صورة إلهه في إعتقاده،فلما تجلى له فيها عرفه. فلا ترى العين ولا يشهد القلب إلا الحق الإعتقادي،فلم ير المخلوق إلا مخلوقاً،فإنه لا يرى إلا صورة معتقده. والحق وراء ذلك كله من حيث عينه القابلة لهذه الصور في عين الرائي،لا في نفسها.. إذا زعم العبد المُتجلّى له أنه رأى الحق،فما رآه،فلا يرى الرائي في التجلي إلا منزلته ورُتبته،فما رأى إلا نفسه وإستعداده.. يقول سيدنا: [ولا خَفاء بتنوع الإعتقادات: فمن قيّده أنكره في غير ما قيّده به،وأقرّ به فيما قيّده به إذا تجلى. ومن أطلقه عن التقييد لم يُنكره وأقرّ له في كل صورة يتحول فيها ويُعطيه من نفسه قدر صورة ما تجلى له فيها إلى ما لا يتناهى،فإن صور التجلي ما لها نهاية تقف عندها]. وإنما تنوعت الإعتقادات وتكثّرت،لتنوع الأسماء الإلهية وكثرتها،فهي مصدر الإعتقادات ومَنشؤها.. والتجلي في الصور يُكَثّره عند العارفين بالتجليات،فإنه ما تجلى في صورتين لواحد.. وأما العامة فيتجلى لهم في صور الأمثال.. _ (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى): فالصورة والمعنى من العبد له تعالى،إذ الإشارة بلغت عين الكُلّ. فما كان العبد عبداً إلا به تعالى،كما لم يكن الحق قواه إلا به.. وليس المُراد من قوله: (كنت سمعه) الحديث،أنه لم يكن ثُمّ كان،وإنما المراد الكشف عن ذلك بسبب التقرّب بالنوافل. كذلك العالَم كله إنسان كبير كامل،فحكمه حُكم الإنسان. وهُوية الحق باطن الإنسان،وقواه التي كان بها عبداً. فهُوية الحق قوى العالَم التي كان بها إنساناً كبيراً،فالعالم كله حقّ. والصور وإن كانت عين الحق،فهي أحكام الممكنات في عين الحق،فإنه تعالى لا يحويه ظَرف ولا تُغيّبه صورة. وإنما غَيّبه الجهل به من الجاهل،فهو يراه ولا يعلم أنه مطلوبه. فقُل: إله،وقل: عالَم،وقُل: أنا،وقل: أنت،وقل: هو،والكل في حضرة الضمائر ما بَرح وما زال..
فالحق تعالى ظَهر بهذه المرتبة وسَمّى نفسه بالخلق،فليس إلا الله وحده،ويُسمى خَلقاً لحُكم الممكن في تلك العين،وهذا الحكم عن عين معدومة،من غير حلول ولا إتحاد ولا إمتزاج.. فهو خَلق بنسبة،وذلك من حيث تَشكّل الأسماء الإلهية بالصور،فله الإمكان. وهو حقّ بنسبة،وذلك من حيث العين القابلة للصُور الأسمائية عليها،فله الوجوب والإمكان. فهو الواجب المُمكن والمكان والمُتمكّن،المَنعوت بالحدوث والقِدَم. كما نعت تعالى كلامه القديم بالحدوث،مع إتّصافه بالقدم،فقال: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم). الضمير من (يأتيهم) يعود على صور الأسماء (مُحدَث)،فنعته بالحدوث،فهو حادث عند صورة الرحمن..
فانظُر ما أعجب أمر الله تعالى: من حيث هُويته السارية في كل شيء،كان الأمر حقّاً كله. ومن حيث نسبته إلى العالَم وظهوره في حقائق الأسماء الحُسنى وتشكّل الأسماء بالصور،كان الأمر خَلقاً كله..
_ يقول سيدنا: [(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) لتقلّبه في أنواع الصور والصفات،ولم يقل (لمن كان له عقل) فإن العقل قيد،فيحصره الأمر في نعت واحد،والحقيقة تأبى الحصر في نفس الأمر. فما هو ذكرى لمن كان له عقل،وهم أصحاب الإعتقادات الذين يَكفُر بعضهم ببعض،ويَلعن بعضهم بعضاً،فما لهم من ناصرين.. فنفى الحق النُّصرَة عن آلهة الإعتقادات على إنفراد كل معتقد على حدته،والمنصور المجموع،والناصر المجموع]،ويقول أيضاً: [فلهذا قال: (لمن كان له قلب) يَعلم تقليب الحق في الصور بتقليبه في الأشكال،فمن نَفسِه عرف نَفسَه،وليس نفسه بغير لهُوية الحق. ولا شيء من الكون بغَيْر لهُوية الحق،بل هو عين الهُوية..].. الإشارة في ذكر الآية الكريمة في كلام سيدنا،هي ما ذكره من أحوال القلب وأحوال التجليات ونُعوتها وتعدّدها،وأنها لا نهاية لها.. (لذكرى) تَذكرة لمن كان له قلب خاص،داع للتجليات الإلهية،باق على صَفائه وتقديسه عن الأوضار الطبيعية. أو صَقلته الرياضات والمجاهدات،وإتباع الكتاب والسنة،فصَفا بعد الكُدورة وتَطهّر بعد النجاسة.. واعلم أن كل إنسان له قلب،فإن القلب إسم للروح الجُزئي،وسُمي جُزئياً لتدبيره الجسم الجزئي. إذ الروح الكُلّي لمّا تنزّل من مرتبة كُليته إلى تدبير جسم الإنسان،صار جُزئياً. وسُمي قلباً لتقلّبه في أنواع الصور التي يتجلى له الحق فيها،فهو دائم القلب مع الأنفاس،لأنه مخلوق على صورة الحق تعالى،وصورة الحق لا تُعطي الضّيق،ولا مجال لها إلا في التقليب.. والعقل يَحصر الأمر الإلهي في نعت واحد وإعتقاد مُفرد،ويُحجّر على الحق تعالى أن يكون على إعتقاد مُخالف لمُعتقده. والحقيقة تأبى وتَمنع الحصر بأن يكون الإله الحق على ما يعتقده فيه واحد دون غيره من المعتقدين.. فإن من لازم شهود أهل العقول أنفسهم معه تعالى التميّز والتحديد والحصر،إذ من إعتقد في إلهه أنه مُباين له مُنفصل عنه،يلزمه تحديد إلهه ولا بدّ. فمعرفته تعالى موقوفة على شُهود صفاته،وهذا لا يُدرَك بالعقل،وإنما القلب السليم يُدرك ذلك،ثمّ يُفيض على العقل بقدر ما يقبله.. وحظّ صاحب العقل العلم بوجود الله ووحدانيته فقط،فأهل العقول المتكلمون في الإلهيات خطأهم أكثر من إصابتهم،سواء كان فيلسوفياً أو معتزلياً أو أشعرياً أو من كان من أصناف أهل النظر العقلي.. علم صاحب القلب السليم،العارف بالله وبتجلياته،فوق علم صاحب العقل،فإنه جاهل بالتجليات،بل يمنع تقليب الحق في الصور،وهي الشؤون التي هو تعالى فيها كل يوم.. فتقليب الحق في الصور سَبب في تقليب العبد في الأشكال،فما عرف العبد العارف الحق تعالى إلا من معرفته نفسَه،ولذا ورد: (من عرف نفسه عرف ربّه). فمعرفته النفس سُلّم إلى معرفة الحق،لأن نفس العارف الإنسانية المقيّدة هي النفس الإلهية المطلقة،فمن معرفته نفسه المقيدة عرف نفسه المطلقة. وليست نفسه المقيدة بغير هُوية الحق السارية في النفس الإنسانية،ولا سَريان،وليس سَريان الهُوية خاصاً بالنفس الإنسانية،بل بكل شيء داخل تحت قوله تعالى (كُن). فلا شيء بغير هُوية الحق السارية،بل هو عينها لا غيرها.. _ إن العارفين لا يمنعون أهل النظر والفكر عن نظرهم،لأن ذلك هو مرتبتهم،وإنما يمنعون العمل بما يُنتجه الفكر من التلبيس. فإنه ما من علم من العلوم الظنيّة إلا ويجوز أن يُنال العلم اليقيني به من طريق الكشف. ولهذا جعل المحققون من الصوفية أفلاطون الحكيم من العلماء بالله،لأنه خرج بنظره مَخرج الكشف،فما كرهه من كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته إلى الفلسفة لجهلهم بمدلول هذه اللفظة..
_ يقول سيدنا: [وأما أهل الإيمان،وهم المُقلّدة،الذين قَلّدوا الأنبياء والرسل فيما أخبروا به عن الحق]،لا من قلّد أصحاب الأفكار والمُتأولين للأخبار الواردة بحَملها على أدلّتهم العقلية. فهؤلاء الذين قلّدوا الرسل هم المرادون بقوله تعالى: (أو ألقى السمع) لما وردت به الأخبار الإلهية على ألسنة الأنبياء.. (فهو شَهيد) يُنبّه على حضرة الخيال وإستعمالها،وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (أن تعبد الله كأنك تراه)،والله في قبلة المُصلّي،فلذلك هو شَهيد.. ومن قلّد صاحب نظر فكري وتقيّد به،فليس هو الذي (ألقى السمع)،فإن هذا لا بد أن يكون شهيداً لما ذكرناه.. فالمُحسن هو الذي يعبد الله ويُطيعه في ما أمر ونَهى،مُشاهداً له ومُصوّراً،حسب إعتقاده في الله وعلمه. فإنه تعالى إنما نَهى عباده أن يتخذوا له صورة محسوسة،كما يفعل عبدة الأصنام والأوثان،وأما الصورة المُتخيّلة فقد أذن فيها،بل رغّب وأمر بالحضور مع المعبود في العبادة.. ولما كانت المعرفة بالله،الحاصلة للعباد،مُنحصرة في أربعة وجوه،فهي: إما من طريق التجلي الإلهي،وإما من طريق التقليد لذي تجلّ إلهي،وإما من طريق النظر العقلي،وإما من التقليد لذي نظر عقلي. فالمعرفة الحاصلة من التقليد لذي تجلّ إلهي،فهم أهل الإيمان الذين كانت معرفتهم بالله إيماناً بالغيب،لا عن تجل إلهي ولا عن نظر عقلي ولا عن تقليد لنظر عقلي. وإن كانت كل معرفة بالله في العالَم إنما هي عن تجلّ إلهي،فليس التجلي الخاص بأهل الله كالتجلي لغيرهم. فأهل الإيمان الذين قلّدوا الأنبياء والرسل فيما أخبروا به عن الحق تعالى،ممّا لا تصل إليه العقول بأنظارها وأفكارها،فإن للعقل حدّاً يقف عنده لا يتجاوزه،وذلك كالصفات السمعية التي أخبر بها الأنبياء والرسل عن ربهم وأحالَتها العقول ونزّهت الحق عنها.. وهذه الأمور إنما تَنزّل الحق تعالى ووَصف نفسه بها رحمة لعباده.. فهؤلاء الذين قلدوا الرسل والأنبياء،والأولياء الداعين الخلق إلى معرفة الله،هُم المؤمنون حقاً،وهم لاحقون بمن قلّدوهم ومُنخرطون في سلكهم. لا من قلّد،من عامة المؤمنين،أصحاب النظر الفكري في معرفة الله تعالى،المُتوهّمين أن الكون دليل على الله،وهو وَهْم باطل،فإن الشيء لا يُدرك إلا بنفسه. فمن طلب معرفة الذات من طريق الفكر والنظر،كان مآلُه الخَيبة والحَيرة من غير طائل،ومُقلّد أصحاب الأفكار،لاحق بهم مُنخرط في سلكهم. واعلم أن طُرق العلم ثلاثة: الأولى: أن يكون الحق هو المُعلّم. الثانية: أن يكون النظر الفكري هو المعلم. الثالثة: أن يكون المعلم مخلوقاً مثل المُتعلّم. فصاحب الإلقاء الإلهي مُلحَق بمُعلمه،ومقلّده مُلحق به. وصاحب النظر العقلي مُلحق بمعلمه،ومقلده ملحق به. وقد أجمع أهل الله أن كل ما يُنتجه النظر والفكر فهو مدخول يَقبل إيراد الشّبه عليه،كما يدل على ذلك إختلاف المقالات في الله تعالى من الناظرين بعقولهم. وإتّفاق أصحاب التجلّي،الذين مُعلمهم الله،من نبي ورسول ووليّ.. (وهو شهيد) بمعنى مُشاهد. فما هو من أهل التجلّي الخاص بأصحاب القلوب،أهل الرؤية. ولهذا قال موسى: (رب أرني أنظر إليك) فإنه تعالى كان مشهوداً له،لا يغيب عنه. ف”الشهود أعمّ من الرؤية”،فإن الشهود ما يُمسكه الإنسان من شاهد الحق الذي إعتقده ورَبط قلبه عليه. فالشهود لا بد أن يتقدّمه علم أو إعتقاد بالمشهود،إذ لا يَشهد الإنسان إلا ما علم أو إعتقد. فلهذا يكون في الشّهود الإقرار والإنكار،ولا يكون في الرؤية إلا الإقرار. (كأنك تراه) هو الشهود بالقلب،وما هو برؤية. فإن المُشاهد إذا رأى مشهوده على غير الصورة التي علمها أو إعتقدها،وقيّده بها،أنكره.. قال تعالى: (وبدا لهم من الله) في هُويته،(ما لم يكونوا يحتسبون) فيها قبل كشف الغطاء.. وإنكشاف الغطاء بخلاف المعتقد في الحُكم في الهُوية الذات الغيب المُغيّب المطلق،الذي لا يُعلَم لمخلوق،فكل عارف محجوب عن شهود الهوية. فلا يزال الحق غير معلوم من حيث الهوية،لا شهوداً ولا ذَوقاً،وما بَقي إلا التجلّي في المظاهر. وتلك إنما هي جسور يَعبُر عليها،أي يعلم أن وراء هذه الصور أمراً لا يصحّ أن يُشهد ولا أن يُعلم.. يقول تعالى: (ويُحذركم الله نفسه) أي ذاته أن تتفكّروا فيها.. ومع هذا فما سَلم أحد من التفكر في ذات الحق تعالى،إلا الرسل. فإن بعض العباد يجزم في إعتقاده أن الله كذا وكذا،وأن الله ليس كذا وكذا،ويحكم على الله بفكره.. قال الشيخ الأكبر: [ليس عندنا للغزالي زلّة أكبر من هذه الزلّة،فإنه تكلّم في ذات الله تعالى من حيث النظر الفكري في كتابه (المضنون به على غير أهله)،وفي غير المضنون،فأخطأ بكل ما قاله وما أصاب..].. وقد عنّ لي أن أذكر بعض من إجتمع به سيدنا من الكمّل بعد الموت،وما جرى بينه وبينهم،وما أفادهم،تتميماً للفائدة،ولتَعلم منزلة سيدنا عند الله ومرتبته وتقدّمه بين أولياء الله.. [ذكر الشيخ الأمير بعض هذه اللقاءات،وما دار فيها من معارف وحقائق..].. _ يقول سيدنا: [وأما أهل الكشف فإنهم يرون أن الله يتجلى في كل نَفَس،ولا يتكرر التجلي. ويرون أيضاً،شُهوداً،أن كل تجلّ يُعطي خَلقاً ويذهب بخلق. فذهابه هو عين الفناء عند التجلي،والبقاء لما يُعطيه التجلي الآخر].
العالَم بأسره مجموع أعراض،فهو يتجدد في كل نفس.. ولا يتكرّر التجلي بصورة من صور الأعيان،بأن يتجلّى بصورة ثُمّ يتجلى بتلك الصورة نفسها،هذا مُحال عند الطائفة العلية.. وكما يُعطي هذا التجلي خلقاً جديداً،يذهب بخلق أول،وهي الصورة التي كانت لتلك العين نفسها. وذلك لأن الصور التي في العالَم كلها نسَب وأحوال،لا موجودة ولا معدومة،وما في العالم إلا الصور. فمجموع العالم أعراض،فهو ذاهب في كل آن لذاته،لأن من حقيقته أن لا يثبُت أكثر من آن..
وللحق تعالى تجليّين: تجل للأشياء،وتجلّ في الأشياء.
فأما “التجلّي للأشياء”: فهو التجلي المُبقي أعيانها،وهو التجلي الخاص الذي بين الحق وبين كل مخلوق،لا تعرض نسبته ولا يدخل تحت عبارة،ولا يعلمه العقل الأول ولا النفس الكلية. فبهذا التجلي تتغيّر الأحكام على الأعيان الثابتة،من الثبوت إلى الوجود.
وأما “التجلي في الأشياء”: فهو تجل يُفني أحوالاً ويُعطي أحوالاً،ومن هذا التجلي توجد الأحوال والأعراض في كل ما سوى الله تعالى. وعليه فلا ينبغي حمل الفناء والبقاء هنا على الفناء والبقاء الخاصين بأهل هذه الطريقة العلية،فالكلام بصدد الإخبار عن العالَم بأسره،لا عن أقوام مخصوصين
ذ رشيد موعشي